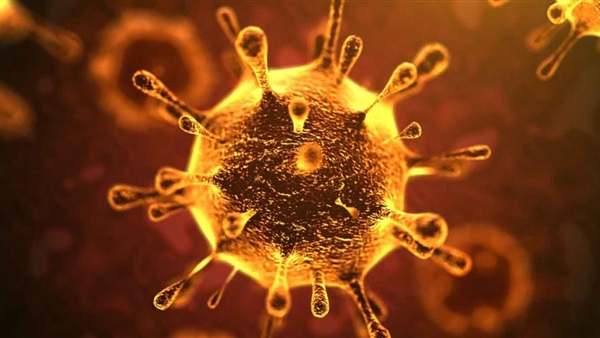
استخدمنا في هذا المقال مصطلح “وجهة التقدم” لتسمية القوى والاتجاهات التي امتطت موجة التقدم والحداثة في عصرنا، وفصّلتها في قياس أهدافها ومصالحها وخياراتها العقلية والثقافية والأخلاقية، التي بلغت حدود العولمة، وطالت كوكبنا بعواقبها وآثارها الماثلة حتى الآن!
في نفس الوقت أردنا تمييز هذا المصطلح عن اتجاه التقدم والتطور بصفة عامة، بوصفه يمثل استعداداً عميقاً في صلب الجنس البشري، ويعبر عن قدراته واحتياجاته المادية والروحية لتطوير خبراته ورسم أهداف وخيارات أفضل لحياته وكوكبه وأجياله القادمة.
عليه فنحن لا نخفي غايتنا لنقد “وجهة التقدم” الحاضرة، وتفنيد الذرائع التي تجعلها قدراً لا بديل عنه، وتخلع عليها ثوب العصمة والحتمية والقداسة.. إلخ. لأن هذه الذرائع تهدم فكرة التقدم والتطور من أساسها وهي التي تميز البشرية وتشكل أفضل وأرفع ما لديها، ونعني به ملكة العقل وحرية التفكير والبحث لتطوير تجاربها واستكشاف اهداف وخيارات أفضل لمصيرها!
والواقع أن عيب هذه الذرائع يتمثل في رفع الوقائع الظرفية، بما فيها العادات المألوفة وطرق التفكير، وحتى قوة الامر الواقع الذي تفرضه الظروف الوقتية.. إلى مستوى الأصنام المقدسة والحقائق المطلقة النهائية، التي تطبع “التقدم الحاضر” بدمغة أيديولوجية تذكرنا بأسطورة المركزية الغربية.. ورسالة الرجل الأبيض.. وتفوق العرق الآري.. وأمركة العالم.. ونهاية التاريخ.. إلخ. التي تمثل في حقيقتها أردأ ما فعلته وانتهت إليه التجارب العقائدية الشمولية التي أصبحت حطاماً في قعر التاريخ!
والواقع أن البشرية ما كان لها أن تخطو في مسار التطور والتقدم خطوة واحدة، بل وأن تحفظ بقائها منذ عصر القبيلة البدائية، لو أن أجيالها وقواها الحية سلمت رايتها ومقاليدها العقلية والروحية لمثل هذا الجمود (بل الهبل) الأيديولوجي. لهذا أستطيع الجزم أن هذا الجمود لا يطال الأفكار والمعتقدات النظرية فقط، بل يطال أيضاً تجارب التقدم العلمي والتطبيقي (بما فيها وجهة التقدم الحاضرة) لأنه يحمل لها نفس الأسطرة والإغراء الأيديولوجي (واسمحوا لي تسميته الفيروس) الذي يشكل قناعاً مثالياً للطغيان ويحجبها عن رؤية العالم الحقيقي، ويفصل لها تابوت الدفن!!
وهذا ما دفع خيرة المفكرين لتعريف الأيدولوجيا بأنها تشكل مزبلة الحرية والثقافة، ودفع كارل ماركس للإعلان أنه ليس ماركسياً، ودفع داروين في مذكراته للتبرؤ من أولئك الذين سخروا نظرياته في التطور الطبيعي للاستغناء عن نزعة التعالي والتطلع الروحي. وهذا ما فعله آينشتاين وكثيرون أيضاً، حتى أكد بعضهم أن المسيحية لم تمسحن روما، بل إن روما رفضت المسيحية. مما يدفعنا للقول إن الاسلام لم يؤسلم قريش بقدر ما قورشت هي الإسلام. وهذا ما دفع برنارد شو لوضع كتابه الرائع “المسيح ليس مسيحياً”، وأوضح في كتاب آخر قائلاً ((إن الماموث والديناصورات وبقية الحيوانات العملاقة تعرضت للانقراض لأنها لم تستطع ابتكار أدوات ووسائل للتكيف مع متغيرات البيئة الطبيعية، بينما تواجه البشرية خطر الانقراض لسبب عكسي تماماً، وهو تعاظم إنتاجها للوسائل والأدوات التي تخرج عن حدود السيطرة جراء فقدانها الأهداف والخيارات السليمة لتوجيه هذا التقدم))
ويردد في مكان آخر ((إن الفأر يملك بأذنيه وعينيه قدراً من وسائل الذكاء الحركي مالا تملكه البشرية على الإطلاق لهذا ربما هي أحوج ما تكون لتطوير عين ثالثة يمكن تسميتها بالبصيرة لتبين أهداف وخيارات أبعد وأرفع لمستقبلها البشري))!
ولا بأس من أن نتذكر هارولد أوري، وهو مكتشف الهيدروجين الثقيل والقنبلة الذرية، وحامل جائزة نوبل، الذي لم يتردد عن الاعلان في مؤتمر دولي: ((إنني شخصياً خائف من مغبة هذا النوع من التقدم، وإن معظم العلماء الذين أعرفهم خائفون أيضاً))!
وهذا ما دفع الكاتب السوري شاكر مصطفى للتحذير قائلاً: ((لقد احتاجت البشرية لخوض مئات الثورات ضد الماضي.. وربما أصبحت أحوج ما تكون الآن لتوجيه ثورتها القادمة ضد المستقبل)) … إلخ
إن هذه الاقوال وغيرها تمثل جزءاً يسيراً جداً من الخبرات التي هيأتها البشرية لصالح صحوتها المرجوة، ونحن لم نذكرها لإثبات صحة تقديراتنا بل إن مرجعها ومرجعناً جميعا يتمثل في الآثام والعواقب الماثلة بالفعل، التي بدأت تتراكم من انفجار الثورة الصناعية الأولى والاكتشافات العلمية والجغرافية التي ظهرت في أحضان التقدم والحداثة، وما صاحبها من جرائم واعتداءات وحشية ضد البيئة الطبيعية والمجتمعات البشرية على السواء!
على أنه يخطئ جدا من يظن أننا نتجه بالنقد أو المعاداة ضد اتجاه التقدم والحداثة بحد ذاته، ناهيك عن الانكفاء لما سبقه من عصور الظلامية والعبودية، بل هو موجه أولاً وأخيراً ضد عيوب التجربة البشرية التي اقترفتها اتجاهات بعينها، وألحقت أشد الأذى بالتقدم والحداثة معاً، كما أثقلت البشرية بمظالم ومشكلات وتداعيات خطيرة تهدد حاضرها ومستقبلها على السواء!
والواقع أن عشرات الحركات نهضت لمواجهة هذه العيوب والآثام بدءاً من مراحل مبكرة. وهي لئن اقتصرت في مراحلها الأولى على ميادين الإبداع الأدبي والفني والفلسفي التي حملت عنواناً مشتركاً هو “اتجاهات ما بعد الحداثة” فإنها ما زالت تتسع هذه اللحظة وصولاً لميادين الإبداع الفكري.. والاجتماعي.. والاقتصادي.. بل والاجتماع السياسي أيضاً، التي شملت مناهضة العولمة والعنصرية والتوحش الرأسمالي والدفاع عن البيئة والعدالة الدولية وحوار الحضارات … إلخ. وفي هذا الإطار يمكن الجزم أنها امتدت لتفكيك الأنظمة والمنظومات الشمولية أيضاً!
عليه نستطيع ان نجزم ان هذه الاتجاهات جميعاً (بما فيها اتجاهات ما بعد الحداثة) هي اتجاهات حداثية بامتياز وهي موجات متعاقبة لتصويب اتجاه الحداثة والتقدم الأصلي، وخصوصاً طي الآثام وعيوب الوجهة المدمرة التي استولت عليه ومنعت تحقيق أهدافه الحقيقية!
كما نعتقد أن صحوة شعوبنا من أجل الحرية والمواطنة والدولة المدنية الديمقراطية، هي جزء لا يتجزأ من مقتضيات هذا التطور التاريخي، وجزء من صحوة البشرية لتحصين مستقبلها وكوكبها معاً ضد وباء الكورونا وبقية الأوبئة الأخرى دون استثناء!
وبناء على هذا أن تبين أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا الفردية والجماعية معاً، لوضع صحوة شعوبنا في مكانها وموضعها الصحيح هذا، إضافة لوضع الأسئلة والأجوبة الصحيحة أيضاً حول مصدر الأوبئة وجذرها الحقيقي، لتكون أساساً صالحاً لتحقيق هذه الصحوة، وتجنيب شعوبنا والبشرية معاً المزيد من المهالك والآلام.







