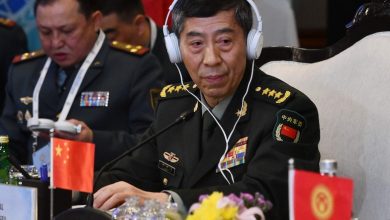في يونيو (حزيران) 2020، اندلعت اشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي في وادي غالوان، المنطقة الوعرة والنائية على طول الحدود المتنازع عليها بين الصين والهند. وقتل 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين في الأقل نتيجة الاشتباكات، كما اندلع سجال حول الآثار طويلة الأمد المترتبة على تلك الصدامات. ورأى بعض المحللين أن العلاقة الصينية – الهندية سوف تعود قريباً إلى طبيعتها مع الاجتماعات الدورية عالية المستوى بين الطرفين وتزايد الاستثمارات الصينية في الهند والتعاون في مجال الدفاع والتعاون المشترك. وبدت جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الهند خلال شهر مارس (آذار) 2022 التي اعتبرت من الزيارات الرسمية الأعلى مستوى بين البلدين، داعمة للفكرة القائلة إن بوسع الهند والصين تجاوز خلافهما الحدودي والمضي قدماً في تمتين علاقتهما. كذلك جاء الاتفاق بين المسؤولين الصينيين والهنود في سبتمبر (أيلول) المنصرم ليشكل، في السياق ذاته، تخفيفاً للمواقف الصدامية التي وقعت عند إحدى المناطق الحدودية في لاداخ، حيث يتواجه جيشا البلدين منذ عام 2020.
لكن وقائع التقارب هذه تحجب تصدعات حقيقية بين الهند والصين، إذ كان صناع السياسات الهندية عام 2020 صدموا إزاء الأزمة الحدودية بين البلدين التي ردوا سببها إلى العدائية الصينية، وهي أزمة تبقى مصدراً للتوتر والقلق. وفي السياق أظهرت السياسات المحلية والدولية الهندية تحولات في نواح ملموسة وذلك كرد فعل على ما يعتبر خطراً صينياً، ويبدو في المقابل أي احتمال لترميم الوضع القائم وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق، احتمالاً مستبعداً. بالتالي انتقلت مقاربة الهند تجاه الصين في المدى المنظور مما كان يعتبر علاقة تنافسية، إلى حالة تعايش تنافسي – إن لم يكن “تعايشاً مسلحاً”، وفق توصيف وزير الخارجية الهندي السابق فيجاي غوخالي. وأنا شخصياً قبل سنتين كتبت في “فورين أفيرز” أن أفعال الصين ربما تسفر عن “خسارتها للهند”. لكن الآن بات ممكناً القول إن الصين خسرت الهند فعلاً.
التصادم في كاراكورام
وكانت الهند اعتبرت الصين تهديداً مباشراً لها منذ أواخر الخمسينيات على أقل تقدير، حين برزت خلافاتهما المتعلقة بـ التيبت (الولاية في جبال الهيمالايا التي ضمتها الصين عام 1951) وبالترسيم الحدودي بينهما. وعجلت تلك الخلافات في وقوع حرب شاملة بين البلدين عام 1962 انتهت كارثياً بالنسبة إلى الهند مع خسارتها أراضي كانت تابعة لها. لكن، وإثر أزمة لاحقة نشأت بين عامي 1986-1987، ظلت منطقة الحدود هادئة نسبياً، وتلك حال سهلتها اتفاقات عدة توصلت إليها بكين ونيودلهي عبر التفاوض على مدى فترة ناهزت 25 عاماً. وتحققت حال التوافق تلك بفضل تعاون صيني – هندي، خصوصاً في مجالات الاقتصاد وفي الأطر المشتركة الأخرى. ولم تعد مسألة الخلاف الحدودي إلى البروز إلا بعد تولي الرئيس الصيني جي جينبينغ السلطة، وذلك إثر مواجهات عسكرية وقعت في أعوام 2013 و2014 و2015 و2017، وأيضاً مع التنافس الأكثر حدة بين الصين والهند في مجالات أخرى بسياق سعي كل منهما إلى تبوؤ موقع أفضل بين دول جنوب آسيا وضمن المنظمات الدولية.
بيد أن الأحداث في لاداخ عام 2020 لم تشكل مجرد نزاع حدودي آخر ضمن السياق المعروف. فالعنف هناك تخطى حواجز نفسية عدة، بحيث تسبب للمرة الأولى منذ 45 عاماً بخسائر بشرية، كما تضمن تراشقاً نارياً هو الأول من نوعه منذ عقود. واندلعت المواجهات في مزيد من المواقع وبمستوى أكبر من السابق وعلى مدى فترة زمنية تجاوزت ما كان يحصل في الأزمات الماضية. ووجهت الهند اتهاماً إلى الصين بانتهاك الاتفاقات الحدودية، وأبدى صناع السياسات الهندية في السياق قلقهم تجاه احتمال قيام القوات الصينية بمزيد من الإجراءات العسكرية. لذا يمكن القول إن فقدان الثقة هذا له انعكاسات طويلة الأمد على المسائل الحدودية غير المتفق عليها بين البلدين، كما على العلاقات الأوسع بينهما.
وكانت بكين دعت إلى وضع الأزمة الحدودية جانباً واستئناف التعاون الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي فوراً، فيما الجنود الصينيون والهنود يفضون اشتباكهم في بعض نقاط التوتر. لكن نيودلهي من جهتها دعت إلى مزيد من مبادرات فض الاشتباك – منها تخفيض عدد الجنود في النقاط الأكثر توتراً – وإلى وقف التصعيد – الأمر الذي يشكل نقيضاً للتعزيزات العسكرية والبنيوية التي حشدها الطرفان على جانبي الحدود طوال عامين ونصف عام. ومن غير المرجح موافقة الصين على الاقتراح الأخير، كما أن الهند لن توقف التصعيد من جانب واحد. إلى هذا، فإن الهند لا ترى إمكانية في وضع المسألة الحدودية جانباً. فهي ترى أن السلام والهدوء عند الحدود يشكلان شرطاً مسبقاً لأي علاقة صينية – هندية طبيعية. كما أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم يلتق شي جينبينغ على هامش قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” في شهر سبتمبر (أيلول)، وهذه المرة الأولى التي لا يحصل فيها اجتماع كهذا – الأمر الذي يمثل إشارة واضحة إلى عدم استعداد الهند بعد للعودة إلى تعاون طبيعي مع الصين.
لقد أدى الصدام عام 2020 إلى تصعيد المواقف الرسمية والشعبية الهندية تجاه الصين، وهذا يتضمن مواقف الجيل الهندي الجديد الذي تشكل الحرب الهندية – الصينية عام 1962 ذكرى بعيدة بالنسبة إليه. والواقع في هذا الإطار أن مسألة غياب الشفافية الصينية بموضوع جائحة “كوفيد-19″، تضافرت مع اندلاع المعارك الحدودية، فأقنعت هنوداً كثراً بأن الصين تشكل خطراً شديداً ومحدقاً على بلدهم. وأسهمت تلك التطورات في وضع حد للفكرة القائلة إن بإمكان هذين البلدين تخفيف الضغوط والمشكلات السياسية بينهما عبر الاتفاقات الحدودية والتعاون الأوسع، خصوصاً في مجالات الاقتصاد. كذلك أسهمت الأمور الآنفة الذكر، الناتجة من القلق إزاء استفزازات الصين، في تقليص المواقف المترددة في الهند تجاه تعزيز القدرات العسكرية في نواح معينة وتدعيم البنى التحتية والمضي في عقد شراكات، تحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأدت تلك النظرة التي تعتبر الصين لاعباً عدائياً لا يمكن الوثوق به إلى فرض تحولات على الحدود يرجح بقاؤها حتى بعد مرور هذه الأزمة. وقام كلا الطرفين بتعزيز حضورهما العسكري في المنطقة الحدودية بينهما حيث جرى نشر مزيد من الجنود – حتى بات “خط السيطرة الفعلية” [خط ترسيم افتراضي يفصل الأراضي التي يسيطر عليها كل من البلدين] بين المناطق التي تسيطر عليها الهند والمناطق التي تسيطر عليها الصين أشبه بـ”خط السيطرة الفعلية” بين الهند وباكستان. كذلك نشرت الهند بعض القوات التي استقدمتها من المناطق المواجهة لـباكستان، أو من وحداتها العسكرية المنضوية في عمليات مكافحة حرب العصابات في شمال شرقي الهند، بغية الدفاع عن مناطقها الحدودية المواجهة للصين. وتعزز الهند بنيتها التحتية العسكرية والمدنية في كامل منطقتها الحدودية لتوازي مستوى التعزيزات الصينية. وتلك الجهود المبذولة سوف تستمر بغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه لحل الأزمة الحدودية الراهنة، لأن الهند ستبقى متخوفة من محاولات صينية لاحقة للسيطرة على أراض هندية.
وتجلت أيضاً هذه المخاوف تجاه الصين في السياسات الهندية المحلية الداخلية، إذ انتقلت حكومة مودي من مساعيها الأولى لزيادة العلاقات وتمتين الروابط الاقتصادية مع الصين، إلى فرض القيود أو تدابير التدقيق الإضافي على مجموعة من الأنشطة الصينية في الهند. والأخيرة لا تسعى إلى الافتراق عن الصين بقدر ما تسعى إلى شيء من الانفصال والاستقلالية – وهذه مقاربة لم تصمم لإنهاء العلاقات الاقتصادية، بل لتحديد نقاط الضعف الهندية في قطاعات مهمة وحساسة، والعمل على معالجتها والتخفيف منها. ويشير مشككون (في صوابية المقاربة المذكورة) إلى المعدل غير المسبوق للتبادلات التجارية بين البلدين باعتباره معياراً لفشل المقاربة، بيد أن تجارة الهند مع الصين سجلت نمواً أبطأ بنحو 15 في المئة من معدل نمو تجارة الهند مع بقية دول العالم خلال السنة الفائتة. كذلك فإن أي مراجعة دقيقة لتلك المقاربة ينبغي أن تنتظر بضع سنوات لكي تتم. وفرض مسؤولون هنود قيوداً على الاستثمارات الصينية في الهند، وعلى وصول الصينيين إلى عقود الشراء الهندية العامة، وأيضاً على أنشطة الشركات أو المؤسسات الصينية في القطاعات الاقتصادية الحساسة وفي مجالات التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمن المجتمع المدني وقطاع التعليم. وأقدمت المؤسسات والشركات الهندية التابعة للدولة والمملوكة من قبلها، على تعليق بعض الاتفاقات مع الشركات الصينية أو الانسحاب منها كلياً. كذلك حظرت الهند عدداً من التطبيقات الصينية الشهيرة، منها منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وأبعدت شركات الاتصالات الصينية من شبكة الـ “جي 5” (الجيل الخامس) الهندية. وتستهدف سلطات إنفاذ القانون الهندية الشركات الصينية بذريعة انتهاكات تمارسها الأخيرة من ناحية التهرب الضريبي ونقل المعلومات.
وأدى التوتر مع بكين أيضاً إلى دفع نيودلهي لمحاولة تقليص الاعتماد الاقتصادي الهندي على الصين والاستفادة من رغبة دول أخرى في التعاون الاقتصادي مع الهند. وفي هذا الإطار انتقلت حكومة مودي من انتقاد المعاهدات التجارية (مع الصين) على أساس أنها تؤثر سلباً في الشركات الهندية وفي المزارعين والعمال الهنود، إلى استكشاف الاحتمالات الممكنة أو توقيع اتفاقات فعلية مع أطراف مثل أستراليا وكندا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتسعى الهند أيضاً إلى اجتذاب استثمارات أكبر من مصادر بديلة لا تقتصر فقط على الدول الغربية، بل تشمل أيضاً منطقة المحيط الهندي- الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط – تحديداً المتعلقة منها بقطاعات مثل الطاقة الشمسية والمستحضرات الصيدلانية والإلكترونيات إذ تحاول الحكومة الهندية تعزيز الإنتاج الهندي المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات الصينية.
ومن ناحية خيارات السياسة الخارجية الأوسع، دفعت الأزمة الحدودية الهند إلى زيادة تقاربها مع بلدان يمكنها المساعدة في تقوية موقفها إزاء الصين من نواحي الدفاع والأمن الاقتصادي وفي مجالات التكنولوجيا الحساسة. وتتضمن تلك البلدان أستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
الانحياز
لطالما سعت الهند في الماضي إلى الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية ورفضت الانحياز إلى تحالفات محددة. بيد أنها الآن، في الأقل، تتقرب من دول بعينها لمواجهة الخطر الذي تمثله الصين. وتبدي الهند اليوم استعداداً أكبر لتعاون وثيق مع الولايات المتحدة، على رغم أن ذلك ربما يغضب بكين. ووقعت الهند في هذا الإطار اتفاقاً لتبادل المعلومات الجيوفضائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما تشترك قواتها العسكرية هذا الشهر مع الجيش الأميركي في تدريبات على ارتفاعات شاهقة بالقرب من الحدود الهندية – الصينية، وهي غدت أكثر انتظاماً في الشراكة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المعروفة بـ”الرباعية” (التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة) على رغم الاعتراضات الصينية والروسية، كذلك اشتركت الهند في عدد من التدريبات العسكرية البحرية مع شركاء لها في “الرباعية” ووقعت اتفاق تبادل لوجستي مع فيتنام في يونيو (حزيران) 2022 وتوصلت في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى اتفاق بيع صواريخ “براهموس” (BrahMos التي طورتها الهند بشراكة مع روسيا) إلى الفيليبين.
وكانت الهند في الماضي تعاملت بحرص مع الحساسيات الصينية في ما يتعلق بتهديدات مفترضة لسيادتها. بيد أن نيودلهي اليوم تخلت عن هذا الحرص. وتحدث مودي علناً عن دعوات أطلقها مع الدالاي لاما، الزعيم الروحي لـ”التيبت”، الأمر الذي يعد افتراقاً عن تمنعه الماضي في إظهار مواقف كهذه. كذلك سهلت القوات الجوية الهندية زيارة الدالاي لاما لمنطقة لاداخ طوال شهر كامل، في يوليو (تموز) 2022. وفي ما يعد افتراقاً عن مواقفها المعهودة السابقة فإن وزارة الخارجية الهندية لم تغامر في سبتمبر (أيلول) الماضي بطرح سؤال يتعلق بالأحوال في منطقة جينجيانغ، الإقليم ذي الغالبية المسلمة في غرب الصين. لكنها أشارت مرتين إلى أن تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أضاء على “سوء معاملة خطرة بحق الأقليات” تمارس داخل الصين. وفي الأسابيع المنصرمة تحدثت الحكومة الهندية منتقدة “عسكرة مضيق تايوان” ورافضة التأكيد مجدداً على مبدأ أو سياسة “الصين الواحدة” (التي تعتبر تايوان جزءاً من الصين وترى “جمهورية الصين الشعبية” سلطة شرعية وحيدة في الصين) وذلك على رغم دعوة بكين لها للقيام بذلك، وناشدت الهند في هذا الإطار الأطراف ضبط النفس، محذرة إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لـتايبه في أغسطس (آب) الماضي من أن يقوم أي طرف بصورة أحادية بالمساس بالوضع القائم.
وأسهمت أزمة الحدود أيضاً في تشجيع تبلور وجهة نظر هندية أكثر تقبلاً للقوة والحضور الأميركيين في جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي. ففي الأعوام الماضية رحبت نيودلهي بالاتفاق الدفاعي الأميركي – المالديفي الذي يسمح بتزود طائرات الاستطلاع الأميركية بالوقود في جزر آندامان بخليج البنغال، كما ساندت الميثاق “المؤسساتي الأميركي – النيبالي لمواجهة تحديات الألفية” الذي يهدف إلى إتاحة تطوير وتنمية البنى التحتية والمساعدة في تعطيل المحاولات الصينية لإفشال الشراكة الأمنية القائمة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تلك الشراكة المعروفة بالـ “أوكوس” (AUKUS). إلى هذا تقوم الهند أيضاً بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين مثل اليابان، من شأنهم تأمين بدائل دبلوماسية وأمنية واقتصادية، ومواجهة التأثير الصيني المتنامي في البلدان المجاورة بجنوب آسيا.
وفي الوقت ذاته الذي يشهد تقرب الهند أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، تشهد علاقات الهند مع الصين ومع التحالفات المدعومة من روسيا جموداً وتعطلاً. وأظهرت أزمة الحدود مدى محدودية صيغ وروابط مثل الـ”بريكس” (BRICS التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والـ”ريك” (RIC، روسيا والهند والصين) ومنظمة شنغهاي للتعاون. فهذه الصيغ، باعتبارها منابر غير غربية، أفادت الهند حين كانت تشعر بتجاهل غربي لها. لكن الهند اليوم ترى أن الصين تشكل عقبة أمام مصالحها الإقليمية والدولية أكثر من أي دولة غربية. إلى هذا فإن جهود بكين وموسكو لإعادة تشكيل وصياغة الروابط المذكورة وتحويلها إلى منابر معادية للغرب، تسهم في تقليص فوائدها بالنسبة إلى الهند. لكن هذا الأمر لا يعني أن الهند سوف تنسحب من تلك الصيغ فوراً – فهي لا تود ترك فراغ تعمل الصين على ملئه – بل إنها مهتمة أكثر بتعميق علاقاتها مع البلدان في “جنوب العالم”، وهذا خارج نطاق أي صيغة تجمعها مع كل من الصين وروسيا.
ليس بهذه السرعة
بيد أن صناع السياسات الغربيين ينبغي أن يفكروا ملياً بالعوامل التي يمكنها الحد من سرعة ومستوى تقارب الهند مع دول مثل الولايات المتحدة في مواجهة الصين. وذاك يعود إلى أن الهند تولي الأولوية للتهديدات الصينية على نحو يختلف عن طريقة إيلائها الأولوية لشركائها. وحتى إن تركز هم الأخيرين على التحديات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الهند سوف تخصص مقداراً كبيراً من التركيز والمصادر لمواجهة التحدي الصيني والباكستاني على حدودها. هذا الهم القاري، أو الإقليمي، سوف يحدد طبيعة المقاربة الهندية تجاه المسائل الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إذ إن نيودلهي مثلاً تبقى حذرة في كلامها ومواقفها بمسألة تايوان وعلاقتها مع بلدان أخرى خشية استثارة الصين ودفعها إلى الضغط أكثر بموضوع الحدود، أو في مناطق هندية مضطربة مثل كشمير ومناطق الشمال الشرقي. كذلك لا يريد المسؤولون الهنود من الصين أن تنظر إلى خلافها الحدودي مع بلدهم من منظار التنافس الصيني – الأميركي، إذ إن قرار بكين بالذهاب إلى حرب ضد الهند عام 1962 كان نابعاً من إحساسها بأن نيودلهي وواشنطن تتواطآن لتقويض المصالح الصينية في التيبت.
كما أن الاعتماد الهندي على روسيا كشريك يزودها بالأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية سيبطئ كل مسعى لدخول الهند سريعاً في تحالفات جديدة، إذ إن رد الفعل الأولي والحذر الذي أبدته نيودلهي تجاه الاجتياح الروسي لأوكرانيا جاء في جزء كبير منه نتيجة مخاوفها من تصعيد صيني محتمل على الحدود. فنيودلهي لم تشأ العبث بجاهزيتها العسكرية عبر إغضاب روسيا، مزودها الأساسي بالأسلحة. وهي أيضاً لم تشأ أن تغير روسيا موقفها الحيادي نسبياً وتقف إلى جانب الصين في مسألة النزاع الحدودي الصيني – الهندي. كذلك تريد نيودلهي منح موسكو بعض البدائل للشراكة مع بكين من أجل تأخير أو حتى عرقلة التوطيد المتزايد للعلاقات الصينية – الروسية.
عقبة أخرى في طريق خطو الهند نحو تحالفات جديدة ربما تتمثل في ما إذا جاءت القيود الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة التي تضعها، مستهدفة الصين، لتؤدي عن قصد أو عن غير قصد إلى إعادة فرض السياسات الحمائية. فهذا يمكن أن يحد من التعاون الهندي الاقتصادي والتكنولوجي مع شركاء غربيين وآخرين من منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كذلك ربما تتسم حركة الهند بالبطء في إطار اتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع التهديد الذي تمثله الصين في المجالين الأمني والاقتصادي، نظراً إلى الأولويات الداخلية أو لأولويات أمنية أخرى. ويمكن للهند أن تحاول كسب الوقت (أو الاستقرار) مع الصين الذي من شأنه أن يكبح سرعتها وليس مسارها في السعي إلى التعاون مع شركاء آخرين تتفق معهم. كذلك ينظر صناع السياسة الهنود بعين الشك إلى إرادة عدد من شركاء الهند وقدرتهم على التمسك بمواقفهم الداعمة للهند في مواجهة الصين. إضافة إلى هذا فإن النقاش الهندي المتعلق بالصين قد يكون انحسر إلى حد بعيد، بيد أن النقاش يستمر حول مدى سرعة توطيد وتمتين العلاقات مع الولايات المتحدة، على نحو خاص، وحول مقدار التوازن الذي ينبغي تحقيقه بين الرغبة في الاستقلالية الاستراتيجية والحاجة إلى الدخول في تحالفات جديدة.
التوجه غرباً
إثر الاشتباكات التي أثارتها على الحدود عام 2020، جمدت بكين سنوات من العلاقات الصينية – الهندية المتوطدة، هذا إن لم تكن تلك العلاقات قد انقلبت رأساً على عقب مودية بالهند باتجاه آخر. وأدت تلك الأنشطة الصينية أيضاً، في رد فعل عكسي، إلى تسهيل وتقوية شراكات الهند مع عدد من منافسي الصين. وفي الآونة الأخيرة لمح وزير الخارجية الهندي سابراهمانيام جايشانكار إلى مجال التنافس الواسع بين البلدين (الهند والصين)، فرسم رؤية لآسيا مختلفة تماماً عن تلك التي تقترحها الصين. وشركاء الهند من جهتهم، بما في ذلك الولايات المتحدة، تساءلوا حول مدى قدرتهم على استمالة الهند إلى جانبهم بتحالف مناوئ للصين. هذه الدول عليها مقاربة الهند مقاربة طموحة وبراغماتية في الوقت عينه، إذ ينبغي أن تكون لدى هذه الدول توقعات واقعية تتعلق بما يمكن لنيودلهي أن تفعله في منطقة الهندي – الهادئ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أولوياتها الحدودية والإقليمية والداخلية. على تلك الدول كذلك أن تدرك أن الهند فيما تتنافس مع الصين، فهي لن تفعل هذا بالطريقة ذاتها التي تنتهجها الولايات المتحدة أو اليابان. لكن على هذه الدول أيضاً ألا تقلل من طموحاتها تجاه الهند بذريعة أن الأخيرة سترفض التعاون الأعمق – إذ إن في النهاية شعور عدم الثقة بالنفس الذي وسم الهند طوال فترة، تحول في الأعوام الأخيرة إلى انفتاح على مزيد من مظاهر التعاون. فالهند بالتأكيد ستقود سفينتها بنفسها، لكنها ستوجه الدفة نحو أولئك المهتمين بمواجهة وموازنة القوة والنفوذ الصينيين، في المنطقة والعالم.
تانفي مادان باحث بارز في برنامج السياسات الخارجية بمعهد بروكينغز، وهو مؤلف كتاب: “المثلث المصيري: كيف أسهمت الصين في رسم وجه العلاقات الأميركية – الهندية خلال الحرب الباردة” Fateful Triangle: How China Shaped U.S. – India Relations During the Cold War
“فورين أفيرز”، 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022
المصدر: اندبندنت عربية