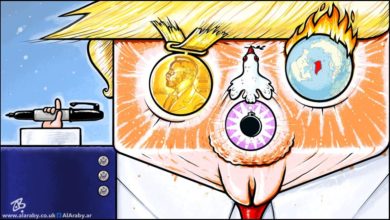يعيش الفلسطينيون منذ سنوات وضعاً مركّباً يتداخل فيه العنف الإسرائيلي المتصاعد مع أزمة فلسطينية داخلية متفاقمة تتمثّل في تآكل القدرة على الفعل الجماعي وضعف البنى السياسية والاجتماعية الحاملة له. فالتصعيد الإسرائيلي الإبادي غير المسبوق لم يحدُث في فراغ، بل يتفاعل مع بنية فلسطينية منهكة ومنقسمة، تعاني مصادرة الإرادة وتآكل الشرعية، ما يُفقد هذا التصعيد إمكان تحوّله إلى لحظة استنهاض وطني، وتحوّله بدلاً من ذلك إلى عامل إضافي يعمّق التفكّك الداخلي. وعليه، لا يقتصر الخطر الراهن على حجم الخسائر البشرية والمادية، بل يتجاوز ذلك إلى تشابك التحدّيات السياسية والمؤسّسية والاجتماعية، واتساعها ضمن سياق إقليمي ودولي سريع التحوّل، يقلّص باستمرار هامش الحركة الفلسطينية، ويهدّد بتآكل ما تبقى من إطار جامع للقضية الفلسطينية.
فالضفة الغربية اليوم تُنهب وتُستباح على نحو متواصل من دولة الاحتلال ومستوطنيها، من دون كلفة سياسية تُذكر، بينما السلطة الفلسطينية في رام الله في واحدة من أضعف لحظاتها التاريخية، بعد أن فقدت جزءاً كبيراً من مقبوليتها الداخلية، وبعد تراجع وزنها وفاعليتها إلى حدّ باتت معه شبه غائبة من الحسابات الإقليمية والدولية الكبرى التي يُعاد رسمها لمستقبل المنطقة. وفي غزّة، لا يقتصر الخطر على الإبادة والتجويع والحصار، بل يتجاوز هذا إلى المضي في مصادرة القطاع من الفلسطينيين أنفسهم، وتحويله إلى غنيمة تُدار بقرارات خارجية أو تفاهمات فوقية لا تعكس إرادة أهله. أمّا نصف الشعب الفلسطيني في الشتات، فيعيش حالةً غير مسبوقة من اليُتم السياسي، بعدما تكسّرت أوهام التمثيل والحماية والدعم، وتراجعت هوامش الفعل والقدرة الفلسطينية على التأثير في مصيرهم، بالتوازي مع انكشاف حجم الصمت والتواطؤ العربي والدولي.
وإذا كان جوهر النضال الفلسطيني الانعتاق من قيود الظلم والقهر، فإن هذا النضال يبدأ، بالضرورة، من انتزاع الحقّ في تمثيل الذات ومنع مصادرته، لا في الخارج وحده، بل في الداخل أيضاً. فكفاح أيّ شعب ضدّ ظلم خارجي، كالاحتلال الإسرائيلي، لا يستقيم ولا يكتسب استدامته أو جدّيته الكاملة ما لم يقترن بكسر القيود الداخلية التي تفرضها قوى تحتكر التمثيل وتتحدّث باسم الناس من دون تفويض ديمقراطي أو انتخابات. ذلك أن نضالاً يرفع راية التحرّر لا يمكنه، من دون تناقض جوهري، أن يتجاهل حقّ المجتمع في اختيار من يمثّله ومحاسبته؛ فغياب هذا الحق يفرّغ الخطاب التحرّري من مضمونه، ويحوّل المقاومة من مشروع تحرّر جماعي إلى ممارسة منفصلة عن إرادة الناس، التي يفترض أنها جوهر هذا النضال.
الاعتراض على وصاية الخارج لا يكتسب جدّيةً ولا يكتمل معناه ما لم يقترن برفض الوصاية القسرية في الداخل أيضاً
صحيح أن الكفاح ضد الاحتلال لا يفقد مشروعيته، لكنّه يفقد اتساقه الداخلي حين يُبنى على علاقة غير تحرّرية بين القيادة والمجتمع، فالاحتلال لا يجرّد الفلسطيني من أرضه فحسب، بل يسلبه القدرة على الفعل والسيادة على ذاته، وأيُّ بنية داخلية تعيد إنتاج هذا الحرمان، ولو بلغة وطنية رفيعة، تشارك من حيث الأثر في المنطق نفسه. من هنا، لا يُعدُّ انتزاع الحقّ في تمثيل الذات أمراً عابراً أو مسألة إجرائية، بل فعلاً تحرّرياً بحدّ ذاته، لأنه يعيد للإنسان موقعه بوصفه صاحب القضية، لا مجرّد موضوع تُدار باسمه. وعليه، يصبح النضال التحرّري مساراً مزدوجاً لا يقبل التجزئة: مواجهة الخارج الذي يسلب الأرض والحقوق، ومواجهة الداخل الذي يصادر الإرادة ويجمّد المجتمع في موقع المتلقّي. فلا تحرّر بلا مواطنين أحرار، ولا مقاومة مستدامة بلا مجتمع يشعر أن هذه المقاومة تعبّر عنه فعلاً، لا أنها تُدار باسمه من فوق. إن كسر القيود الداخلية لا يضعف النضال، بل يعمّقه، ويحوّله من بطولة نخبوية معزولة إلى مشروع جماعي حيّ، يتجدّد من القاعدة، ويستمدّ شرعيته من الناس، لا من الماضي فقط.
ويتّضح هذا المأزق بجلاء عند النظر إلى الواقع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزّة معاً، فالسلطة الفلسطينية، التي تُبدي امتعاضاً مستتراً من إنشاء ما يُسمّى “مجلس السلام” الأميركي لإدارة غزّة، مطالبة بمواجهة مفارقة أخلاقية وسياسية صارخة: ألا تتحوّل، في منطقها العملي، إلى صورة موازية لذلك المجلس. فكلا الطرفين (السلطة والمجلس)، على اختلاف السياق واللغة ولحظة التكوين، يفتقدان المصدر نفسه للشرعية، أي الإرادة الفلسطينية الحرّة، فمجلس يُفرض على غزّة بقرار خارجي لا يجسّد اختيار أهلها، تماماً كما أن سلطة تدير البلاد من دون تفويض انتخابي متجدّد لا تجسّد، هي الأخرى، الاختيار الحرّ للفلسطينيين. ومن هنا، فإن الاعتراض على وصاية الخارج لا يكتسب جدّيةً ولا يكتمل معناه ما لم يقترن برفض الوصاية القسرية في الداخل أيضاً؛ فالتحرّر لا يكون انتقائياً، إمّا أن يكون تحرّراً شاملاً يعيد للشعب حقّه في اختيار من يحكمه ويمثّله، وإما أن يتحوّل إلى خطاب سيادي موجّه للخارج، مُفرغ من مضمونه في الداخل.
لا تُبنى الدولة بالمؤسّسات والحدود وحدها، بل بالجينات السياسية والأخلاقية لمن يؤسّسونها ويديرونها
وتبلغ خطورة هذا المسار ذروتها حين يُنقل النقاش إلى أفق الدولة الفلسطينية العتيدة التي لا تزال القيادة الفلسطينية تراهن عليها؛ إذ إن دولة “يجود” بها الخارج، من دون تفويض داخلي حرّ، ومن غير تقاليد راسخة لاكتساب الشرعية، ستولد ميتةً بحكم تبعيتها وضعفها البنيوي. فهي ستكون منذ لحظتها الأولى مثقلةً بشروط الإذلال والإضعاف والإلحاق، بما يحوّلها من أفق تحرّري إلى عبء إضافي على الفلسطينيين. فالدولة لا تُبنى بالمؤسّسات والحدود وحدها، بل بالجينات السياسية والأخلاقية لمن يؤسّسونها ويديرونها، وإذا كانت هذه الجينات مشبعةً بمنطق الوصاية واحتكار التمثيل وإدارة المجتمع من فوق، فإن الدولة المقبلة لن تتجاوز أزمة السلطة القائمة اليوم، بل ستعيد إنتاجها في إطار سيادي شكلي أكثر خطورة. لذلك، يصبح الحديث المتكرّر عن الدولة الفلسطينية أقرب إلى هروب لفظي من مواجهة الأسئلة الجوهرية: فالدولة لا تُنتزع بتكرار المطالبة بها، ولا تُبنى بالرموز وكثافة المراسيم وزيادة عدد السفارات والاعترافات الدولية، ولا يمكن أن تقوم على أنقاض مجتمع مفكّك ومصادَر الإرادة، بل تبدأ بإصلاح الداخل واستعادة القدرة على الفعل المشترك لتأمين سيادتها الحقيقية، وبناء تمثيل سياسي صادق، وإعادة تأسيس علاقة سليمة بين المجتمع وقياداته.
أيّ تحرّر مستدام يفترض حسم معركة الداخل المنسية أولاً؛ فهذه المعركة ليست تفصيلاً ثانوياً ولا ترفاً سياسياً، بل تمثّل جوهر الأزمة الفلسطينية اليوم، لأنها في أصلها أزمة تمثيل لا تحرّر. فلا تحرّرَ حقيقياً من دون تماسك وطني متين، ولا يمكن لهذا التماسك أن يتحقّق في غياب تمثيل سياسي شرعي، كما لا تماسك مستداماً من دون مساءلة فعلية، ولا مساءلة مجدية ما لم تُكسر بوضوح أنماط الوصاية واحتكار القرار التي قوّضت السياسة الفلسطينية وأفرغتها من معناها. إن استمرار تجاهل ضرورة الترميم/ إعادة التأسيس لوقف التهتّك الداخلي يعني إبقاء الفلسطينيين عالقين بين احتلال يتغذّى من انقسامهم وتفتّتهم، وقيادات عاجزة عن تجديد شرعيتها، وواقع دولي لا يتنظر أحداً ولا يمنح الحقوق لمن لا يمتلك القدرة على تمثيل ذاته. وما لم تُحسم هذه المعركة بوصفها أولويةً قصوى، ستظلّ معارك الخارج كلّها، مهما عظمت تضحياتها، تدور في حلقة مفرغة، تستنزف الفلسطينيين، وتبدّد تضحياتهم، وتحوّل التحرّر من أفق ممكن إلى وهم مؤجّل.
المصدر: العربي الجديد