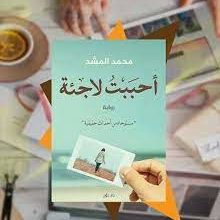كتب عبد الرحمن الكواكبي (1855 ـ 1902) في مطلع القرن العشرين، عن الاستبداد وآثاره المدمّرة على الشعوب. وكان يرى أنّ الأمّة إذا اعتادت الذلّ، وتوالى عليها الاستبداد جيلاً بعد جيل، تفقد تدريجياً حسّها بالحرية وقيمتها للاستقلال، حتى تغدو أقرب إلى القطيع منها إلى جماعة بشرية تطمح للتغيير. هذه الرؤية، وإن كُتبتْ منذ أكثر من قرن، لا تزال صالحةً لوصف المشهد العربي بعد ما سُمّي “الربيع العربي” في عام 2011. لقد خرجت الشعوب العربية إلى الشوارع مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، رافعةً شعاراتٍ بسيطة، ولكن قوية: “الشعب يريد إسقاط النظام”، “الموت ولا المذلة”. كانت اللحظة استثنائية، أعادت إلى الأذهان ثورات أخرى في التاريخ الحديث، من الثورة الفرنسية عام 1789 إلى سقوط جدار برلين عام 1989. بدا وكأن العرب أخيراً انخرطوا في مسار التاريخ العالمي نحو الديمقراطية. لكن سرعان ما اصطدمت تلك الأحلام بالواقع المرّ: أنظمة عريقة في الاستبداد، نخب متشبثة بالسلطة، ومجتمعات لم تُتح لها فرصةُ بناء مؤسّسات مستقلة قادرة على حماية مكتسباتها.
في مصر، التي شكّلت قلب الموجة الأولى من الثورات، عاش الناس لحظة أمل بسقوط نظام حسني مبارك، ولكن سرعان ما تكرّر سيناريو الكواكبي: استبدال مرض بمرض. انتقل الحكم من استبداد عسكري مموّه إلى صراع حادّ بين سلطة دينية صاعدة ومؤسّسة عسكرية متجذرة، قبل أن يعود الجيش ليمسك بزمام الأمور بقبضة أشد عسفاً ممّا كانت عليه. بدل أن يُترجم حلم الحرية بناءَ نظام ديمقراطي تعدّدي، تحوّل خيبة أمل جديدة. في تونس، مهد الشرارة الأولى، ظنّ كثيرون أنّ “الاستثناء التونسي” سيصمد. لكن التجربة الديمقراطية، رغم ما حققته من إنجازات دستورية وانتخابات نزيهة نسبياً، واجهت هشاشةً اقتصاديةً وانقسامات سياسية عميقة. ومع الوقت، عاد منطق الشخص الواحد الحاكم ليطلّ برأسه من جديد، وكأنّ عقارب الساعة تدور إلى الوراء. أمّا في ليبيا واليمن وسورية، فتحوّلت الثورات حروباً أهليةً مفتوحةً، تدخّلت فيها قوى إقليمية ودولية، وحوّلت الأمل بالتغيير كابوساً دموياً. بدل أن تنكسر حلقة الاستبداد، ازدادت الشعوب إنهاكاً وفقدت ما تبقّى من ثقة بجدوى الثورة. والنتيجة أنّ شعارات الحرية والعدالة تراجعت أمام مطلب أساس وأكثر بدائية: الأمن والبقاء.
ليس هذا السيناريو المأساوي مصادفةً، بل له جذور تاريخية عميقة، فالدولة العربية الحديثة، منذ الاستقلال في منتصف القرن العشرين، بُنيت غالباً على أنقاض الاستعمار من دون أن تُؤسَّس على قاعدة مؤسّساتية صلبة. وما لبثت أن تحوّلت دولةً أمنوقراطية، يحكمها حزب واحد أو زعيم واحد، باسم الشرعية الثورية أو القومية أو المقاومة. ولأنّ الاستبداد امتدّ عقوداً طويلة، فقد تكلّست معه الثقافة السياسية، وغابت الممارسة الديمقراطية، حتى إنّ مفهوم المعارضة نفسه أصبح مرادفاً للخيانة. كان الكواكبي محقّاً حين وصف الشعوب المقهورة بأنها قد تنتفض أحياناً، لكن بدافع الانتقام من شخص الحاكم لا بدافع التخلّص من الاستبداد منظومةً، وهذا ما رأيناه في كثير من بلدان “الربيع العربي”: سقوط رأس النظام لم يعنِ سقوط البنية العميقة للاستبداد. فالشرطة والأجهزة الأمنية والبيروقراطيات القديمة بقيت في مواقعها، وأعادت إنتاج ذاتها بسرعة، مستفيدةً من غياب قيادة ثورية قادرة على إعادة بناء الدول على أسس صحيحة.
لم يكن “الربيع العربي” خطأً، بل كان ضرورةً تاريخية
تبيّن التجارب التاريخية في مناطق أخرى أن التغيير العميق يتطلّب وقتاً وصبراً، بل أحياناً صدمات متكرّرة. أوروبا احتاجت إلى قرون من الصراعات الدموية قبل أن تستقرّ على أنظمة ديمقراطية. أميركا اللاتينية عاشت دورات متتالية من الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية قبل أن تُرسِّخ تجاربها الديمقراطية. لكن، الفرق أن المجتمعات هناك امتلكت نخباً فكرية وسياسية استطاعت مع الزمن أن تُراكم خبرة في التنظيم والمساءلة. أمّا في العالم العربي، فما زال هذا المسار في بدايته، إن لم يكن متعثّراً عند الخطوة الأولى. اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الثورات، يسود شعور بالإحباط وربما اللامبالاة في صفوف أجيال عايشت الحلم الكبير ثمّ رأت كيف تحوّل كابوساً. ولكن، رغم هذه الخيبة، لا يمكن القول إنّ “الربيع العربي” انتهى بلا أثر. على العكس، لقد كسر حاجز الخوف لدى ملايين المواطنين، وفتح الباب أمام وعي جديد بقيمة الحرية والكرامة. وحتى لو عادت الأنظمة المستبدّة إلى السلطة، فهي لن تكون مطمئنةً كما كانت قبل 2011. فالشعوب جرّبت النزول إلى الشوارع، وعرفت أنّ الاستبداد ليس قدراً أبدياً.
إذا كان الاستبداد شوّه طبائع الناس عبر قرون، فإنّ التخلّص منه يحتاج بناءً طويل المدى، لا إلى انتفاضة عابرة. يحتاج إلى فصل المؤسّسة الدينية عن العمل السياسي، وإلى إعادة الاعتبار للتعليم، وإلى ترسيخ ثقافة المساءلة، وإلى نخب سياسية لا ترى السلطة غنيمةً، بل مسؤولية. هذا هو التحدّي الحقيقي أمام العالم العربي: كيف نحوّل الغضب الشعبي إلى مشروع بناء؟ وكيف نجعل من الحرية مطلباً دائماً لا مجرّد صرخة في لحظة يأس؟
في النهاية، لم يكن “الربيع العربي” خطأً، بل كان ضرورةً تاريخية. الأخطاء كانت في إدارة المرحلة التالية، في غياب الرؤية، وفي سرعة عودة قوى الماضي إلى السيطرة. لكنّ الشعوب التي كسرت الصمت مرّة، قادرة على أن تفعلها مرّة أخرى. وبين التشاؤم المبرّر والأمل الضروري، يبقى المستقبل مفتوحاً، ولو على طريق طويل وشاق. وإن كان الاستبداد مرضاً عضالاً، لكنّ دواءه موجود، وإن تأخّر استعماله.
المصدر: العربي الجديد