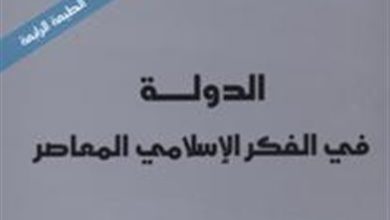بعض التصورات الشائعة لدى بعض الباحثين، والأكاديميين فى العالم العربى، تتسم بالجمود فى نظرتها للدولة ككيان رمزي متعالٍ عن مكوناتها والسلطات الثلاث وأجهزتها، وهو ما يمتد إلى مفهوم السيادة في عالم معولم متغير تخضع فيه لموازين القوة في النظام الدولي وفواعله وشركاته العابرة للدول والأسواق . هذا الجمود في الإدراك والوعى يعود إلي شيوع المقاربات الدستورية الشكلية والوصفية في النظر الى مفهوم الدولة القومية الحديثة في الدرس الاكاديمي ، ناهيك عن غياب بعض المتابعات النظرية والتطبيقية في النظريات السياسية المعاصرة عن تطور الدولة والسلطة والاقتصاد ، والتكنولوجيات المتطورة ، والرأسمالية في طورها النيوليبرالي ، والقوى الاجتماعية والتغير الاجتماعي وتأكلات بعضها كالطبقات الوسطي فى المجتمعات الأكثر تطورا في عالمنا.
أدت الثورات الصناعية من الاولي إلى الرابعة إلي تأثيرات كبيرة في الدولة ، والسلطة، ومفهوم السيادة، وعلى الديمقراطيات الليبرالية والثقافة السياسية الحاملة لها. من ثم أثرت على الحريات العامة، وخاصة مع ثورة الاستهلاك المكثف، وهو ما أدى إلى تغيرات كبرى فى مفهوم الحريات العامة والشخصية، وتحولت حرية الاستهلاك الفعلى أو المأمول والمرغوب إلى الحرية المركزية، التى كرست الفردية المفرطة، وإلى تشيئ الإنسان، وإلى إزاحتها وتهميشها النسبي لبعض الحريات العامة لا سيما السياسية، بالنظر إلى أن هذه الحريات تمارس فى إطار نظام الاستفتاءات العامة الذى يمارس فى بعض الحالات والشروط ، ونظام الانتخابات الرئاسية، خلال سنوات ما بين خمس إلى ست سنوات فى بعض الأنظمة الانتخابية. من ثم لا يمكن تغيير التركيبة الحكومية او الأعتراض علي بعض مشروعات القوانين من الجماعة الناخبة ، او علي سياسة رئيس الجمهورية كما في النظام شبه الرئاسي الفرنسي او الرئاسي الأمريكي ، إلا بعد انتهاء المدد المحدودة دستوريا وقانونيا لمدد الولاية الرئاسية .
من هنا تبدو إمكانيات التغيير السياسى من الجماعة الناخبة رهناً بانتهاء هذه المدد، لكى يمارس الفرد الناخب أو الجماعة الناخبة الحق فى تغيير التركيبة الحكومية والبرلمانية او رئيس الجمهورية .
الحريات السياسية الأخرى، خضعت لمؤثرات طاغية تمثلت فى الصحف والمجلات، والقنوات التلفازية ، والفضائية الحكومية، والأهم الخاصة المملوكة لبعض الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاعلام، وتخضع لطبيعة المصالح الاقتصادية والسياسية لممولي هذه الشركات الضخمة، التى باتت مؤثرة على اتجاهات الرآى العام فى الولايات المتحدة وكندا وأوربا الغربية، وخاصة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وما بعدها.
قامت أجهزة الإعلام والصحف والمجلات بتوظيف المفاهيم الليبرالية، والديمقراطية، كل وفق مصالحه على نحو كرس نسبيا بعض الفجوات بين هذه الحريات، في الخطابات الإعلامية، وبين واقع السياجات الناعمة التي تؤطّر ممارسة الفرد لها فى الحياة العامة واليومية.
من هنا كان التأثير الطاغى لتوظيفات مفهوم الحريات السياسية، والفردية لصالح الرأسمالية النيوليبرالية خاصة من قبل الشركات الرأسمالية الكبرى وأثرها على بعض الإدراك والوعى الفردى وشبه الجمعى، فى السلوك السياسى، والاجتماعي واليومى.
أدت هذه التوظيفات الرأسمالية للإعلام إلى تحول الحريات إلى تمثيل، واستعراض إعلامى متلفز ومقروء ومسموع قبل الثورة الرقمية، وإلى هيمنة سياسات تسليع الحريات التى تسيطر عليها الشركات الإعلامية الضخمة، والمصالح الاقتصادية الكبرى لمموليها ، وإلى سطوة الإعلان، وشركات العلاقات العامة ، لا سيما فى الولايات المتحدة، ثم إلى أوروبا الغربية، وامتدت من مجالات السينما، إلى السياسة والسياسيين نسبيًا ومجالات ترويج الإستهلاك والخدمات.
خضع المواطن الفرد للشبكات الإعلامية وسياجاتها الناعمة حول الحريات ، وبات اسيرًا لها فى الأفكار السياسية والاجتماعية، والأهم فى مجال الترويج للسلع والخدمات، والاستهلاك المفرط، ومن ثم إلى تسليع السلوك الفردى والجماعى إلى حد ما.
أدى تطور الشركات الرأسمالية الكبرى والمصارف، على المستوى الكونى/ العولمى إلى التأثير على مفهوم السيادة، وذلك من خلال سياسات هذه الشركات الضخمة فى استثماراتها والعابرة للحدود والأسواق الإقليمية والوطنية من خلال إشكال معقدة من داخل الأنظمة القانونية، للدول المختلفة، ولا سيما دول جنوب العالم، التى باتت غالبها خاضعة لشروط هذه الشركات ، والمصارف العابرة للحدود والأسواق ومعها أيضا المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي ..الخ .
على مستوى الدول الغربية الأكثر تطورًا، باتت هذه الشركات والمصارف الضخمة، مؤثرة على سياسات الدول والأنظمة الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وتداخل تأثيرها على أداء البرلمانات، والحكومات، والأحزاب السياسية.
لا شك أن هذه التحولات فى إدراك ، وهيمنة الشركات والمصارف الرأسمالية الضخمة، أدت إلى انعكاسات سلبية على النظم الديمقراطية الليبرالية وتأكل بعض من مكوناتها ، وفق عديد الدراسات الغربية، ووصفها بعضهم Yacha Mounk فى كتابه The People Vs Democracy بتأكل الديمقراطية الليبرالية وارتباط الديمقراطية بالليبرالية، فى مسارها ، وحدث بعض الانفصال بينهم، وصعود بعض الحكومات، الليبرالية التى تسيطر عليها النخبوية، والتكنقراطية، والقضائية، وخاصة فى أعقاب نهاية الحرب الباردة. ثم مع النيوليبرالية .
لا شك أن هيمنة حرية الاستهلاك المفرط ساعدت على حالة من التهميش الفردى، وتمدد الشعور بالتفاوتات الطبقية داخل المجتمعات الغربية الأكثر تطورًا، وخاصة مع القفزات التكنولوجية فائقة التطور، والسرعة والمتلاحقة، وبروز مشكلات الاندماج الاجتماعى، لمواطنين –من ذوى أصول غير أوروبية، وأديان ومذاهب وأعراق مختلفة -،عن غالبية مواطني هذه المجتمعات، وخاصة فى أوروبا، وهو ما أدى إلى ظهور الاتجاهات اليمينية المتطرفة، وكراهية الأجانب، والاسلاموفوبيا، وهو ما أدى إلى شيوع الاتجاهات الشعبوية، التى تنطق باسم مصالح الشعب، والإرادة العامة باسم الأمة ، وإنماء الشعور شبة الجماعى بكراهية النخب الحاكمة ، والزعامات السياسية ما بعد الحرب الباردة، التى يفتقر بعضها إلى الملكات والقدرات السياسية للنخب السياسية ما قبل وما بعد الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة . تمثل مخاطر هذا النمط من الزعامات الشعبوية السياسية في محاولاتهم التشكيك فى فاعلية النظام الديمقراطى الليبرالى من خلال محاولات المساس باستقلال القضاء، وحرية الصحافة ، والإعلام على نحو ما فعل، ولا يزال دونالد ترامب بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية، ومضى أكثر من مائة يوم من حكمه، ويتم ذلك تحت مقولات أمريكا أولًا، وأمريكا عظيمه.
ساعد على صخب الشعبوية ،،وأزمة الدولة ، والنظام الديمقراطى الليبرالى أزمة المحكومية، وقابلية الأفراد للأنضواء والمشاركة في المؤسسات السياسية، والتفاعل معها، وهى ظاهرة بدأت فى نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضى، ولا تزال، وتتمثل فى تراجع بعض نسب المشاركة فى الانتخابات العامة، وعدم مشاركة بعض أقسام من الجماعات الناخبة فى الاقتراع العام، وخاصة مع بعض من التأكل فى بنيان الطبقات الوسطى، وازدياد نسب الضرائب وارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات كالنفط والغاز .
كرست الشعبوية، وأزمات الديمقراطيات الليبرالية تطور الرأسمالية النيوليبرالية، التى يعتبرها بعض الباحثين الغربيين – Wendy Brown -فى كتابه فى أنقاض النيوليبرالية إنها تمثل مشروع لتأكل الديمقراطية الليبرالية، وليست كما تصورها منظرو مدرسة شيكاغو فريدريش هايك ، وميلتون فريدمان، كمشروع لتحرير الأسواق، وإنما هى مشروع لإعادة تشكيل الفرد والمجتمع والسيادة، وإنهاء ساهمت فى إضعاف وتأكل الثقافة والقيم السياسية الديمقراطية ومن ثم ساهمت فى تفنيت، وتفكيك نسبى للسلطة، وإعادة تشكيل الفرد كمشروع استثمارى ذاتى، ( موقع أفكار عن نظريات العدالة علي الفيس بوك) ، ومن ثم خشوع غالب تفاصيل الحياة والأفراد إلى قانون السوق، ومن ثم تسليع كل شيء، ومن ثم الشعبوية كانت جزءًا من سياسات النيوليبرالية.
في هذا الصدد لاحظ بعض الكتاب البارزين مثل كوين سلوبوديان – Quinn Slobodian – ان بعض المفكرين النيوليبراليين مثل موراي ووثبات ، وتشارلز موراي بعد نهاية الحرب البارد ، وتفكك الكتلة الشيوعية السوفيتية ذهب بعضهم إلي أن تهديد الرأسمالية الغربية لم ينتهي بنهاية الدول الشيوعية ، وأنما بات يتمثل في الحركات الاجتماعية الجديدة مثل النسوية ، والحقوق المدنية ، والبيئة ، ومن ثم ذهب بعضهم وفق كوين سلوبودان بضرورة التحالف الجديد الذي يجمع بين النيوليبرالية والتفوق العرقي ، وذلك علي بعض المبادئ كما ورد في كتابه – أبناء هايك :الجذور النيوليبرالية لليمين الشعبوي – وحدد هذه المبادئ فيما يلي:
- الطبيعة البشرية الموروثة ،والاعتقاد في الفروق العرقية والذكاء موروثة علي نحو يبرز التفاوتات الاجتماعية .
- الحدود الصارمة للدول الغربية ، ورفض الهجرة حفاظا علي النقاء الثقافي والاقتصادي .
- المال الصلب ،والدعوة للعودة إلي معيار الذهب أو العملات المشفرة كأداة لمواجهة السياسات الحكومية .
من ثم يذهب إلي أن حركات اليمين المتطرف ليست تمرداً علي النيوليبرالية ، وإنما هي تطور داخلي لها ويعيد تشكيلها بطرق تبرز التميز والتفاوتات بين الأفراد . ( انظر ملخص وجيز جدا للكتاب علي موقع : أفكار عن نظريات العدالة علي فيسبوك ).
ثمة من يري من بعض الكتاب مثل ماتياس سايدل – Matias Saidel – في كتابه النيوليبرالية المعاد تحميلها : الحوكمة السلطوية وصعود اليمين المتطرف – ان ثمة تقاطع مابين النيوليبرالية والسلطوية ، وأنها لم تعزز سياسات السوق الحرة ،بل أدت إلي تمكين الأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة من خلال تحالفات وممارسات قمعية وخاصة بعد ازمة 2008 ،ومن ثم لم تعد محض إطار اقتصادي ، وانما تحولت إلي نظام حوكمة يعزز السلطوية والقومية العرقية والعنصرية مع الحفاظ علي مبادئ السوق الحرة . في هذا الصدد ذهب إلي إبراز أن النيوليبرالية تستخدم لفرض سياسات قمعية ضد الفئات الاجتماعية المهمشة ،مثل الأقليات العرقية والنساء من خلال تعزيز التنافسية كمعيار وحيد للنجاح . وان القوي اليمينية المتطرفة استبدلت عداءها للشيوعية إليّ النسوية ، ومعها أيضا التحول الجنسي علي نحو مافعل ترامب ، ويعتبر اليمين المتطرف والشعبوية انهم يمثلون تهديداً للنظام الاجتماعي . من ثم يعتبر سايدل ان النيوليبرالية ان النيوليبرالية ليست سياسات اقتصادية فقط ، وانما مشروعا سياسيا يعزز السلطوية ويقيد الديمقراطية . ( انظر موقع أفكار عن العدالة سابق الذكر ) .
لا شك أن الشعبوية القومية المتطرفة والعرقية، أثرت أيضا وعلي نحو سلبي على الثقافة السياسية الليبرالية الديمقراطية، ومؤسساتها وعلى الأفراد، والحريات، وذلك لصالح خضوع الفرد اسيرا لحرية الاستهلاك المفرط، وسياجاتها الناعمة وغوايتها وشبقها ، ومن ثم تحول الفرد إلى سلعة فى السوق، وهو ما سوف يزداد فى ظل عدم تبلور اتجاهات سياسية مضادة للنيوليبرالية، وداعية لإصلاحات فى المؤسسات السياسية على نحو ما حاوله بعضهم فى حركة السترات الصفراء الفرنسية التى تشكلت على الحياة الرقمية، من عناصر تنتمي إلي الطبقة الوسطى، وتظاهرت فى جميع أنحاء فرنسا، ثم تراجعت . مشكلة قادة النيوليبرالية والشعبوية إنهم لا يبالون سوى بمصالحهم الخاصة وتعظيم الربحية خاصة مع الشركات الرقمية الضخمة التى باتت تسيطر على المعلومات الضخمة ، والأسواق والشركات، بل وتؤثر على سياسات الدول والسلطات فى الدول الأكثر تقدما.
المصدر: الأهرام