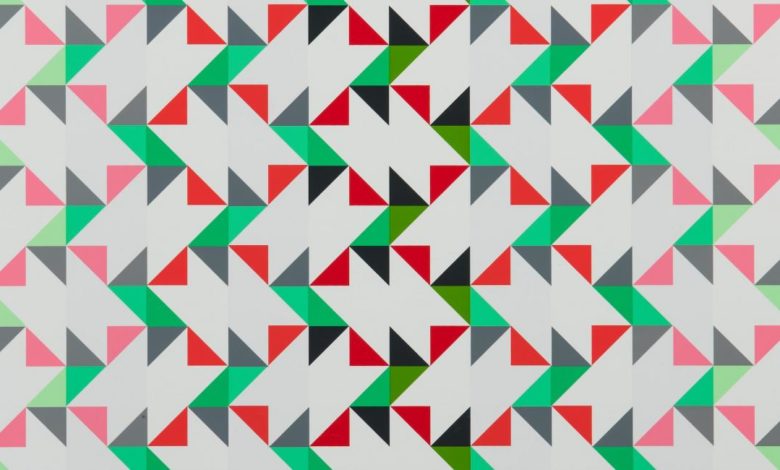
اعتاد الغرب أن يرى في العرب مجموعةً من الماكرين والمخادعين والمستبدّين والضعفاء، الذين يملكون الأموال والنفط، لكنهم لا يفهمون إلّا لغة القوة تحت عنوان تطوير بلدانهم وحمايتها. كانت هذه القاعدة الأساسية التي شرّع فيها الغرب استعماره بلادنا العربية، وكتب عنها بإسهاب وشرحها المفكّر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد في كتابه “الاستشراق” (1978). وما لبثت هذه النظرة النمطية إلى العالم العربي أن اتخذت بُعداً جديداً بعد “11 سبتمبر” (2001)، وتمثّلت بإلصاق تهمة الإرهاب والتطرّف بالعرب، وتحت هذا العنوان أيضاً، شُرِّع احتلال الأرض العربية، والسيطرة على مقدّراتها، بذريعة الدفاع عن الأمن القومي الغربي، لتقسّم في ما بعد بين مجموعات طائفية ومذهبية متناحرة.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، أعادت السياسةُ الغربية، والتعاطي الإعلامي الغربي، مفهومَ الاستشراق إلى الواجهة. على المستوى الإسرائيلي، لم يجد المسؤولون الإسرائيليون الحرج في استخدام تلك النظرة الغربية التي تتجاوز الاستعلاء لتعبّر بشكل مباشر عن تحقير الإنسان العربي. وللمفارقة، لاقت هذه اللغة القبول والرواج، ليس لدى الحكومات الغربية فقط، بل في وسائل إعلامه أيضاً، من خلال وصف الفلسطينيين، طوال مدّة الحرب على غزّة، أحيانا كثيرة، بـ”الوحوش”، و”الحيوانات البشرية”، وغيرها من التسميات المُهينة. وتكرّست هذه النظرة في الأداء الاستعلائي (الإعلامي والرسمي) في التعامل مع الأصوات والتحرّكات العربية، التي رفضت (ولا تزال) الإبادة الإسرائيلية، وذلك باتهام كلّ من يناصر غزّة ويرفض الاعتداءات الاسرائيلية بـ”دعم الإرهاب” وبـ”معاداة السامية” وبـ”العنصرية” وغيرها من الاتهامات الجاهزة.
ومع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، استُعيد الخطاب الاستشراقي بكلّ جوانبه، لا سيّما في تعامله مع عدة دول عربية أنها منبع للأموال يجب أن تنصاع لمشاريعه، وإلّا فإن سيف العقوبات سيكون مسلّطاً عليها وعلى شعوبها. في هذا الإطار، لا بدّ من لفت النظر إلى أن هذا المشهد يدلّ على أن كلّ السياسات التي اعتمدتها بعض الدول العربية، من الانفتاح إلى التطبيع باسم التسامح، لم تستطع أن تغيّر بعضاً من هذه الصورة النمطية تجاه العرب.
على المستوى العربي، من السهل رصد تأثّر الثقافة العربية نفسها ببعض أفكار نظرية الاستشراق إلى حدّ التماهي معها أحياناً، لا سيّما في ما يتعلّق بتصديق حتمية التفوّق الغربي في مختلف المجالات، وباندهاش لا يتوقّف بالحضارة الغربية، رغم غنى الحضارة العربية وريادتها ودورها، حتى في تشكيل النواة الأولى لحضارات الغرب في شتى المجالات. صدّق العرب أنهم ضعفاء، وأنهم لا يستطيعون حكم أنفسهم بأنفسهم، وأنهم يحتاجون، بالتالي، إلى الوصاية الغربية، ولو بعناوينَ وأشكالٍ مختلفةٍ للتطوّر والتقدّم.
المثال الأبرز للهوان العربي قضية فلسطين، منذ نكبتها في 1948، وصولاً إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة التي أعادت بقسوتها مشاهد النكبة
ولا تقتصر آثار هذه الثقافة على المظاهر الاجتماعية والحياتية والعلمية والاقتصادية، ولكن أيضاً (وربّما قبل أيّ جانب آخر) في العمل السياسي العربي، والذي تجسّد بتاريخ طويل من التنازلات والانقسامات بسبب الصراع على السلطة والنفوذ، الذي يفتح بدوره الباب على مصراعيه للتدخّلات الأجنبية. ولعلّ المثال الأبرز للهوان العربي قضية فلسطين، منذ نكبتها في 1948، وصولاً إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة التي أعادت بقسوتها مشاهد النكبة، واستعاد قسم كبير من الناس مشاهدَ حقيقية لمقارنتها وإظهار مدى تطابقها مع مشاهد التهجير والقتل ضدّ الفلسطينيين التي حدثت في غزّة. وكما راهن أهل فلسطين على الجيوش العربية في 1948 لنصرتهم، راهن أهل غزّة في هذه الحرب على الدول العربية، شعوباً وحكّاماً، لإغاثتهم، وللضغط على حلفائهم الغربيين لوقف الإبادة الإسرائيلية ضدّهم. وكما في كلّ حرب واعتداء إسرائيلي، لم يجد الغزّيون إلا البيانات الإعلامية على مدى أكثر من عام ونصف العام، وصدرت بشكل خجول لتهدئة احتقان الشعوب العربية. وقد تزامن ذلك مع تفكّك جبهات المساندة التي انطلقت من لبنان واليمن والعراق، وسقوط ما يعرف بـ”محور المقاومة”، لا سيّما بعد خسارة لبنان الحرب وإخراجه من المشهد، وبعد سقوط النظام السوري، علماً أن هذا الأخير لم يقم بأيّ خطوة لدعم غزّة أو لبنان خلال الحرب، بل على العكس، منع فتح جبهة الجولان في الحرب الماضية، ورفض إطلاق رصاصة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي، رغم كلّ اعتداءاته على الأراضي السورية.
ومنذ ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي، بدأ عرّاب الديبلوماسية الأميركي هنري كيسنجر بتطبيق سياسة تدمير الالتفاف والالتزام العربي المتضامن مع القضية الفلسطينية، وبفرض نوعٍ من التقسيم العربي من خلال فصل الموضوع الفلسطيني عن ارتباطه العربي، وهو ما حدث في عمليات التطبيع التي بدأت مع مصر بشكل منفرد مباشرة بعد حرب أكتوبر (1973)، وصولاً إلى التطبيع الإماراتي، والمفاوضات حول التطبيع الإسرائيلي السعودي، الذي تأخّر بسبب 7 أكتوبر (2023)، والحرب على غزّة، والتصريحات الأميركية والإسرائيلية أخيراً عن مخطّط التهجير. وخلال مسار التطبيع، جرى العمل لفصل المواطن العربي نفسه عن القضية الفلسطينية، ونزع السياق الإنساني والطبيعي لنظرة الشعوب العربية لمبدأ مقاومة الاحتلال، من خلال تطبيق سياسة تقوم على الاعتقاد بأن مواجهة الاحتلال تؤدّي إلى الخراب، وربط التطبيع بالازدهار والانفتاح.
منذ النكبة، ثمّ النكسة، وصولاً إلى اليوم، فشلت الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
إذاً، منذ النكبة، ثمّ النكسة، وصولاً إلى اليوم، فشلت الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لا بل تتزاحم الذاكرة العربية في محطّات كثيرة تنازل عنها العرب لمصلحة إسرائيل حدّ التواطؤ، ما جعل الأخيرة لا تتوانى حتى عن إحراج الدول العربية “الصديقة”، أو “الحليفة”، أو التي تريد التحالف معها، في الإعلام، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الاستخفاف بالبيانات والمواقف العربية الرسمية الرافضة لخطط التهجير ضدّ الفلسطينيين، إلى حدّ الطلب علناً، وبصيغة الواعظ والآمر، من بعض الدول العربية استقبال الفلسطينيين لتطبيق مخطّطها بدعم أميركي.
فبالأمس القريب، خرج الرئيس ترامب ليكشف للعالم كلّه حقيقة المشروع الأميركي الإسرائيلي منذ العام 1948، وهو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع مساحة إسرائيل التي شبّهها ترامب نفسه “بالقلم الصغير على طاولة كبيرة (أيّ العالم العربي)”. هكذا إذاً، وتحت عنوان إعادة الإعمار ومعالجة الأوضاع الإنسانية لأهل غزّة، أعطى الرئيس الأميركي صكّ الموافقة العلنية لمشروع “الحلم الإسرائيلي”، وإن جرى الإعلان لاحقاً عن تأخير تطبيقه بعد موجة الانتقادات العربية الرسمية التي تلت، لكن من دون إلغائه، بل استبدال مقاربته بمصطلحات منمّقة.
وعلى الرغم من أهمية الاستنفار العربي الرسمي لرفض تصريحات ترامب ونتنياهو، إلا أن هذا المشهد يفتح النقاش على جانب أساس، وهو فقدان ثقة الشعوب العربية بالحكومات العربية في الوقوف أمام المشاريع الإسرائيلية المدعومة أميركيا، رغم تفاعلها الإيجابي في الفضاءات الإلكترونية. من هنا، تكوّنت عبر السنين لدى الشعوب العربية حالةٌ من الرومانسية في مقاربة ثقافة الهزيمة والضعف، تحديداً في مسألة القدرة العربية على التعامل مع الأطماع الإسرائيلية، وعلى فرض سياسات فاعلة لمواجهة اعتداءاتها في فلسطين. فعبر التاريخ العربي، منذ احتلال فلسطين (1948) وحتى الحرب على غزّة أخيراً، لم تمنع التصريحات العربية الرسمية إسرائيل من القتل والاعتداء والتدمير والاستيطان في فلسطين، وبدل الضغط لمحاسبتها، سارعت بعض الدول العربية إلى التطبيع معها بذريعة حماية فلسطين وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية. غير أن إسرائيل استمرّت في انتهاكاتها للقوانين الدولية كلّها، وفي إمعانها في قتل الفلسطينيين، وفي استمرار الاستيطان وزيادة وتيرته في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى المحاولات المستمرّة لتهويد القدس، وتكرار مشاهد اقتحام المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه. وعند بدء عدوانها على غزّة منذ أكثر من عام، لم يرتقِ الموقف العربي إلى مستوى الإبادة الجماعية التي كانت تقترفها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين، بل اقتصر على بعض المواقف العربية الإنشائية، التي تتكرّر عند كلّ اعتداء إسرائيلي، ولم تمنع تحميل المقاومة الفلسطينية السبب في الإبادة بدل الاحتلال الإسرائيلي وحكومته، ورئيسه المطلوب دولياً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.
مع عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، استُعيد الخطاب الاستشراقي بكلّ جوانبه
أين يقف العرب اليوم في مواجهة هذا المشروع الذي يهدّد الأمن القومي العربي بشكل علنيّ، وليس بتصفية القضية الفلسطينية فقط؟ … ثمّة تجربة ديبلوماسية واحدة يجب الإضاءة عليها، والبناء عليها، واستثمارها، وتعميمها في وعي الشعوب العربية، لأنها تشكّل بالفعل خرقاً لهذا المسار العربي كلّه، الذي استعرضه القسم الأول من هذا المقال، وهذه التجربة هي الوساطة القطرية المصرية، التي نجحت في وقف الحرب على غزّة. فهذه التسوية هي إثبات للشعوب العربية (قبل أيّ جهة أخرى) القدرة العربية على المواجهة، وأخذ زمام المبادرة، وفرض مصلحتنا وروايتنا وحقّنا. فكما عُمِل على ترسيخ ثقافة الهزيمة والتنازل والضعف لدى الأجيال العربية، يشكّل نجاح هذه التسوية (أو الوساطة) نموذجاً مختلفاً يجب أن يعمّم لإعادة تشكيل الإدراك العام المعرفي والمجتمعي لدى الشعوب العربية، وتحديداً الجيل الجديد الذي يمتلك القدرة (أو لديه الحماسة) على المبادرة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن قطر طرحت، في دورها وسيطاً أساسيّاً في هذه الصفقة، نموذجاً جديداً في أدبيات العمل الدبلوماسي لم نعهده من قبل في العالم العربي، أقلّه منذ عقود، وهو ما يمكن تسميته بـ”الدبلوماسية الإنسانية” أو “دبلوماسية الإنسان”، التي عبّر عنها رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة له (17/1/2025)، استهلها بالتوجّه إلى أهل غزّة طالباً منهم المسامحة “إذا قصّرت دولة قطر في حقّهم كلّ الشهور التي مضت”، ليضيف: “أمانة، نحن في قطر، وسموّ الأمير، وكل الشعب القطري، فرحين جدّاً بهذا الاتفاق مثل فرح أهل غزّة الذي رأيناه، هذه السعادة التي رأيناها في شوارع غزّة. عندما تمّ الإعلان عن الاتفاق، قال لي سموّ الأمير: ضيّعت (نسيت) التعب كلّه في الخمسة عشر شهراً حتى وصلنا إلى هذه النتيجة”.
هذه التصريحات لا يحب أن تكون عابرةً، وهي ليست تفصيلاً ثانوياً في ظلّ الواقع العربي الحالي، بل تقع في صلب الحضور القطري في الملفّ الفلسطيني بشكل عام، وفي الحرب على غزّة بشكل خاص. يعكس هذا التصريح علاقةً غير مألوفة في الذاكرة العربية في الموضوع الفلسطيني تحديداً، إذ غالباً ما يُعامَل الفلسطيني في المحطّات والحروب كلّها باعتباره مجرّد ملفّ أو رقم على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية، قابل للمساومة. هذه العاطفة التي أظهرها المسؤول القطري عن ملفّ التفاوض والتسوية خبرها أهل غزّة قبل أيّ شعب آخر خلال الحرب، عبر زيارات المسؤولين القطريين لغزّة، أبرزهم وزيرة التربية والتعليم لولوة الخاطر، وعبر تحويل الوسائل الإعلامية في قطر جيوشاً تقود المقاومة الإعلامية لتوصل الصوت الفلسطيني إلى المنطقة والعالم.
الوساطة القطرية المصرية أثبتت القدرة العربية على المواجهة، وأخذ زمام المبادرة، وفرض مصلحتنا وروايتنا وحقّنا
وعلى المستوى السياسي العربي، تطرح هذه الوساطة نقاطاً عدّة يجب البناء عليها والعمل لتطويرها وتعميمها، لا سيّما في مواجهة مخطّط التهجير الأميركي الإسرائيلي. أولاً، إعادة الاعتبار للعمل الجماعي العربي من خلال التعاون بين قطر ومصر. ونجاح الشراكة بين مصر وقطر في إبرام الاتفاق يعيد فتح النقاش حول أهمية العمل الجماعي العربي وقوته. ولا يكمن إغفال رمزية (وأهمية) التجربة بين الدولتَين، التي يجب إضاءتها وتعميمها، ذلك أن العلاقات بينهما مرّت بأزمات ومطبّات مختلفة لسنوات، بسبب خلافات واختلافات سياسية أيديولوجية. من هنا، يؤكّد نجاح هذه الوساطة المشتركة أنه يمكن للدول العربية احترام خصوصية بعضها بعضاً، وتنظيم الخلافات و/أو الاختلافات في ما بينها، والعمل لأجل المصلحة العامّة العربية، وخاصّة في قضية فلسطين، التي تهدّد الأمن القومي العربي، وليس تصفية القضية الفلسطينية فقط.
ثانياً، للمرّة الأولى ربّما في تاريخ الوساطات والاتفاقيات العربية في ما يخصّ القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، تنجح وساطة عربية في حفظ حقّ أهل الأرض، من خلال فرض الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي في غزّة والعمل على استكماله، ومن خلال التشبيك لمواجهة العراقيل التي تضعها إسرائيل، وتهدّد التسوية، من خلال حملة ديبلوماسية تقودها مصر ومتابعة ديبلوماسية قطرية في حشد الدعم الدولي لتقديم الدعم الكامل لأهل غزّة، ولوضع إسرائيل وأميركا أمام مسؤوليتهما في تنفيذ الاتفاق بالكامل، والضغط لتأمين إدخال المعدّات اللازمة للمباشرة بإعادة الإعمار، وبالتالي إسقاط مشروع التهجير.
تعيش المنطقة اليوم حالة زخم ودفع استثنائيَين على المستوى الإعلامي في رفض المخطّط الأميركي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزّة، غير أن هذا الزخم يحتاج مقوّمات لحمايته ولتثبيته ولتحويله سياسةً فاعلةً، تتخطّى الحملات الإعلامية التي لا تؤدّي إلى تغيير فعلي، ولا تساعد أهل غزّة في الثبات في أرضهم وحمايتهم من التهجير. إن ثبات أهل غزّة في أرضهم يحتاج مقوّمات تتمثّل في إدخال المساعدات، ولا سيّما البيوت المؤقّتة، وفي البدء فوراً في إعادة الإعمار. لهذا، أمام الشعوب العربية، كما حكوماتها، نهجان ونموذجان: إمّا الاستفادة من نجاح التسوية القطرية المصرية والضغط بخطوات فاعلة لكبح جماح الأميركيين والإسرائيليين، أو سقوط المنطقة العربية مرّة جديدةً عبر تقديم التنازلات المقنّعة، وعبر الغرق في الخطابات الإنشائية (التي تغرقنا أكثر في العزلة عن حقّنا وحضورنا)، فنكرّس فشلنا الذي تحدّث عنه “الاستشراق”.
المصدر: العربي الجديد



