
قبل أربع وعشرين عاماً، وفي مساء العاشر من حزيران عام 2000، أعلِن عن وفاة حافظ الأسد بعد حكم اتسم بالإجراءات الاستثنائية (حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، حيث شهدت البلاد في عهده أحداثاً مهمة رسمت مسار البلاد بصيغته “المؤبدة” التي ينشدها، سواء على المستوى الإقليمي (حرب تشرين الأول 1973، والتدخل في لبنان 1976، والتدخل مع قوات التحالف ضد العراق 1991).
وعلى المستوى المحلي (التحركات الشعبية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، ومجزرة حماة 1982، والاعتقالات طويلة المدى خلال تلك الفترة وما بعدها)، وفي ذات اليوم، يعلن عبد الحليم خدام، نائب الرئيس في حينه، عن ترقية بشار الأسد من رتبة عقيد إلى فريق وتعيينه قائداً للجيش، ويصدق على القانون بتعديل سن الرئاسة ليصبح مفصلاً على مقاس الوريث.
وما هو معروف بتاريخ سوريا، أن أمام الرؤساء طريقين لنهاية مدة الرئاسة: الانقلاب أو الموت، وكون حافظ الأسد أنهى بطريقة ما سلسلة الانقلابات، كان الموت السبيل الوحيد لإنهاء رئاسته، لكن لم تكن تلك النهاية بأي شكل تحمل سمات نهاية لما أسسه من نمط حكم مرعب يقوم على أسس كتم الأصوات وخنقها بقوة المخابرات والسلاح، هذا النمط الذي مرر بسلاسة عملية التوريث المناقضة بكل صيغ الأنظمة القائمة في سوريا، وبكل بساطة، فقد حولها إلى مملكة أو مزرعة خاصة للعائلة وللدوائر المحيطة بها وفق علاقة الولاء مقابل العطاء، حيث لم ينتظر نائب الرئيس أي مهلة ليعلن عن المراسيم والقوانين التي “تشرعن” عملية التوريث تلك، المستمرة بكارثتها حتى اليوم.
ولأن الوريث لم ينل فترة إعداد جيدة على ممارسة السلطة، فقد بدا في فترته الأولى كما روّج له الغرب (مدني، متعلم في الغرب)، وكأنه يريد الإصلاح من خلال طروحاته بالتطوير والتحديث، لكن لم تمض إلا فترة قصيرة ليعود إلى ممارسات المؤسس -والده- فكان ما حصل مع تجربة ربيع دمشق والمنتديات التي أسست في عجالة ضمن تلك الفترة القصيرة، حيث الاعتقالات والسجن عبر محاكمات صورية أنهت كل آمال أو أوهام حول إمكانية الإصلاحات التي وعد بها في بداية عهده (تموز 2000)، بل زادت صلاحيات أجهزة المخابرات، وخاصة الجوية التي غدت المشرف إلى حد كبير على باقي الأجهزة، ناهيك عن قيادات فرق الجيش الخمسة عشر المحصورة ضمن ضباط الطائفة.
والجديد في عهد المستبد الوريث، هو سعيه إلى الهيمنة على القطاع الاقتصادي الذي كان موزعاً إلى حد ما بين برجوازيي دمشق وحلب بحماية سلطوية مقابل حصص مالية للراعي، فعبر قوانين التحرر الاقتصادي الجديدة وسياسة الانفتاح، أو ما عرف بالليبرالية في الاقتصاد، برزت شخصيات جديدة سواء كواجهة للسلطة أو من دوائرها المقربة مثل (مخلوف وجابر، وغيرهما) كمظلة لكبار التجار والبرجوازيين، وبات من المعروف من لا يعمل تحت المظلة، سيرمى به خارج السوق، لدرجة تحكم فيها مخلوف وشركاؤه بنصف فعاليات الاقتصاد في سوريا، إضافة إلى تحكم بعض الشخصيات المقربة بالقروض والمصارف، حتى صار يطلق عليهم السيد (5) في المئة، وهي النسبة الواجب دفعها للخال مقابل الحصول على قروض كبيرة.
بعد عقد من التوريث، كانت الهيمنة على كافة القطاعات مكتملة، فالهيمنة المطلقة لأجهزة المخابرات على مختلف مفاصل الحياة لدرجة مرعبة، وكذلك الجيش، والاقتصاد، ما كان يعد بالنسبة للنظام بيئة آمنة لاستمرار الطغيان وتأمين الخضوع، إلا أن ما حدث من شرارة الربيع العربي من قبل في تونس ومصر شجعت الناس في سوريا على محاولة كسر الرعب، فنزلت مئات الألوف إن لم يكن الملايين إلى الشوارع تصدح مطالبة بحياة حرة وكريمة، حياة افتقدتها طوال عقود من الحكم الأسدي، الذي لم يكن يسمح حتى بالحلم لمناهضته، فواجه الناس منذ البدايات بالاعتقالات والتعذيب الوحشي، ثم الرصاص والتجويع والصواريخ والطائرات وصولاً لما غدا يعرَف بأنه أكبر كارثة إنسانية في هذا الوقت، كارثة أنهت إمكانية العيش في سوريا إلى أجل غير معروف.
كشفت المواجهة بين أكثرية السوريين وطغمة النظام الأسدي عن عمق بنية الاستبداد وقوتها التي أسسها حافظ الأسد، هذه البنية التي اعتمدت على ترتيبة فريدة قائمة على أجهزة المخابرات وقيادات الجيش، ترتيبة تعتمد على الوحدة والتناقض، الوحدة من حيث أن استمرار مصالحها مرهون باستمرار نظام الطغيان الأسدي، والتناقض فيما بينها من حيث التنافس في تقديم الولاء للطاغية، هذا التنافس الذي يخلق بيئة من التنافر والعداء، ناهيك عن التجسس المتبادل، كل هذا أبعد بالكامل تشكيل نواة عسكرية أو أمنية يمكن أن تشكل بديلاً يمكن أن تطيح بالأسد.
ومن ناحية أخرى، أطلق الأسد يد هذه الأجهزة في مواجهة الناس، لدرجة إصدار قوانين تعفي العناصر الأمنية من المحاسبة عند ارتكاب جرائم قتل في أثناء عملهم.
لم يكن أمام السوريين سوى السعي لتحطيم هذه البنية، كمقدمة أساسية لبناء دولة محايدة وتأسيس مؤسسات وطنية تقوم على القانون وخاصة الجيش والأمن، ما يوفر شروطاً أساسية لبناء حياة حرة كريمة، لكن مجريات الأمور كانت عكس ما تمنوه، سواء لأسباب داخلية وخارجية تفاعلت فيما بينها فخلقت بيئة مناهضة لتطلعات وأحلام الناس، حيث أزاحت مطالبهم إلى الأخير، وجعلت من مصالح الدول المتنافسة المحرك الأول، وسخرت جزءاً كبيراً من إمكانات السوريين لأهداف ومصالح الآخرين، فكانت النتيجة ليس فقط إدامة الاستبداد متمثلاً بنظام العائلة الأسدي الذي رهن البلاد وأفرغها من سكانها مقابل الاستمرار في الكرسي، وتأسيس كيانات مرهونة بالخارج، وإنما تحويلها إلى بيئة طاردة لسكانها، الساعين لحياة أفضل بعد أن أوصلوهم إلى حالة لا أمل فيها.
كان الصوت الذي صدحت به حناجر الثوار في مرحلة ما “ما النا غيرك يا الله” النبوءة التي تحققت بعد مضي هذه السنين، حيث غدوا مشردين في دروب الهجرة أو المخيمات، أو متحملين قسوة ووحشية النظام ورعبه، وبعد تحول كثير ممن كانوا من “الأصدقاء” إلى مروجين للأسد ونظامه، ليس على المستوى العربي، وإنما على المستوى الدولي، وخاصة مع تزايد موجة اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في أوروبا، التي كان الجامع المشترك بينها العداء للاجئين والتطبيع مع الديكتاتور. موجة تبشر بترسيخ الطغاة في العالم، ومنها نظام الأسد، ضاربين بعرض الحائط قيم التحرر والديمقراطية، وتفتح الباب لقرن أسود.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا



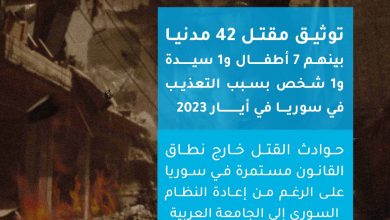




أمام الرؤساء الديكتاتوريين المستبدين طريقين لنهاية مدة رئاستهم الانقلاب أو الموت، ولأن حافظ الأسد أنهى بطريقته كل إمكانيات الإنقلاب عليه بطريقته الإجرامية كان الموت السبيل الوحيد لإنهاء رئاسته، رحل بعد أن ورثَّ الحكم للقاصر إبنه، ليكون الموت رحَلَّ الديكتاتور ولكنه ورثَّ الاستبداد، رؤية موضوعية دقيقة .