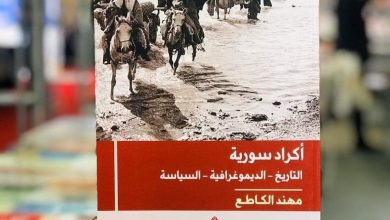نأى غيرُ قليلٍ من المثقفين السوريين بأنفسهم عن التعاطي مع قضايا الشأن العام طوال الحكم الأسدي للدولة السورية، ولعل السبب وراء ذلك هو انعدام هوامش الحرية وتسيّد السطوة الأمنية وتعزيز مبدأ العنف الممنهج باعتباره الضامن الأساس لهيبة السلطة.
وفيما انكفأ قسم من هؤلاء على الاهتمام بشأنه الوظيفي سواءٌ أكان أكاديمياً أو إدارياً أو سوى ذلك، إلّا أن شطراً آخر وجد أن منافذ التعاطي مع الشأن العام ما تزال متاحةً لمن أراد أن يَلِجَها، ولكن ليس بالضرورة أن تكون عبرَ الانخراط في أطر تنظيمية محدّدة، سواء أكانت تلك الأطر سياسية حزبية، أم مدنية، ممثّلةً بجمعيات أو منظمات مهنية أو نقابية، وكذلك ليس بالضرورة أن يكون التعاطي مع الشأن الحياتي العام مرهوناً بتبنّي إستراتيجيات أو أطروحات سياسية مباشرة من شأنها استفزاز السلطة الحاكمة أو استثارة الجهات الأمنية، بل يمكن العمل عبر قنوات الثقافة، لاعتقاد أصحاب هذا الاتجاه بأن الثقافة هي أكثر عمقاً وشمولاً من السياسة، وبالتالي يمكن لها أن تتيح فضاءاتٍ أكثر تحرّراً من سلطة الرقيب، كما يمكن لها أن تتيح – كذلك – هامشاً واسعاً للمناورة بغيةَ تحصين الجانب الأمني للمثقف وتحاشي الوقوع في دائرة الرصد والمراقبة من قبل الجهات الأمنية.
وبناءً على هذا التصوّر شهدت الحالة السورية على مدى عقود نشاطاً ثقافياً متنوعاً، وبخاصة في المجالين الأدبي والديني، مع التأكيد – بالطبع – على أن مجمل الحراك الثقافي كان تحتكره مؤسسات السلطة وقلّما وُجدتْ كيانات ثقافية مستقلة، باستثناء الإصدارات والمطبوعات التي يصدرها كتّاب سوريون وتُطبع وتوزّع خارج سوريا.
لا يعنينا – في سياق هذه المقالة الوجيزة – الفحوى الحقيقي أو القيمي لذاك النشاط الثقافي، بقدر ما تعنينا الأسباب الكامنة وراء هذا التوجّه، والتي يؤكّد أصحابه على أمرين اثنين: يحيل الأول إلى عدم وجود أي جدوى من نشاط سياسي سرّي يجري في الظلام وفي الأقبية والسراديب، ولن يودي بصاحبه بالنتيجة، سوى إلى السجن الطويل أو التخفّي أو الموت، فضلاً عن تداعيات هذه المآلات على حياة العائلة والأهل في ظل نمط من الحكم لا يجرّم العمل السياسي المخالف له فحسب، بل يرى فيه خيانة عظمى، وبالتالي فإن العمل السياسي وفقاً لتلك الشروط لن يكون أكثر من مغامرة تنطوي على كثير من الاندفاع العاطفي وقليل من العقلانية.
أما الأمر الثاني فيحيل إلى قناعة لدى أصحاب هذا التوجه فحواها أن العمل على مستويات الفكر والدين والثقافة تستهدف بناء الإنسان وتأهيله تدريجياً ليكون أكثر قدرةً على امتلاك الوعي وأكثر قبولاً وأرسخ قناعةً بمشروع التغيير، وبالتالي فإن المسعى السياسي للتغيير يُعدّ عملاً لاحقاً للتنوير أو هو تحصيل حاصل للمسار التوعوي أو النضج الفكري.
مع انطلاقة الثورة السورية في آذار 2011 وجد هؤلاء المثقفون أنفسهم أمام عاصفة مباغتة طالت عمقَ تصوّراتهم وقناعاتهم، إذ وجدوا مجمل تنظيراتهم وحصادهم الثقافي والفكري بات خلفَ ركب الثورة التي بيّنت شعارات حراكها السلمي وتطلعاتها أن الوعي المنبثق من الإحساس بضرورة التحرر من الطغيان والحاجة إلى استعادة الحرية والكرامة المسلوبة هو أكثر نضجاً وأكثر قدرةً على مقاربة مشروع التغيير من الوعي المنبثق من اليقينيات الإيديولوجية، كما أفصحت انتفاضة السوريين عن أن التخوم المزعومة بين ما هو ثقافي وما هو سياسي ليست سوى ضربٍ من الوهم أو الزيف، إذ ليست الثقافة بمعناها الحيوي الفاعل كمّاً معرفياً يحوزه المرء فحسب، بل هي موقف حياتي يتجسّد بسلوك المرء حيال القضايا والمسائل التي تمسّ مصير الناس وحيواتهم. وبإيجاز شديد يمكن التأكيد على ان جوهر المفارقة يكمن بكون الشواغل الثقافية في مرحلة ما قبل الثورة هي في الغالب ذات مُعطى إيديولوجي ظلّ بعيداً عن مقاربة المسائل التي تمسّ السياق الحياتي للمواطن، بينما أفصحت الثورة عن شواغل ثقافية أخرى كمسألة الحريات بمختلف أشكالها وتداول السلطة وحق المواطن في العيش الكريم والعدالة والديمقراطية وسوى ذلك، وبالتالي بات السوريون أمام نسقين ثقافيين، ينتمي الأول إلى ما قبل الثورة، ويتجلّى بمضامين وآليات تفكير تنتمي لمرجعيات إيديولوجية ذات بعد تاريخي شمولي في الغالب، وينتمي الثاني إلى مرحلة ما بعد الثورة ويتجسّد بمضامين ثقافية ذات بعد إنساني كوني يتجاوز تخوم الإيديولوجيات التقليدية.
ولكن على الرغم من الصدمة الفارقة بين النسقين من حيث الفحوى الثقافي، فإن كثيراً من مثقفي النسق الأول لم يتردد في الانحياز للثورة ومحاولة مواكبتها أو اللحاق بها، واستمر في متابعة الشأن العام المباشر كتابةً وتنظيراً، بل منهم من انخرط في صفوف الحراك الثوري، وكذلك منهم من بات يتطلع إلى شغل مناصب قيادية في كيانات المعارضة الرسمية، وربما تبدو هذه الانعطافة طبيعية باعتبارها تجسّد تماهياً مع الكشوفات المعرفية الجديدة للثورة من جهة، ونظراً لكونها جاءت موازاةً لصعود نوعي لسيرورة الثورة – ميدانياً وسياسياً – في ذلك الحين من جهة أخرى، وكان من المفترض أن تؤسّس تلك الانعطافة لمسار ثقافي جديد يستلهم وعياً أكثر قدرةً على مقاربة أولويات السوريين سواء الحياتية أو المصيرية، ولكن واقع الحال يشير إلى ارتدادات ثقافية معاكسة بدأت منذ سنوات، وجاءت موازيةً للتراجع الذي باتت تشهده القضية السورية منذ أواخر العام 2015، ثم ما لبثت هذه الارتدادات أن باتت تشكّل مساراً ثقافياً يعلن عزوفه عن التعاطي المباشر مع قضايا الشأن السوري ولا يقبل أصحابه أي دور حركي أو سياسي مباشر، بل ربما استاء الكثير من هؤلاء من مجرّد سماع أو رؤية عبارات أو شعارات كانت لها حظوة كبيرة لدى هؤلاء من قبلُ أكثر من سواهم، ويعزو أصحاب هذا المنحى أسباب عزوفهم إلى حاجة المجتمع السوري في الوقت الراهن إلى ( التنوير) وليس إلى ( التثوير)، إذ كشف الانفجار الهائل الذي حل بسوريا – وفقاً لهذا الاتجاه – عن تصدّعات كبيرة تطول بنية المجتمع وكذلك أظهر الواقع بؤس الوعي الجمعي الذي لم ينضج بعدُ ليصل إلى مرحلة التغيير، فجميع النزعات الطائفية والعرقية وجميع أشكال الاحتراب الديني وحالات الانشطار الاجتماعي إنما مبعثها التخلف الذي لم يتجاوزه السوريون، فضلاً عن افتقار الحالة السورية للعديد من المفاهيم والقيم التي ينبغي البناء عليها إزاء أي مشروع للتغيير، كانعدام الهوّية الوطنية وثقافة المواطنة وقيم التماسك الاجتماعي ومفاهيم العيش المشترك والتسامح وسوى ذلك.
وبناء على هذا التصوّر يغدو العمل الموجّه نحو المسار التنويري أجدى بكثير من التعاطي المباشر مع تفاصيل الواقع الحياتي وفقاً لهذا الاتجاه، إذ يمكن العمل – على سبيل المثال – في مجال التأسيس لفهم عصري وجديد لقضايا الدين وكذلك العمل لإنجاز أفكار وتصورات عصرية لبناء الدولة السورية في المستقبل، فذلك كله أكثر جدوى وفائدة من العمل على شعار (إسقاط النظام) الذي بات شعاراً شعبوياً مبتذلاً نظراً لاستخدامه المفرط من جانب جماعات وأفراد لا تمتلك الحدّ الأدنى من إدراك مضامينه، أضف إلى ذلك أن مسألة إسقاط النظام أو إزالته لم تعد رهن الإرادات السورية، بل أصبحت رهناً بتوافقات لمصالح إقليمية ودولية لا قدرة للسوريين على التأثير فيها.
ما هو لافت بالفعل أن انكفاء عدد غير قليل من مثقفي ما بعد الثورة عن التعاطي مع الشأن السياسي المباشر واتجاههم نحو ( التنوير)، إنما يشبه إلى حدّ التطابق، من حيث المبررات والأسباب، مع انكفاء مثقفي ما قبل الثورة، وإيثارهم للتعاطي مع مسائل الثقافة بعيداً عن تجلياتها السياسية المباشرة، ولئن كان توجّه مثقفي ما قبل الثورة مشفوعاً بالخوف من تنكيل السلطة وتحاشي بطشها، فما هي الشوافع الحقيقية لسلوك مثقفي (التنوير) في المرحلة الراهنة؟ ثم لا بدّ من السؤال: إلى أي حدّ يمكن أن يكون شعار (إسقاط النظام) معيقاً لمشروع التنوير؟
المصدر: موقع تلفزيون سوريا