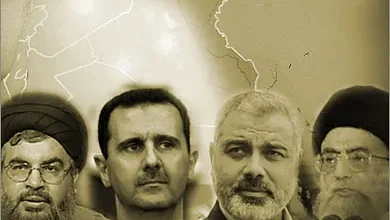ارتبطت مقاومة الغزو والاحتلال الأجنبى تاريخيا بالصور التى تتخلق وتنطبع لدى أطرافها المتنازعين، والمتصارعين، فى ذاكرتهم الجماعية والشخصية لمن شاركوا، وشاهدوا أساليبها، وأيضا الآلام والمجازر التى يرتكبها الغزاة لدى الجماعات المحتلة. انتقلت الصورة من المرويات الشفاهية، والصور الحاملة لها، إلى الرسوم، ثم إلى الكتابة، ومعها ثنائية الغزو/ الاحتلال، والمقاومة والشجاعة -والبطولة- وإلى الأدب والشعر، والأغانى والموسيقى الشعبية. كل طرف من أطراف الحروب الدامية لديه سردياته حول إنجازاته، وانتصاراته، أو مقاومته للغزاة، وشجاعته، وبطولاته.
مع التطور فى أنماط الدول، وتحولها من الإمبراطوريات التاريخية المتعاقبة إلى نموذج الدولة/ الأمة، مع تطور الرأسمالية الأوروبية، والغربية، وحركات القوميات، ظهرت معها الكولونياليات الغربية، واستعمارها لغالب البلدان الواقعة فى أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وذلك لاستغلال مواردها الطبيعية، والبشرية، وهو ما أدى إلى استنفار مقاومة الشعوب للمستعمرين سعيا وراء الحرية، والاستقلال، من ثم تبلورت صيغ، وأشكال مختلفة لمفهوم المقاومة، التى باتت تشكل ثقافة بعض هذه الشعوب وتتشكل، وفق تداخلاتها مع خصوصياتها الثقافية، وأساطيرها، ومروياتها، وتاريخها الشفاهى، والمكتوب ورموزها، ومعتقداتها الدينية، على نحو جعل من سرديات مقاومة كل شعب -أو بعض مكوناته- حاملة لخصوصياتهم الثقافية وجزءا من التاريخ الرسمي والتاريخ من أسفل بعد تطور مدارس ومناهج الكتابات التاريخية وخاصة ما بعد الكولونيالية.
تطورت مقاومات الشعوب المحتلة والمستعمرة حتى بروز حركات التحرر الوطنى، وارتباط المقاومة بمفاهيم الاستقلال، والحرية، والكرامة، والدولة مابعد الكولونيالية، فى السياقات الفكرية والسياسية شبه الحداثية -وبعضها ينطوى على ابتسارات، وخصوصيات- ومن ثم لعبت السرديات الوطنية حول المقاومة دوراً مركزياً فى بناء الدول حديثة الاستقلال، والاندماج الداخلى -بين المكونات المختلفة فى مجتمعاتها- وأحد أبرز مكونات الإيديولوجيا السياسية، بل وتشكيلات النخبة السياسية الحاكمة.
ساهم عصر الصورة الفوتوغرافية، والسينما، ثم التلفازات، والسرديات الأدبية والروائية والقصصية والشعر، فى بناء مفهوم “البطولة” لقادة المقاومة التاريخيين فى هذه البلدان، ثم تحولت هذه الصور، مع مفهوم “الشهرة” والنجوم السياسيين اللامعين من الساسة الأمريكيين والغربيين، ثم توارى هذا المفهوم (مفهوم البطولة) مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعى الرقمية، نحو المشهدية المرئية، وخاصة فى عصر الثورة الرقمية والذكاء الإصطناعي، وهو ما برز مؤخراً مع مشهديات المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاستيطانى الإسرائيلي عبر “الفيديوهات الطلقة” والمنشورات والتغريدات التي تعلق أو تشير إليها، وسعيها نحو الحرية والاستقلال، وتحولات الصورة فى عالم وسائل التواصل الاجتماعى.
1- تعد مسألة الحرية فى مواجهة هيمنة القوة، الأقدم فى تاريخ الوجود الإنسانى، وذلك فى كل الجماعات الإنسانية أيا كانت معتقداتها وأعراقها، ومناطقها، وتاريخها، بل ورسخت في بعض الذاكرات الإنسانية الجماعية، والشخصية، وذلك لأن بعض الحياة الإنسانية قامت علي ثنائية القوة والضعف، الهيمنة والخنوع، بين أبناء النوع البشرى، ومن ثم الاستغلال، وأشكال مقاومته، وبين ثنائية الامتثال، والخنوع، والرفض والتمرد، تواترت وتعاقبت معها وفي ظلها سرديات القوة، والاستبداد، والمقاومة والرفض والحرية والاستبداد، والانتفاضات ضد الطغيان، مع كل تطور فى في بعض من التاريخ الإنسانى، وتشكلت معها بعض السرديات التاريخية حول العدوان، والمقاومة والتسلط والشجاعة، والهزيمة والبطولة، والحرية والكرامة ضد الاستعباد والاستغلال.
2- اتخذت هذه المفردات والصفات معانيها ودلالاتها فى كل جماعة أيا كانت أسماؤها وتشكيلها وأعراقها وأديانها، ومذاهبها، وذلك وفق ميثولوجيا الشجاعة، والجبن، والنصر، والهزيمة فى أسطوريات وحكايات هذه الانتصارات والهزائم. من ثم، شكلت ثقافة كل جماعة مروياتها، وأساطيرها الشفاهية حول معانى الشجاعة، والخوف، والبطولة والجبن، والخضوع والعنف، والعجز، والفشل.
3- بعض السرديات حول القوة والهيمنة والتسلط الفردى، والجماعى، والحرية والشجاعة والبطولة انتقلت من الواقع الفعلي إلى الخيال الشخصي، والجماعى، وتناصت مع صور الخيال الجامح لإعطائها معانى ودلالات “ميتاواقعية”، ومعها كل ما هو خارق، فى الإنجاز، حول المنتصر، أو المسيطر والمهيمن على الجماعة، أو الذى قام بغزو جماعة أخرى -أيا كانت قبائلية، أو المقاوم الشجاع، أو مجموعة عرقية أو دينية أو مذهبية.. إلخ، وذلك لكى يسود مفهوم القوة الغلابة، القادرة المسيطرة، ويجاورها السرديات المضادة حول الآخر المنهزم، والخاضع للقوة، والتسلط، والاستغلال.
4- من هنا كان التمييز بين الأعلى والأدنى، بين المنتصر والمنهزم، فى السرود الشفاهية للبطولة والهزيمة، والشجاعة، والجبن، والقوة، والضعف. هذا التمييز فى المخيال الجماعي والشخصي كان مترعا بالأسطورى، وما فوق الواقعى، ويتناص مع المعتقد الدينى أيا كان، ومع كل ما هو خارق واستثنائى، وغير عادى، ويحمل معها سمات ما فوق إنسانية لجعل مفهوم القوة والقوى استثنائي، ويجاوز ما هو إنسانى ليساوق ويتداخل مع أنسجة الأسطورى أو بعضها منها.
5- من هنا كانت البطولة أداة رمزية لتماسك الجماعة وشحذ إرادتها الجماعية فى مواجهة الغزو والتمدد، واحتلال مناطق وثروات الجماعات الأخرى المجاورة، ثم البعيدة. على النقيض، كانت المقاومة وشراسة الدفاع عن الجماعة فى القتال الوجه الآخر المضاد للغزو، ورفض الخضوع، والخنوع للغازي. لقد شكلت سرديات/ تجليات المقاومة جزءاً من الثقافة الشفاهية أو المكتوبة أو المرسومة فى بعض الكهوف وتجاويف الجبال الصلدة، وحملت فى أعطافها سردية أسطورية المقاومة والتصدي للغزو والغزاة والدفاع عن الجماعة.
6- السرديات المتصارعة حول القوة والضعف والشجاعة والجبن والغزو والمقاومة على صعيد الجماعة، تداخلت بين الواقعى والمتخيل، بين العادى والاستثنائى، وبين الفعلى الأساطير، لأن السرديات الشفاهية حول هذه الثنائيات تتمدد ومعها الإضافات والتداخلات بين الروايات المختلفة. ومن داخل هذه السرديات صعد مفهوم البطولة، والنصر والهزيمة، والبطل، والمنتصر، والمهزوم، ولكل رواية هناك نقائض لها، وحكايات موازية. ومع التطور التاريخي تناسلت الروايات حول الرواية.
7- لم يقتصر الأمر على الصراعات بين الجماعات وإنما امتدت إلى داخل الجماعة، بين سطوة الأقوى وتسلطه على الأضعف والضعفاء، والصراع على القيادة والنفوذ، والسيطرة والاستغلال واستبعاد الأضعف. فى ذات المستوى تناسلت الحكايات المؤطرة فى الذاكرة الشفاهية -ثم الكتابية- حول الأقوى، وحكايات بنائه لقوته وهيمنته على الآخرين الضعفاء، وانبثق معنى البطل والبطولة، والخوف والخائف والضعف والضعيف.
8- من خلال التطور التاريخي، وتشكلات الجماعات الإنسانية حول المعتقدات والديانات، ثم المذاهب والأعراق واللغات، تطورت مفاهيم البطولة والهزيمة والشجاعة والجبن فى الذاكرات الجماعية، والوعى الجمعي والشخصي، والشفاهية التاريخية، وذلك على مستويين:
المستوي الأول، هو المرويات ومحمولها الأسطورى التاريخي، التي شكلت أحد أبرز مكونات ثقافة الجماعات أيا كانت، ونظرتها لذاتها وللآخرين ضمن مكونات أخرى كالمعتقد والطقوس وعلاقتها بالطبيعة، ونظام الأكل والشراب والزراعة والرعى والصيد..إلخ. وظلت ثنائية البطولة والمقاومة جزءاً من حياة الجماعات تاريخيا، على عديد المستويات والوجوه؛ الوجه الأول: سواء على مستوى علاقة الجماعات ببعضها بعضاً، فى الصراعات والمنازعات، والحروب حول الموارد الطبيعية، أو الاعتداء والاستيلاء على أراضى الغير (الجماعات الأخرى، أو بعضا منها) أو دفعه للهجرة منها. الوجه الثانى يتمثل فى السيطرة على الجماعات الأخرى وأراضيها ومواردها الطبيعية..إلخ، وتحويلهم إلى جماعة مسيطر عليها، وموضوعا لاستغلال الجماعة الأقوى.
من خلال عملية السيطرة على الأراضى والجماعات الأخرى ومواردها ينطلق الوجه الآخر المضاد لسردية الغزو والسيطرة، وهى سردية المقاومة للغزاة، سواء فى وجهها البطولى، أو الموت فى سبيل حرية الجماعة أو بعض أعضائها.
المستوى الثانى، ينصرف إلى داخل الجماعة، ويتمثل فى ثنائية السيطرة والخضوع، والقوة والضعف، والشجاعة والجبن، حيث تبدو عبرها سردية القوة/ الاستبعاد، وسردية مضادة هى المقاومة، الشخصية أو الجماعية، حول بناء القوة داخل الجماعة، ومحاولات إزاحة الأقوى/ البطل الحاكم، لصالح صعود حاكم/ مسيطر مختلف، أو التحرر من العبودية والاستغلال. تتشكل كل سردية، ومعها تاريخها الفعلي أو المتخيل، والذى تنمو وتتكاثر حكايته وتتأسطر، ويتداخل فيها الواقعي والفعلي والمتخيل وما وراء واقعات المقاومة/ البطولة.
ظلت هذه الثنائيات، وتداخلاتها فى تطور الجماعات، وبناء القوة داخلها، حتى تشكُل الدول والإمبراطوريات، فى الحضارات القديمة، وغزواتها ومروياتها مع الدول الأخرى.
9- مع تطور بناء الدول، وشكلها وأنظمتها الداخلية، تنامت ثنائية القوة/ الضعف، والسيطرة/ الخضوع، والحاكم ودائرته والمحكومين، والسلطة/ المعارضة، ومعها مفاهيم البطولة والشجاعة، والهزيمة والنصر، والخنوع والاستسلام والعدالة والظلم داخل المجتمع والدولة، ومعهم سردياتهم الشفاهية، والكتابية معاً. وحرص الحكام على صياغة تاريخهم، ومعه بطولاتهم، وإنجازاتهم الفعلية أو المفترضة، من منظور مصالحهم، وتصوراتهم لذواتهم وفى ذات الوقت تهميش توثيق الانقلابات عليهم، أو المعارضة لحكمهم المستبد، ورموز البطولة المعارضة لهم. فى ذات الوقت تطورت الكتابة التاريخية حول سياسات الحكام، وأيضا المحكومين، فى أثناء وبعد خروج الحاكم من السلطة موتا أو عنوة واقتدارا من بعض معارضيه.
10- توثيق وتأريخ تاريخ الغزوات والحروب عند الدول الأخرى، واحتلالها كرمزية على شجاعة وإنجازات الدولة والحاكم، وأيضا من منظور الدول المحتلة، والمغزوة على المقاومة والبطولة، إزاء المحتل الغاصب لأراضيهم، وتشكلات ثقافة المقاومة، والموت فى سبيل تحرير بلادهم من الاحتلال الأجنبى.
11- مفهوم البطولة هو مفهوم نسبى ومتغير، ويتحول وفق منظورات مختلفة تاريخياً، ودولتيا وشعبياً، سواء من داخل الدولة ونظام الحكم فيها والحكام، وأيضا من منظور الوعى الشعبى الجمعى، والمعارضين لنمط السلطة الحاكمة الاستبدادى، أو القمعي. الوعى الشعبى للمحكومين، وإدراكهم لمعنى البطولة، يختلف عن إدراك الحكام ودوائر القوة حولهم. بينما لدى الشعب، أو بعض جماعاته التكوينية -أيا كانت أديانها وأعراقها ومناطقها وتركيباتها الداخلية- غالبا ما تنطوى على بعض من أحداث الواقع الفعلي، والمتخيلات، والمرويات، والأسطوريات، لتمجيد معنى المقاومة والبطولة، كجزء من ذاكرتها الجماعية، ونمط حياتها، سعيا وراء التماسك والاندماج الداخلى لديها، ويتداخل ذلك مع نمط التنشئة الاجتماعية لديها.
12- مع نشأة النظام الرأسمالى الغربى -وتوحيد مكونات المجتمعات الأوروبية، ثم الولايات المتحدة وكندا– تطورت حركة القوميات، وتكوين الدولة/ الأمة مع توسع الرأسمالية الدولية، وتمدد الغزو والاحتلال الغربى للدول والمجتمعات الأفريقية والآسيوية، والأمريكية اللاتينية، وعمليات النهب الاستعمارى لثرواتها، ونقلها إلى المركز الأوروبي البريطاني والفرنسىي والإيطالي، والأسباني، والبرتغال، والهولندى والألماني. فى ظل هيمنة الاستعمار الغربي للبلدان المستعمرة، تبلورت تدريجياً عمليات مقاومة المستعمر الغربي- أيا كان اسمه أو شكل حكمه للبلدان المحتلة، واستغلاله لثرواتها الطبيعية والمدنية، وعلاقاته بالسكان المستعمرين؛ تبلورت هذه المقاومة، واتخذت أشكالا متعددة من المقاومة المسلحة، ومن خلال الإرادة الثقافية الجماعية –إن جاز التعبير وساغ- وذلك من خلال إحياء الطقوس والمعتقدات والأعراف الموروثة أيا كانت مصادرها، وأساطير الجماعات التكوينية للشعب -قبائل وعادات وعشائر وأديان ومذاهب ومناطق..إلخ- وإبراز الخصوصيات السوسيو- ثقافية- والتعليمية، والتغاير عن ثقافة المستعمر، وتقاليده وسلوكه، أو عدم التفاعل معه. ومن خلال أنسجة المقاومة الثقافية والدينية والعسكرية تشكلت معانى البطولة، فى مواجهة المستعمر الغربى، والدعوات للحرية، والتحرر، والاستقلال الوطنى. هنا تمركزت معانى البطولة فى مواجهة المستعمر الغربى، والدعوات للحرية، والتحرر، والاستقلال الوطنى. من هنا تمركزت أيضا معاني البطولة فى إطار الخصوصيات الثقافية، وفى المقاومة العسكرية، وأبطالها من الشهداء، ومن قادة العمل الوطني التحرري، ومن بعض زعماء القبائل والعائلات، وبعض الأفراد العاديين من قاوموا، واستشهدوا أمام قوات المحتل الغربى.
13- ارتبطت معانى ومفاهيم البطولة بالشهادة والشجاعة فى مواجهة المحتل الغربي وجنوده وآلياته العسكرية، وأيضا من خلال قيادة العمل السياسي والعسكري من أجل الاستقلال الوطني، لبعض من أبناء هذه الشعوب ممن تلقوا تعليماً حديثاً، وفق المدارس، والجامعات الغربية، كما حدث فى البلدان المحتلة فى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، أو ممن تحولوا دينيا إلى الديانة المسيحية، الكاثوليكية والبروتستانتية، من خلال الجماعات التبشرية، ووجدوا قدرا من التعليم، أو تدرجوا فى مستوياته المختلفة. لم يؤثر نموذجا الحكم الفرنسى المباشر، والبريطانى غير المباشر، فى تخفيض الدعوات للاستقلال الوطنى، وإنما ساعدا على تبلور ونضوج الوعي بالارتباط بين مفاهيم الاستقلال والحرية والدستور -من ذلك المثال المصرى تحت الحكم البريطانى- ولا فى تصفية المقاومة المسلحة ضد المحتل الفرنسي كما فى حالة الجزائر، والمحتل الإيطالي كما فى الحالة الليبية، وجنوب أفريقيا فى مواجهة حكم الأقلية البيضاء والفصل العنصري لنظام الابارتهايد. من هنا، كان تمجيد الشعوب -ومكوناتها الداخلية- للحرية والمقاومة والبطولة والاستقلال الوطنى، وهو ما برز فى ثقافة المقاومة الفيتنامية ضد الفرنسيين والأمريكيين، والجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي على سبيل المثال لا الحصر.
14- مع دخول الصور الفوتوغرافية إلى أحد أبرز مكونات الثقافة البصرية والتوثيقية فى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية والسينما الهليودية، حدث تحول فى مفهوم البطولة والبطل إلى مفهوم “الشهرة” الذى يتحكم فيه صناع السينما وتمويلها، واختياراتهم، من الممثلين والممثلات، وساهم فى تبلور المفهوم الصحف والمجلات المصورة، وسطوة الصور الفوتوغرافية. ارتبط بهذا التحول النوعى ظهور شركات العلاقات العامة، ودورها فى الترويج لبعض ممثلى السينما، والموديلات النسائية، وتحويلهم إلى نجوم لامعة فى الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية.
لم يقتصر التحول من مفهوم البطولة إلى مفهوم الشهرة والنجومية على الفنون، وإنما امتد إلى رجال الأعمال، وتحولهم إلى شخصيات عامة شهيرة. هذا التحول النوعي ارتبط عضويا بالتطور فى الرأسمالية الغربية، وتسليع الإنسان، وترويجه وذيوعه فى أوساط الرأى العام داخل هذه المجتمعات، وبدايات ظواهر التشيوء الإنسانى، وثقافة الاستهلاك المفرط للسلع والخدمات والنجوم والرموز.
15- امتدت عملية التحول من البطولة للشهرة إلى الحياة السياسية، بل واعتمادها على صورة السياسى المؤسسة على الصور الفوتوغرافية فى الصحف والمجلات السياسية، والمصورة، وترويجها من خلال شركات العلاقات العامة ثم التلفاز والسينما الوثائقية، بل واستخدام بعضهم من صناع صورة السياسيين أدوات التجميل -الماكياج- لكى تبدو صورة السياسى أمام الجماهير فى شكل بهى، ويتسم بالرصانة والوقار والأناقة، وباتت صور السياسيين مصنعة كجزء من صناعة الإعلام والصورة -من الأبيض والٍأسود، وما بينهما من ظلال إلى الصور الملونة- ومن ثم باتت صورة السياسى مسلعة، وتقوم كسلعة ضمن سوق السلع والخدمات، وجزء من أسواق الاستهلاك.
16- الانتقال من عالم الصورة والعلاقات العامة إلى التلفزات كرس مفهوم الشهرة والذيوع، وتم توزيعها واستهلاكها على نطاقات اجتماعية أوسع جماهيريا، والأهم أن ذلك ارتبط بمحررين يقومون بإعداد الخطب السياسىية، وتخطيط عملية ظهور السياسى أمام الجماهير كنجم لامع! على نحو ما ابرزه الكاتب دانيال بورستين في كتابه “الصورة، الأحداث الزائفة” الذي صدر في طبعته الأولي 1961، وطبعته الثانية ومقدمتها الجديدة بعد مرور خمسة وعشرين عاما 1987.
17- امتدت عملية الانتقال من السوق السياسى والسوق الإعلامى الأمريكي، إلى الأسواق السياسية الأوروبية، مع بعض الاستثناءات لشخصيات سياسية تاريخية مثل ونستون تشرشل فى بريطانيا، والجنرال ديجول فى فرنسا على سبيل المثال، وذلك فى أثناء وأعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم فرنسوا متيران فى أثناء الحرب الباردة بعد وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى فى فرنسا (1981-1995). اعتمد هؤلاء على دورهم ومواقفهم القيادية وانتصارهم فى أثناء الحرب العالمية الثانية، وما بعدها، وإلى تكوينهم السياسى والثقافى، وميتران كمثقف وسياسى بارز من الجمهورية الرابعة إلى الجمهورية الخامسة الفرنسية.
ازدادت كثافة التسليع للسياسيين مع جيل ما بعد الحرب الباردة، من خلال شركات العلاقات العامة والقنوات التلفازية والفضائية، والصحف والمجلات، والإعلام المسموع.
18- أدت الثورة الرقمية، والشبكات العنكبوتية، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعى، إلى تغيرات نوعية فى الإعلام، وتأثيره، على أنظمة الإعلام التقليدي، الذى لا يزال مؤثرا نسبيا، وخاصة التلفزات، والصحف والفضائيات على الرغم من تطوره، وتكيفه مع بعض من الثورة الرقمية، وتزامن زمن الصورة مع زمن الحدث، منذ محاولة انقلاب ياناييف الفاشلة فى الاتحاد السوفيتى السابق.
لم يعد مفهوم الشهرة، والنجوم اللامعة بذات القوة والتأثير الذى استمر طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، ويتراجع نسبيا على الرغم من بعض التكيف مع الرقمنة لصالح ثورة وسائل التواصل الاجتماعى، و”الذكاء الإصطناعى”، الذى أدى إلى مرحلة الإناسة الروبوتية، تمهيداً للتحول إلى مرحلة ما بعد الإنسانية، سواء تم ضبط وحوكمة الذكاء الاصطناعى، فى ضوء متطلبات الحكومات والإدارات السياسية فى الغرب، أو حتى فى دول آسيا الناهضة حول الصين، أو فشلت سياسة الضبط والسيرة، وذلك لأن عالم الذكاء الإصطناعي لم يُعد تحت سيطرة الدول، وإنما هناك دور بارز ومتعاظم ومؤثر للشركات الرقمية الكونية ومصالحها الضخمة، وقد يخرج الذكاء الإصطناعي عن السيطرة والحوكمة.
19- فى عصر ثورة وسائل الاتصال الاجتماعى الرقمية، وعلى الرغم من أنظمة الرقابة الرقمية الأمنية والاستخباراتية للدول، لكن هناك انفجار للمعلومات الضخمة Big Data، تحت سيطرة الشركات الرقمية الكبرى، من حيث توظيفها، وبيعها لتفضيلات ورغبات وتوجهات الجماهير الرقمية الغفيرة للشركات الرأسمالية الكبرى، لتعيد الأخيرة صياغة سياساتها فى إنتاج السلع والخدمات وتحفيزها للجماهير الرقمية والفعلية الغفيرة على الاستهلاك المفرط، وإعادة تشكيل دوافعها ورغباتها وتفضيلاتها من الاستهلاك الفعلي والاستهلاك الرقمى.
فى ظل هذا التحول والقطيعة المحلقة فوق الشرط الإنسانى ذاته، يتراجع، وينزوي مفهوم الشهرة والذيوع، وبات الاستهلاك الرقمى للنجوم والسياسيين خاضعاً للتغير فائق السرعة لأنماط استهلاك النجومية فى الفنون، والأدب، والمسرح، والسينما، والتلفاز، والصور المرئية. وباتت سنوات استهلاك النجم/ الشهير وجيزة وقد لا تتعدى سنوات، أو سنة، أو أقل، لأن التغير الرقمى وتحولاته فائقة السرعة فرض أنماطا جديدة لاستهلاك للمنشورات والتغريدات والصور سبق أن أطلقنا عليها “القراءة الومضة” و”النظرات الومضة للصور” و”الفيديوهات الطلقة”، و”المشاهدات فائقة السرعة”، وهو ما ساهم فى سرعة استهلاك مفهوم النجم/ الشهير/ اللامع.
20- فى ظل انفجار واتساع الفضاءات والمنصات الرقمية، دخلت الجموع الرقمية/ الفعلية الغفيرة إلى المجموعات الرقمية المتعددة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، فى جماعات وصداقات رقمية عابرة للحدود والمناطق والجغرافيات السياسية والدينية والمذهبية والعرقية والقومية، بل والجغرافيا الثقافية، وجغرافيا الخصوصيات على تعددها الداخلى والإقليمى والكونى.
أدت الثورة الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعى إلى الحضور الكثيف للجموع الفعلية الغفيرة إلى هذا العالم، وأدى ذلك إلى انكشاف الخصوصية، وإلى تعبير هذه الجموع عن تفضيلاتها وآراءها فى تفاصيل الحياة في مجتمعاتها، وأعمالها، واهتماماتها، ومواقفها، وآراءها فى قضايا السياسة الوطنية، والإقليمية، والدولية، ومن ثم أصبح مليارات من البشر جزءاً من العالم الرقمى ووسائطه الاجتماعية ومنصاته، ويعبرون عن مواقفهم، وآراءهم، وادراكاتهم، ومعلوماتهم، وقدراتهم العلمية والمعرفية والدينية والمذهبية، والمعلوماتية، فيما يطرحون من تفضيلاتهم، أو آراءهم المتعارضة أو الرافضة أو المحايدة حول ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعى.
21- ساعدت الثورة الرقمية فى تسارع عمليات تشكل الفرد الفعلي، والفرد الرقمي، التى كانت -ولا تزال- تواجه بعض من العسر السياسى، والاقتصادى والاجتماعى والتعليمى فى بقايا النظم الشمولية والتسلطية فى العالم.
ثمة ولع جماعي -ومليارى من البشر فى مجتمعات عالمنا المتعدد والمتنوع والمتنافر فى بعضه- بالصور الذاتية، والفيديوهات الطلقة، ومعها المتابعات، والتصوير من خلال الهاتف المحمول/ النقال، للوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية والإجرامية، والكوارث الطبيعية والإنسانية، والحروب الأهلية، وبين الدول، والنزاعات الدينية والمذهبية والعرقية..إلخ.
مركزية الذوات الرقمية باتت ظاهرة كونية واجتماعية داخل المجتمعات الرقمية المحلية والمناطقية، والوطنية، والإقليمية، بالصور والفيديوهات والمنشورات والتغريدات، وعلى منصات التواصل الاجتماعى، ومن ثم التدافع من بعضهم ليغدو معروفا، ولو يوم أو ساعة، أو دقائق، من خلال التعليقات والتفضيلات، وباتت تشكل واحدة من أبرز اهتمامات الأفراد الرقميين فى دوائرههم الرقمية.
22- أدى بعض التغير السابق إلى توارى مفهوم الشهرة التى أنهت مفهوم البطولة، ولم تعد صور الصحف والمجلات والسينما والدراما التلفازية، هى الحاملة للشهرة، ومعها شركات العلاقات العامة. بات استهلاكها سريعا من جانب الأجيال الرقمية الشابة، وفى سن الصبا والطفولة، حيث لا يتم مشاهدة سوى بعض المقاطع السريعة، وفق تفضيلات المشاهدين. ولم يعد طقس المشاهدة السينمائية والتلفازية يستأثر باهتمامات وعيون وعقول بعض “جيل زد” G Z الرقمي.
الاختزال والتكثيف هو ابن عصر السرعة الفائقة، والوجبات السريعة، والموسيقى القصيرة الوجيزة والمُرقِصة، ومن ثم تحولت ثقافته إلى ثقافة السرعة الفائقة، والإيجاز، والنظرات والقراءات الومضة، وباتت أمزجته وذائقته متغيرة ومتحولة، على نحو جعلنا ندخل فى ظل عالم مركزية الفرد الرقمي وتفضيلاته. من هنا يحاول بعض ممن كانوا من خلال السينما والدراما التلفازية والبرامج الإخبارية جزءاً من عالم الشهرة، التى تراجعت على نحو كبير، توظيف الأدوات والمنصات واللغة الرقمية لكي يكونوا جزءاً من هذا العالم الرقمى، إلا أن ذلك لم يؤد إلى مركزية هؤلاء، ولا إلى صناعة الشهير/ الشهرة، كما كان فى ما قبل، وما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة، وسقوط الإمبراطورية الماركسية السوفيتية.
23- أدت الثورة الرقمية ومنصاتها إلى تغيرات فى الحياة السياسية فى الدول الديمقراطية الغربية، وفى سياسات إدارتها السياسية، وفى النظم الحزبية المتعددة، والمتنافسة وأيضا، وتغيير صورة السياسي فى الوعى الجمعي لمؤيديه داخل المجتمع والحزب. ومع الثورة الرقمية تواجه صيغ الديمقراطية الليبرالية التمثيلية مشكلات عديدة، خاصة مع صعود بعض من الشعبوية مع اليمين واليمين المتشدد، وظواهر معاداة الأجانب والمواطنين من ذوى الأصول العرقية والدينية المغايرة لمواطنى بعض البلدان الغربية -كالعرب والسود ذوي الأصول الأفريقية- ومعها يتمدد بعض من التمييز والتنمر، والعنف اللفظى واللغوى ومحمولاته من المفردات والأوصاف التمييزية.
ثمة اتجاهات تتمدد داخل بعض المجتمعات الأوروبية ترمى إلى ضرورة إدخال إصلاحات داخل بنية النظام السياسي الليبرالي، نحو إعطاء الحق لبعض المواطنين -وأعداد متفق عليها- فى طلب اللجوء إلى استفتاء عام حول بعض التشريعات أو مشروعات القوانين، على خلاف رأى بعض الحكومات، وخاصة فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
24- تمثلت المطالبات بالتغيير، ومن ثم بعض التناقضات بين الحكومات، وقطاعات اجتماعية واسعة إلى اندلاع تظاهرات السترات الصفراء فى فرنسا، وبعض البلدان الأوروبية لأسباب اقتصادية واجتماعية، وكانت الدعوة وتنظيم هذه التظاهرات تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكلت التظاهرات فى الواقع الفعلي مشهدية فعلية، من الشعارات والنداءات والاحتجاجات، وفى بعض الاشتباكات مع قوات الأمن، ومع الهواتف المحمولة -والتلفازات فى الإعلام التقليدى- إلى مشهدية بصرية فيديوهاتية، يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، فى زمن حدوثها، للناشطين على هذه المواقع فى فرنسا والعالم.
لا شك أن الجموع الرقمية والفعلية الغفيرة كانت تعبيراً عن نهاية مفهوم البطولة والشهرة لرجال السياسة والسينما والفنون والأدب، لصالح مفهوم الجموع الرقمية الغفيرة والفعلية، وداخلها. هذا السعى المحموم لكل فرد رقمي فى إثبات ذاته وحضوره، ووجوده فى تفاصيل الحياة اليومية الفعلية من خلال التعبير والحضور الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعى، بل وإبداء الآراء السلبية والإيجابية والحيادية أو اللامبالية لمن هم فى موقع الشهرة والذيوع، أدى إلى استهلاك فائق السرعة لهذه الشخصيات فى السينما والمسرح، بل وفى الكتابة الأدبية والصحفية، من خلال المجموعات الأدبية- كصالونات القراءة، والصفحات الأدبية الرقمية، والأعداد المتزايدة لكتاب الروايات والقصص أيا كانت مستويات مواهبهم، أو عدمها، ومدى قدراتهم الأدبية والكتابية، بل ثمة إزاحة من هؤلاء للآخرين، والترويج لشخصياتهم وترويج أعمالهم.
25- ثمة مؤشرات على نهاية وشيكة لمفهوم الشهرة الفعلية في أنظمة الإعلام التقليدى، لصالح مفهوم الحضور الرقمى، والمشهدية البصرية؛ الفيديوهاتية وسرودها المرئية، عبر مئات الآلاف من الصور والفيديوهات الطلقة والمنشورات والتغريدات، والمزاوجة بين كليهما فى خطابات بين الفيديوهات القصيرة جدا، والكتابة، واستهلاكها فائق السرعة من جانب المتابعين، على وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال بعض التفضيلات، أو الحذف، أو اللا مبالاة تجاهها، بل ويلجأ بعضهم -فى الصحف والكتابات الأدبية- إلى اللجوء إلى كتاب ومدونين لتعظيم التفضيلات لخطابهم، على نحو رقمى، لكنه مخالف للواقع الرقمي والفعلي معا.
26- فى ظل هذا السعي المحموم للحضور الرقمى من الفرد الرقمى/ الفعلي، سعيا وراء التواجد، أو بناء المكانة، باتت المشهدية البصرية والقراءة الومضة سيدة وسائل التواصل الاجتماعى، ومن ثم لم يُعد مفهوم البطولة، والمروءة، والشهرة، حاضرة إلا نادراً واستثنائيا فى الحياة الفعلية والرقمية.
27- الظواهر الرقمية السابقة، والمتغيرة، والمتحولة فى اللغة، والمفاهيم التى سادت فى عديد المراحل التاريخية المختلفة للإنسانية وتطوراتها، ومنها البطولة والشهرة، وخاصة مع صعود الثورة الرقمية كونيا، والدخول إلى عصر الإناسة الروبوتية، تشهد تغيرا سيتحول إلى قطيعة معرفية ولغوية. والسؤال ما أثر ذلك على مقاومة الشعب الفلسطينى من المدنيين العزل، والمقاومة الإسلامية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ والمداهمات للسكان المدنيين وأحيائهم في الضفة الغربية، والعنف والقنص بالرصاص للمدنيين، وقتل وجرح وأسر بعضهم داخلها، وتمزيق سلطات الاحتلال لوحدة أراضيها من خلال المستوطنات والمستوطنين المحتلين.
28- يبدو أن الحضور الرقمى البصرى والكتابى على مواقع التواصل الاجتماعى -وبعض الإعلام التقليدي- أدى إلى إحياء جزئي متغير لمفهوم البطولة والشجاعة والمقاومة، لكن فى صيغة جديدة، ومختلفة عن هذا المفهوم الذي ساد فى الماضي، وذلك فى أشكال مشهدية وبصرية، يتم بثها وقت حدوثها على الواقع الرقمي/ الفعلي لمئات الملايين من مرتادى وسائل التواصل الاجتماعى، والفاعلين عليها. لا شك أن تدفق الفيديوهات الوجيزة، وتداخلها من المنشورات، والصور من بين تفاصيل المأساة الإنسانية للمدنيين من القتلى والجرحى والنازحين، ونقص الرعاية الصحية والدواء والماء والطعام والمباني المحطمة، والنزوح القسرى، كلها تفاصيل مشهدية دامية، تبث فوراً من الواقع التراجيدى للعدوان الإسرائيلي، والإبادة الجماعية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو أدى إلى خطف العيون، وشحذ القيم الإنسانية وإيقاظ بعض من الضمير الإنساني والأخلاقي داخل المجتمعات الغربية، وأيضا فى غيرها من دول العالم.
29- أدت السرديات المشهدية البصرية المتناصة مع الكتابية الومضية، إلى تحرك جنوب أفريقيا ودول أخرى داعمة لها، وتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالب على نحو عاجل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وفتح المجال أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين المدنيين العزل. لا شك أن مشهدية مرافعات الدفاع أمام المحكمة، جسدت الموقف القانوني العادل والأخلاقي لجنوب أفريقيا ودعاة السلم فى العالم. وتم بث هذه المرافعات، ومعها الدفاع الإسرائيلى المتهافت، على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات العربية، وهو ما أدى إلى استنفار الضمير الإنساني إزاء الكارثة الإنسانية التى يعاني منها المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والرجال الفلسطينيين.
30- يلاحظ أن السردية المشهدية البصرية- الفيديوهاتية الوجيزة جدا- لأطفال غزة من الموتى والمصابين والنازحين، ومن فقدوا آباءهم وأمهاتهن، كان من أبرز السرديات المشهدية البصرية، تأثيرا فى بعض الضمير الإنساني فى المجتمعات الأمريكية والغربية، وغيرها، ومثلت أحد أهم التوثيقات المرئية والبصرية للعدوان الوحشي على القطاع، وضحاياه، وعلى نحو حفز عديد من النشطاء الرقميين والفعليين على الدعوة للتظاهر وكتابة المنشورات والتغريدات وبث الصور على الحياة الرقمية.
31- باتت السردية المشهدية المرئية -الفيدوهاتية ومن خلال الصور والمنشورات والتغريدات- تمثل التحول النوعي، والقطيعة مع نماذج البطولة والشهرة الفردية، إلى الصورة والخطاب المرئى الحامل ربما لآخر ملامح الشجاعة والبطولة التى تم استدعاءها من حالة الموت والذاكرة التاريخية لمجتمعات عالمنا الكوني، إلى الحياة الرقمية، مع بطولة وشجاعة المدنيين الفلسطينيين العزل، وربما تكون آخر البطولات الجماعية فى عصر الأناسة الروبوتية فى عمليات تبلورها وتحولها إلى ما بعد الإنسانية.
إن المشهدية البصرية للكارثة الإنسانية لسكان قطاع غزة والإبادة والنزوح القسرى، والعقاب والحصار الجماعى، أعادت إحياء المسألة الفلسطينية، ومعها بعض من الروح للفكرة العربية الجامعة لدى قطاعات جماهيرية فى العالم العربى، وهو ما سيؤدى إلى تغيرات عديدة على مستوى إقليم الشرق الأوسط.
المصدر: الأهرام