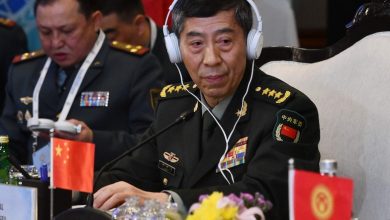تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين الآن تحولا في النمط الفِكري الذي يحكمها. أثارت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) مجادلة جديدة داخل أوروبا حول الحاجة إلى قدر أكبر من “تنويع” سلاسل الإمداد، وبالتالي ضرورة فك الارتباط بشكل منهجي موجه عن الصين. لن تكون هذه بالمهمة السهلة، ولن تحدث بسرعة. ولكن من الواضح أن أوروبا تخلت عن طموحها السابق في علاقة اقتصادية ثنائية أكثر تكاملا مع الصين.
في الماضي، عندما سعى الأوروبيون إلى إدخال إصلاحات على التجارة والاقتصاد والسياسة الخارجية في التعامل مع الصين، كان أملهم يتلخص دائما في زيادة التواصل مع الصين مع جعل العلاقة أكثر عدالة وتبادلية في ذات الوقت. كان الهدف الأساسي يتمثل في توسيع التجارة الثنائية وفتح السوق الصينية للاستثمارات الأوروبية. وحتى عندما شدد الاتحاد الأوروبي نهجه في التعامل مع الصين، ظل هدفه متمثلا في تعميق الروابط الاقتصادية معها. وجرى تقديم قرار إنشاء أدوات جديدة للاتحاد الأوروبي لفحص الاستثمارات وفرض تدابير مكافحة الاحتكار على أنه إجراء مؤسف لكنه ضروري لتهيئة الظروف السياسية لتعاون أوثق.
في تقرير نُـشِـر في وقت سابق من هذا الشهر، يزعم أندرو سمول من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن مشاركة الاتحاد الأوروبي مع الصين سيكون لها من الآن فصاعدا غرض جديد: تنظيم العلاقات الصينية الأوروبية على النحو الذي يقلل من اعتماد أوروبا على التجارة والاستثمار الصينيين. ويتلخص الإجماع الجديد في أن الأوروبيين ينبغي لهم أن يكونوا معزولين بدرجة أقوى عن نزوات الحكومات الأجنبية غير الجديرة بالثقة أو المتعجرفة، سواء كانت في بكين أو واشنطن.
يتجلى هذا الـفِـكر الجديد بوضوح في تصريحات كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، وجه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الدعوة إلى الأوروبيين مؤخرا للعمل على تقصير وتنويع سلاسل الإمداد، والنظر في تحويل علاقاتهم التجارية من آسيا إلى أوروبا الشرقية، ومنطقة البلقان، وأفريقيا. على نحو مماثل، تريد الحاكمة المطلقة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، تغيير قواعد المساعدات الحكومية لحماية الشركات الأوروبية من عمليات الاستحواذ الصينية.
من جانبها، لم تكن أغلب الحكومات الأوروبية راغبة في تغيير استراتيجيتها. حتى الآن، كانت تستثمر بكثافة في تطوير علاقة تعاونية مع الصين؛ وهي على المستوى العملي في احتياج شديد إلى الإمدادات الطبية الصينية الصنع لكي تتمكن من تجاوز الجائحة.
مع ذلك، ساعدت ثلاثة عوامل في تغيير الحسابات الاستراتيجية الأوروبية. الأول يتمثل في تغير طويل الأمد داخل الصين. كانت سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصين تستند سابقا إلى ما يسمى الرهان على التقارب، الذي رأى أن الصين ستصبح تدريجيا مواطنا عالميا أكثر مسؤولية إذا استُـقـبِـل دخولها إلى الأسواق والمؤسسات العالمية بالترحاب.
لكن ما حدث كان العكس. فقد أصبحت الصين في عهد الرئيس شي جين بينج أشد استبدادا. فنظرا لزيادة الدولة الصينية لدورها في الاقتصاد وبعد أن أصبحت الأسواق الصينية أقل ترحيبا بالشركات الأوروبية، لم ينحصر الأثر الذي أحدثته سياسات شي جين بينج الأصلية ــ صُـنِع في الصين 2025، ومعايير الصين 2035، ومبادرة الحزام والطريق ــ في إرغام الشركات الأوروبية على الخروج من السوق الصينية وحسب، بل اشتمل أثرها أيضا على تصدير النموذج الصيني إلى الخارج. لم تعد الصين تنافس على حصة من الإنتاج ذي القيمة المضافة المنخفضة. بل إنها تتسلق صاعدة بسرعة كبيرة سلسلة القيمة العالمية، وتخترق القطاعات التي يعتبرها الأوروبيون أساسية لمستقبلهم الاقتصادي.
ثانيا، تتبنى الولايات المتحدة على نحو متزايد نظرة أكثر تشددا في التعامل مع الصين، وخاصة منذ دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض. فقبل وقت طويل من اندلاع الجائحة، بدا أن هناك “انفصال” أوسع بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني يجري على قدم وساق. جاء هذا التغيير بشكل مفاجئ إلى حد ما، وكان له وقع الصدمة على الأوروبيين، الذين اضطروا فجأة إلى القلق من أن يتحولوا إلى ضحية لسباق “من يَـجـبُـن أولا” بين الصين وأميركا.
لنتأمل هنا كيف تناضل العديد من الدول الأوروبية لاسترضاء كل من الولايات المتحدة والصين بشأن الدور الذي تلعبه شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في بناء شبكات الاتصال من الجيل الخامس. من الناحية النظرية، كان ينبغي لتشكك أوروبا الجديد في الصين أن يمهد الطريق لتعاون أوثق بين ضفتي الأطلسي حول هذه القضية. ولكن بالهجوم على أوروبا بالتعريفات الجمركية، وغير ذلك من الهجمات غير المبررة، تسببت إدارة ترمب في تعكير ما كان ينبغي أن يكون اختيارا واضحا.
لكن التطور الثالث (والأكثر إثارة للدهشة) كان سلوك الصين خلال الجائحة. بعد الأزمة المالية العالمية العام 2008، بدت الصين وكأنها ترتقي إلى مستوى الحدث كقوة عالمية مسؤولة، حيث شاركت في جهود التحفيز المنسقة بل إنها اشترت اليورو واستثمرت في الاقتصادات التي كانت تعاني من نقص السيولة النقدية. ولكن ليس هذه المرة.
تنبئنا إحدى وقائع الجائحة بالكثير. في وقت مبكر من هذا العام، عندما كان فيروس كورونا متفشيا في ووهان، شحنت بلدان الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 60 طنا من المعدات الطبية إلى الصين. كان قسم كبير من هذا قادما من مخزونات استراتيجية وطنية، وقد أرسِل بشكل سري، بناء على طلب الصين. في المقابل، عندما وصلت الجائحة إلى أوروبا، قدمت الحكومة الصينية استعراضا ضخما لتقديم “المساعدة” إلى أوروبا ــ والتي كان قسم كبير منها مدفوع الثمن.
الأسوأ من هذا أن الصين كانت تستخدم غطاء أزمة كوفيد-19 لملاحقة صفقات اقتصادية مثيرة للجدال سياسيا، مثل خطة السكك الحديدية الممولة من الصين بين بلغراد وبودابست، والتي جرى تهريبها عبر الهيئة التشريعية في المجر كجزء من حزمة الطوارئ كوفيد-19. على نحو مماثل، كانت شركة هواوي عالية الصوت في الدفع بحجج مفادها أن الأزمة تبرر حتى طرح الجيل الخامس من الاتصالات بسرعة أكبر. وفي المملكة المتحدة، بذل صندوق رأسمال استثماري مملوك للدولة الصينية مؤخرا محاولة للسيطرة على واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في البلاد (Imagination Technologies).
لكن الأمر الأكثر إثارة للانزعاج كان استغلال الصين للاحتياجات الصحية لتعزيز مصالحها السياسية التافهة. على سبيل المثال، حذر مسؤولون صينيون هولندا من أن شحنات الإمدادات الطبية الأساسية قد تُـحـجَـب انتقاما من قرار الحكومة الهولندية بتغيير اسم مكتبها الدبلوماسي في تايوان.
منذ اندلاع الأزمة، أظهر الاتحاد الأوروبي رغبة أكبر في مقاومة حملات التضليل الصينية، كما تبنى تدابير لحماية الشركات الأوروبية المتعثرة من استحواذ مستثمرين صينيين عليها. لكن التحركات الأشد خطورة لم تأت بعد. وسوف يبدأ الأوربيون قريبا تحويل الحديث عن “التنويع” إلى عمل فعلي.
على أية حال، ربما ساعدت التغيرات الهيكلية التي تعمل من خلال النظام العالمي في نهاية المطاف على إنتاج مجادلة جديدة حول الصين على نحو أو آخر. ولكن الآن وقد كشفت أزمة كوفيد-19 عن مدى اتكالية أوروبا ونوايا الصين الحقيقية، يجري تحول استراتيجي على قدم وساق.
*مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
*خاص بـ”الغد” بالتعاون مع بروجيكت سنديكيت.
المصدر: الغد الأردنية