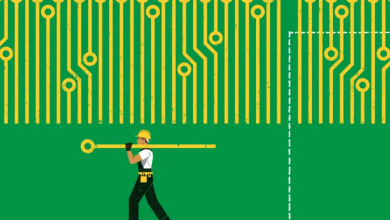بعد الحربِ العالميّة الثانية، وفي مواجهة التحدّي الشيوعيّ في فرنسا وإيطاليا والجزءِ الغربي من ألمانيا، استقرّ الرأي على تثبيت الانتصارِ عبر إكسابِه مضمونًا اجتماعيًّا-اقتصاديًّا. هكذا بُنيت دولةُ الرفاه، وكان مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا، بعمليّة كهذه، أُتيح لمستقبل من عاش مأساة الحروب أن يطمئنّ، وهو اطمئنانٌ عاش عقودًا متوالية أربعة. بعد انتهاءِ الحرب الباردة، اصطبغ الانتصار بالنيوليبراليّة، وباستعداد سخيٍّ ممن يسيطرون ويضعون القواعد لغضّ النظر عن باقي العالم في ثقافة استعمارية مترسبة، ونظرةِ استعلاء على تطلّعات شعوب الأرضِ إلى الحرّيّة والمساواة. اليوم أصبح إضعافُ المستقبل في مواجهة الماضي أمرًا لا مفرَّ منه، وأصبح النومُ على حرير الانتصارِ عجرفةً لا يقتصر أذاها على المتعجرفين بل يمتد لجميع سكانِ هذا الكوكب.
الماضي لا يمضي بسهولة وبتلقائيّة؛ في إيطاليا، وعلى رأس تحالفٍ يمينيّ، يعود «النيوفاشيّون» إلى الحكم، كما لو أنّ الفاشيّةَ وموسوليني لم يُهزما في الحرب العالميّة الثانية؛ وفي الحرب الروسيّة الراهنة على أوكرانيا ثمّةَ ما يوحي بنيّةٍ دفينةٍ لدى موسكو للعودة إلى ما قبلَ هزيمة الاتّحاد السوفياتيّ في الحرب الباردة، حتّى الانكسارات التي مُنيت بها الإمبراطوريّاتُ الكبرى في الحرب العالميّة الأولى، تجد من يعمل على إنهائها… فالرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان ربّما كان أبرزَ هؤلاء المرتدّين إلى ماضٍ إمبراطوريّ…حكّام إيران هم بالتأكيد أنشطُ العاملين على استعادة أمجاد إمبراطوريتهم التي حطَّمها إلى غير رجعة دعاءُ الرسول الأعظم عندما دعا على كسرى بقوله اللّهمَّ مزِّقْ ملكَه.
في الوقت نفسه، يجسّد واقعُ أوروبا الراهن محاولةً الدول القومية -الأمّة الانقضاضَ على انتصار العولمة؛ لقد ضعف مشروع الاندماج الأوروبيّ بسبب «بريكست»، فيما تتكاثر القوى القوميّة التي تطالب بوضع حدٍّ للاتّحاد العابر للدول، أو للحدّ من فاعليّته…
الحريةُ المنضبطة في توزيع الثروةِ التي تتناسب مع الفطرةِ البشرية في حب التملكِ كما وصف ربُّ العزة: ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ)، كانتِ السلاحَ الأقوى والأنجعَ للغرب الليبرالي في وجه الشرقِ الشيوعي، لكنَّها تحولت مع عصر تاتشر- وريغان في منتصف الثمانينات إلى الحرية المنفلتة وجعلت للدول دورًا ثانويًّا أمام قوانين السوق والتجارة الحرة، فأتتِ الصينُ لتهدمَ هذه الوعيَ المسيطر للمفهوم الأنجلوسكسوني للثروة وقواعد تداولها والذي أراد مبتدعوه أن يضعوا نهاية للتاريخ بتتويج انتصارهم العظيم في نهاية الحرب الباردة. لقد تحوّلتِ الرأسماليّة، على يد بوريس يلتسين، إلى نظام أوليغارشيّ فاسدٍ ومُتداعٍ، بعدما تحوّلتِ الاشتراكيّة، بوعودها الكبيرة لعام 1917، إلى نظام توتاليتاريّ يستأثر بالثروة ويبيع الشعارات للآخرين مع جوزيف ستالين، والآن يحاول بوتينُ إعادةَ بعثِه من جديد!
إنّ المسار الخطّيَّ للتاريخ خرافةٌ لا تعادلها إلا خرافةُ نهاية التاريخ؛ فليس هناك انتصارٌ كاملٌ حاسمٌ، ولا هزيمةٌ كاملةُ ساحقةٌ، وليست هناك بداياتٌ تُنهي ما سبق إنهاءً كليًّا، أو نهاياتٌ يمضي معها الماضي غيرَ مأسوف عليه إلى غير رجعة، ليس هناك ثقافة بشرية منتصرة وأخرى مهزومة!
معركةُ الثروة وقواعدُ توزيعِها السائدةُ تحدد فقط المنتصرَ والمهزوم المؤقت في المعركة، لكنها تفقد قوتها وزخمها عندما تعاكس الفطرةَ البشرية كما حدث مع الشيوعية، وبالتأكيد تفقد جوهرها إذا غابت عنها العدالةُ كما يحدث مع النيوليبرالية! العولمة واقع لا مفرَّ منه فرضته التكنولوجيا، لكنَّ الرأسمالية بمفهومها الريغاني (نسبة لرولاند ريغان)، والليبرالية بمفهومها الفيكتوري (نسبة للعصر الفيكتوري)، والانتصار العسكري بمفهوم كسب المعركة واحتلال الأرض واستعباد الشعوب بمفهومها الاستعماري: جميعُها يمكن وصفُها بالأيديولوجيات المترسبة بحسب مفهوم الناقد البريطانيّ (رايموند ويليامز ,1921-1988Raymond Henry Williams) والتي لم تعدْ تنفع البشرية في الوقت الراهن.
عندما تضع مفهوم حرية الثروة مع مفهوم المساواة، وتضيف له مفهوم العدالة، تمتلك خلطة لم تتجسد عبر تاريخ البشرية إلا في ومضات بسيطة (عصر الخلفاء الراشدين الخمسة) ! المشهد السريالي الحالي بين بشر يغرقون في إدمان حرق الثروة، وخلال ثوانٍ تُنقل حفلات إدمانِهم إلى بشر آخرين يغرقون في الحرمان من أبسط حقوق بني البشر، سيكون السلاح الجوهر (Game changer) في معركة القواعد الجديدة في توزيع الثروة.
من الجميل أن نفهم مصطلح “الأيديولوجية المترسّبة ” (residual ideology) من وجهة نظر الناقد البريطانيّ رايموند ويليامز في كتابه “الماركسية والأدب” كذلك مفهوم “الثقافة المهيمنة، المتبقية، والناشئة” فهو يفيدنا في تشخيص الواقعِ واستشراف الحلول والمستقبل. يشرح رايموند ويليامز كيف تحافظ الهياكلُ الاجتماعية المهيمنة-مثلُ الثقافةِ والهياكل الاجتماعية والاقتصادية الغربية المسيطرة في وقتنا الراهن-على هيمنتها، بينما في الوقت نفسِه مجموعاتٌ اجتماعيةٌ أخرى يحاولون أن يناقضوا أو يخربوا تلك الثقافات؛ بخاصة حين يكونون على الجانب المهزوم المتضرر، مثلما يحدث مع باقي شعوب الأرض وروسيا والصين منهم. فكما سبق وأشرنا ليس هناك انتصارٌ كاملٌ أو هزيمةٌ كاملةٌ لبشر على حساب بشر، أو سيادةٍ لمفهوم بشري على حساب مفهوم بشري آخر، ويختلف الأمرُ بالتأكيد إذا كان المفهوم فوق بشري (إلهي)، ولكن المعضلة بحسب أي تفسير!
الناقد البريطانيّ رايموند ويليامز يتطرق إلى فكرة جوهرية: وهي أنَّه في حين أنَّ القوة المهيمنة هي أقوى قوة تشكيل كما يتضح من الاسم، فإنَّها لا تحصل على انتصار كامل، ولكنَّها تظهر في الغالب كنوع من الكتلة الثقافية التي يُلجَأ إليها على حساب أنواع ثقافية الأخرى تحت مبررات كثيرة منها على سبيل المثال مواكبة التطور التكنولوجي (مثلما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي وقريبًا في منتجات الذكاء الاصطناعي التي تؤمن الحاجات بسرعة وراحة أكبر). لقد افترض ويليامز أنَّ الثقافةَ السائدة هي التي يمكن رؤيتُها بوضوح في المجتمعات من خلال الممارساتِ والأفكار التي ينغمسون فيها هم أنفسهم، ولا تتطلب تلك الثقافةُ تفسيرًا واسعًا فهي واقعٌ لا مفرَّ منه. في حالتنا الراهنة تُعَدُّ الثقافةُ الاستهلاكية والتركيز على الفردية مثالان يمكن اعتبارهما جزءًا متأصلًا من الثقافة الأمريكية المهيمنة. لكن ويليامز يشرح بوضوح القوتين الأخريين اللتين هما محور الصراعات التي نشاهدها من حولنا، “الثقافة المتبقية والناشئة.”
الثقافة “المتبقية” -بحسب وليام-هو تأثير الممارسات الثقافية القديمة على المجتمعات الحديثة، بوعي أو بغير وعي؛ وهي نوع من البقايا الثقافية وكذلك الاجتماعية التي يتمُّ تسربُها إلى البنية التحتية للثقافة المهيمنة، وأوضحُ مثالٍ عليها الثقافةُ الدارجة للالتزام الديني والأعراف في مظاهرنا وممارساتنا اليومية في عالمنا العربي والاسلامي. يَعدُّ ويليامز الدينَ المنظم والمجتمع الريفي والنظام الملكي (حكم الأخويات والنوادي السرية في الجمهوريات الليبرالية) ثلاث سمات متبقية مهمة للثقافة الأنجلوسكسونية، فالمُثُل البروتستانتية والبيوريتانية (Puritanism) التي لا تزال تشكل التصورات الثقافية في المجتمع الأمريكي اليوم مثالًا جيدًا للثقافة المتبقية، وهي بالتأكيد كانت المحرك الرئيسي لاتباع ترامب الذين اقتحموا الكونغرس وللجماهير الحاشدة الذين اصطفوا لوداع الملكة اليزابيت الثانية.
يشرح قسمٌ آخرُ في كتابه بوضوح الثقافة الناشئة أيضًا، حيث يصفُها بأنَّها الأفكار والممارسات الثقافية الجديدة التي يتم إنشاؤها باستمرار في المجتمع من قبل الجماعات والأفراد، وأضيف عليها الحكومات في دولنا؛ يمكن أن تكون هذه الأفكار هي السائدة، لكنها قد تكون أيضًا بديلة أو متعارضة. وللغرابة قد يكون البديل-بحسب وليام-أقلَّ تصادمية، حيث من المفترض أن تكون المعارضةُ للثقافة المهيمنة أكثرَ تصادمية. يعطي وليام مثالًا على ذلك بثقافة الهيبي التي ظهرت في ستينات القرن الماضي ولم تصادم الثقافة الليبرالية بل تشكل ثقافة فرعية منها. الدواعش في عالمنا الإسلامي ربما يشكلون حالة مماثلة.
يقول وليام ” لا يوجد نظامٌ اجتماعي مهيمن، وبالتالي لا توجد ثقافةٌ مهيمنةٌ في الواقع تتضمن أو تستنفد كلَّ الممارسات البشرية والطاقة البشرية والنية البشرية “ربما هذا ما نحاول أن نعكسه في هذه المقالة، فقياسًا بالوعيين «المسيطر» و«الناشئ»، نجد أنَّ الأمر أكثر بكثير من مجرّد «تأثير» لا تزال تملكُه الممارسات الثقافيّة القديمة على المجتمعات الحديثة، لكنه صراعٌ بشريٌّ قديمٌ جديد ابتدأه قابيلٌ وهابيل، عنوانُه الطمع وحبُّ الاستئثار بالثروة المادية والمعنوية (شهوة الاستعلاء) على حساب الآخرين، ولم تفلح ماركسية لينين ولا رأسمالية الغرب ولا حرية فولتير في إعطاء وصفة ناجعة! يبدو الصراع الحالي والعصر الجديد- عصر ما بعد هذا الصراع – دليلًا دامغًا على هذا الفشل، أمَّا ثقافةُ التطرف، فهي دليلٌ على فشل من يحملون أعظم رسالة على تفسير معاصر قبل تجسيد عملي لهذه المعادلة التي يمكن وصفها بالسهل الممتنع!
فهل يفلح من ينضوي اليوم تحت علم اللاجئين والمشردين بلا وطن أو ثروة أو أبسط الحقوق والظروف للعيش البشري أن يخرج منهم من يُعيد دمج القواعد الإلهية بنموذج اجتماعي اقتصادي ثقافي يُجسد العدالة والفطرة في إعمار الأرض؟