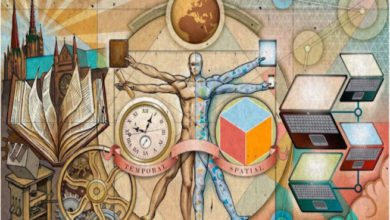(1)
لو صارت مصداقية المنظّمة الأممية، التي أنشأها كبار ما يُسمّى “المجتمع الدولي”، هدفاً لإضعافٍ متعمّد من كبيرٍ من بين أولئك الكبار، فلن يبقى لبقية أعضاء ذلك المجتمع إلّا انتظار مصيرٍ مُزرٍ؛ إذ إنّ الانهيار (لا مندوحة عنه) واقعٌ على صغار دول ذلك المجتمع. ولو جاز لنا أن نستعير شيئاً من اللغة والنحو، فإنّ وقوع الواقعة سيدفع أثمانه “المفعول به” بلا رحمة، وسينفد “الفاعل” بجلده، من دون محاسبة.
إن المنظمة الأممية التي بلغ عمرها ثمانين عاماً، وتوافَق على إنشائها الكبار بعد حرب عالمية انتهت عام 1945، وبعد أن أهلكت خمسين مليوناً من سكّان الأرض، وأحدثت ما أحدثت من دمارٍ في المقدّرات، ومن انهيارٍ في العمران، يكتب اليوم فصلها الأخير زعيمٌ شعبوي يريد أن يقود العالم وفق رؤاه ومزاجه، رافعاً شعاراً صاغ تفاصيله من مناماته، ومن بعض أضغاث أحلامه لاستعادة المجد لبلاده.
(2)
في حسابات الرئيس ترامب، يمكن أن يتحقّق المجد المنشود بالاستقواء والغطرسة على أنداده في المجتمع الدولي، وبالاستكبار والسيطرة على صغاره. نرى ذلك في تعامله مع دولةٍ ندٍّ للولايات المتحدة مثل الصين، وأخرى مستضعفة مُستصغرة مثل فنزويلا، يرسل الرئيس “الشعبوي” إلى عاصمتها (كاراكاس) أزلامه فيختطفون رئيس تلك الدولة من غرفة نومه، ويقتادونه مكبّلاً ليُحاكَم بالقانون الأميركي في مدينة نيويورك. أجل، تستخفّ مثل هذه البلطجة بمبادئ وقيم المجتمع الدولي التي تحمي سيادة الدول، وليس بعيداً من مقرّ المنظّمة الأممية نفسها. أمّا عن قصته مع بعض رؤساء أفريقيا الذين زاروه في البيت الأبيض، فيبدي “الشعبوي” استغرابه (في تعليق ساذج) لإجادة بعضهم اللغة الإنكليزية؛ فتأمّل!
من ينصت لتصريحات ترامب، ذلك الرئيس الشعبوي، يساوره شكٌّ في إن كان ينصت لمستشاريه أو يطالع تقارير مساعديه
(3)
هكذا يتابع الشعب الأميركي سياسات مَن انتخبه رئيساً لبلاده، فإذا هو يصارع في الداخل الأميركي، كما يناطح في الخارج، بذهنية ديكتاتور غاشم، أكثر منه زعيماً منتخباً ليحكم أربعة أعوام وفق الدستور الأميركي. تتحكّم بالرجل ذهنية الاستقواء والاستضعاف، حتى في سياساته الداخلية، وإن بدا حذراً؛ إذ إن أيَّ استهداف للمؤسّسات الأميركية الراسخة، رسوخ دستور عمره أكثر من قرنَين، لن يكون سهلاً أو ميسوراً العبث بثوابته.
لك أن تنظر لأفاعيل الرجل في سياسته تضييق الخناق على المهاجرين، وما أثاره من اضطرابات في عديد من الولايات والمدن الأميركية، مصادماً في ذلك، ومهدِّداً، تماسك النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة.
(4)
غير أن أخطر ممارسات الرئيس الأميركي الشعبوي مناطحاته وصراعاته الخارجية، تلك التي تمثّل أطماعه الرغبوية في التمدّد لابتلاع بلد بحجم كندا، وفي الاستيلاء على “غرينلاند”، في استهانة قصوى ببديهيات مبادئ التعاون الدولي ومواثيقه، واحترام قدسية سيادة الدول. تلك هي القيم الأساسية التي قام عليها نظام الأمم المتحدة، وهو النظام الذي من مقاصده العليا حماية الأمن والسلم الدوليَّين وحفظهما، حتى لا ينحدر العالم من جديد إلى حربٍ عالمية ثالثة لا تُبقي ولا تذر.
للمرء أن يتساءل إن كان ذلك الرئيس الشعبوي وبذهنيته تلك، وبخبراته في مجالات الاستثمار والعقارات، يملك الدراية الكافية عن خلفية وتاريخ الأمم المتحدة التي يسعى حثيثاً إلى التقليل من شأنها، والاستخفاف بإرثها في حفظ الأمن والسلم الدوليَّين؟ ثم للمرء أن يسأل: هل يدرك الرجل طبيعة تلك الأنظمة والوكالات والهيئات المتخصّصة التي انبثقت من التوافق العالمي لميثاق الأمم المتحدة، التي استتبعت قيام الأمم المتحدة، مكمّلة لمهامها السياسية والدبلوماسية؟ إن الإرث الباذخ للأمم المتحدة يتجاوز تلك المهام ليتّصل بمعالجة أوجه التعاون الدولي كافّة، اقتصاداً وتجارةً وثقافةً وصحّةً… من ينصت لتصريحات ذلك الرئيس الشعبوي، يساوره شكٌّ في إن كان ينصت لمستشاريه أو يطالع تقارير مساعديه.
إن جهوداً جبّارةً بُذلت لتأسيس بنيان التعاون الدولي: من مؤسّسات بريتون وودز الاقتصادية والمالية، ومن الوثائق الأساسية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنظمات مثل يونسكو، والتجارة الدولية، والصحّة العالمية، وسوى ذلك كلّه من ملفّات ومن قضايا دولية، خرجت من عقول ذكية وشاركت في معالجات فكرية معمّقة، وعصفٍ ذهني عميق، لتشكّل هذا البنيان الشامخ الذي اسمه منظومة التعاون الدولي.
(5)
لم تكن للدبلوماسية المتعدّدة الأطراف، التي قامت على أكتافها منظومة التعاون الدولي، من منجزات تقابل الطموح المأمول أو تلاقي الرضا المطلوب. لقد وُلد نظام التعاون الدولي، ومنذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، مشوَّهاً ومشوباً بنواقص لم تفلح معها جهود بُذلت خلال سنوات وعقود (لأسباب تتصل بتعقيدات حقبة الحرب الباردة) لإصلاحٍ منشود للتشوّهات، ولرتقٍ مطلوب للثغرات.
إن كانت تلك هي حال المنظّمة الأممية، فلن يكون مطلوباً لتنشيط فعاليتها إلّا ما قد يحقّق الحدّ الأدنى والمتواضع من ملاحقة الخلافات والصراعات الدولية التي عصفت بالعالم هذه الآونة. ذلك ما فتح شهية الرئيس الشعبوي وإن لم يسأله أحد؛ فمدّ رجليه في الساحات الدولية، مرتاحاً كفعل أبي حنيفة النعمان حين سأله سائل جاهل، بعد كل مساعيه لاقتراح الحلول لكل أزمة تطرأ، أو لكل حرب تنشب، وأعلن رغبته الطفولية في الحصول على جائزة نوبل للسّلام.
نقف على عتبات حقبة الفوضى الدولية، بديلاً من التعاون الدولي الآفل
(6)
آخر شطحاته اقتراحه “مجلساً للسلام” خطر له لإدارة قطاع غزّة بعد الحرب الطاحنة، لكنّه (ومن بنات أحلامه التي لا نهاية لها في مناماته) طرح مقترحه موسّعاً، ومن دون أن يقول صراحة إنّ “مجلس السلام” المقترَح قد يكون الشكل الموازي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو بديلاً محتملاً له في المستقبل القريب. طفق الرئيس الشعبوي يرسل دعواته لمن يختار من الشرق والغرب، وبمزاج رائق، لعضوية “مجلس السلام” المزعوم.
ليست الأمم المتحدة ذلك المبنى القديم القائم في نيويورك الذي قام بلا أسس ولا جذور ولا مبرّرات… كلّا. لقد جلس 50 ممثّلاً من دول العالم في لوس أنجليس، مباشرةً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، للتداول حول إخراج ميثاق الأمم المتحدة. شهرين، راجعوا ما تجمّع لهم من وثائق شملت مخرجات ثلاثة مؤتمرات للقادة المنتصرين في تلك الحرب: مؤتمر في طهران، والثاني في بوتسدام (في المنطقة الألمانية التي يسيطر عليها السوفييت)، والأخير (الأشهر) في يالطا (في أوكرانيا). وشكّلت تلك المؤتمرات، بعد تشاور وتداول معمّق، المراجع الأساسية لصياغة ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
تُرى، أيُّ مرجعيات استند إليها الرئيس الشعبوي في مقترحه الشخصي بإنشاء “مجلسٍ للسلام”، من دون أي إشارة للأمم المتحدة أو لميثاقها؟
لربما تكمن الإجابة في أنّنا نقف على عتبات حقبة الفوضى الدولية، بديلاً من التعاون الدولي الآفل.
المصدر: العربي الجديد