
في أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد، كانت الأنظار تتجه إلى صناديق الاقتراع بوصفها علامة على ولادة مرحلة جديدة، لا مجرّد تبدّل في الأسماء.
لكن النتائج حملت خيبةً مزدوجة: خيبةً في التغيير السياسي الذي وُعِد به السوريون، سواء بتعويم وجوهٍ قديمة أو بمحاولة تسلّق بعضهم لسُلَّم المرحلة، وأخرى أعمق في تمثيل النساء اللواتي غبن تقريبًا عن المشهد، رغم كل ما قدّمنه خلال سنوات الحرب وما بعدها.
فبدت العملية السياسية وكأن التحوّل المأمول أعاد إنتاج الإقصاء نفسه، ولكن بوجهٍ أكثر نعومة وأقلّ صخبًا.
بقيت آليات التفكير القديمة تحكم الفعل السياسي، وبدا أن المجتمع الذي انتفض ضد سلطة الفرد ما زال أسير السلطة الأبوية.
ربما كان من المفترض أن تكون المرحلة الانتقالية في سوريا امتحانًا لقيم العدالة والمواطنة، وأن تشكّل الانتخابات الأولى اختبارًا حقيقيًا لقدرة السوريين على كسر القوالب التي صاغها نظام الأسد لعقود.
فبعد سنواتٍ من الخطاب الإنشائي عن مكانة المرأة ومساهمتها في المجتمع، كانت اللحظة الديمقراطية المنتظرة فرصة لتثبيت حضور النساء في القرار السياسي بوصفه حقًا لا منّة.
غير أن ما جرى كشف عن هشاشة البنية الاجتماعية والسياسية التي لم تتغير جذريًا بعد.
فحتى مع سقوط النظام، بقيت آليات التفكير القديمة تحكم الفعل السياسي، وبدا أن المجتمع الذي انتفض ضد سلطة الفرد ما زال أسير السلطة الأبوية.
وعلى الرغم من محاولات الإدارة الجديدة إضفاء طابعٍ “ديمقراطي” على العملية الانتخابية، فإن الواقع السياسي والقانوني في البلاد يجعل من هذه الانتخابات شكليةً أكثر منها حقيقية.
فغياب البيئة الآمنة والمستقلة، وعدم الوضوح في رسم ملامح المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضعف مؤسسات الرقابة، كلها عوامل تجعل العملية الانتخابية تفتقر إلى الشفافية.
كما أن المشاركة السياسية في ظل هذا المناخ تبقى محدودة الأثر، ولا يمكن اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة السوريين الحرة.
هل في هذا ما يدعو للدهشة؟ ليس تمامًا.
فالبلاد خارجة من سجنٍ كبير أعاق حرية التفكير، وتسبّب بشللٍ في ممارسة الحريات والحقوق الطبيعية. وما زلنا مبتدئين جدًا في تنظيم البرامج الانتخابية والمقارنة بينها والاختيار، ويبدو من ضروب الخيال أن يُتهيأ لنا أن التحول الديمقراطي سيتحقق بين ليلةٍ وضحاها.
ولا أقصد هنا مسألة الحياة السياسية فحسب، بل أيضًا تعامل المجتمع مع المعطيات والشروط التي تمهّد لحياةٍ سياسيةٍ صحية.
إن غياب النساء عن البرلمان لم يكن مجرد صدفةٍ انتخابية، بل انعكاسًا لتاريخٍ طويل من التمثيل الشكلي.
ففي العقود السابقة، استُخدمت المرأة بوصفها رمزًا تجميليًا لحداثة النظام، عبر مقاعد “كوتا” محددة وواجهاتٍ نسائية تابعة للأجهزة السياسية.
ومع أن هذه المقاعد وفّرت حضورًا شكليًا في المشهد العام، فإنها لم تمنح النساء سلطةً حقيقية أو صوتًا مستقلًا.
في الانتخابات الأخيرة، غابت حتى تلك الواجهة الرمزية.
لم تُسعف الوعود ولا الخطابات الداعية إلى المشاركة الشاملة في تصحيح اختلالٍ بنيوي عميق، ليس في التمثيل الجندري فقط، وإنما في بنية المجتمع ذاته، الذي لا يؤمن بالنساء على أنهنّ شريكاتٌ حقيقيات.
لقد غاب التمثيل النسائي كأن الكرسي البرلماني ما زال محجوزًا لذكورةٍ سياسيةٍ تعيد تعريف نفسها في كل مرة، لكنها لا تسمح لغيرها بالدخول.
وعند قراءة خريطة الأصوات، يتضح أن المشكلة لم تكن فقط في القوائم الانتخابية أو القوى السياسية التي نظّمتها، بل في المزاج الاجتماعي ذاته.
فالمجتمع الذي واجه طغيان السلطة لم ينجح بعد في مواجهة طغيان العرف، فصوت الناخب ظلّ محكومًا بنمطيةٍ راسخة ترى في السياسة شأنًا رجاليًا، وفي المرأة كائنًا رمزيًا يصلح للتمثيل في المناسبات، لا في مواقع القرار.
الناخبات أنفسهنّ لم يخرجن كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالتنشئة الاجتماعية والسياسية أقصت النساء عن الحيّز العام لعقود.
لذلك ذهبت كثير من الأصوات النسائية بدورها إلى المرشحين الرجال، إما بدافع العرف أو بدافع “الواقعية السياسية” التي أقنعت الناخبات بأن “الكرسي ليس لهنّ بعد”.
تعتمد كثير من المنظمات السياسية والمدنية على ما يُسمّى بـ“الكوتا النسائية” كآليةٍ لضمان الحد الأدنى من المشاركة، لكن هذه الآلية، كما أظهرت التجربة السورية، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى غطاءٍ رمزي أكثر من كونها وسيلة تمكين.
فالكوتا، عندما تُفرض دون معالجة الأسباب العميقة للتهميش، تصبح مجرد ديكور في مشهدٍ لم يتغير.
في الغالب، لم تتغيّر العقلية الداخلية في الإدارة، فالمناصب القيادية ظلّت حكرًا على رجالٍ يحملون صيغة الخطاب الجديد لا مضمونه.
بقيت النساء في مواقع الدعم والتمثيل في المبادرات المدنية، ونادرًا ما تبوأت إحداهنّ مقعدًا في مراكز القرار وصناعة الاتجاهات.
ربما أمامنا اليوم تجربةٌ ناطقة تخبرنا أن الكوتا لا تصنع المساواة، بل تكشف غيابها.
فهي أشبه بمرآةٍ تُظهر بوضوح حجم الفجوة بين الخطاب والواقع، فحين تُمنح المرأة مقعدًا محجوزًا مسبقًا، تُمنح أيضًا رسالةً ضمنية: هذا حجمك، لا تتجاوزيه.
ليس سهلاً على مجتمعٍ عاش عقودًا من السيطرة الأبوية والسياسية أن يُعيد تعريف ذاته في بضع سنوات.
فالإقصاء الذي مارسه النظام السابق لم يكن سياسيًا فقط، بل ثقافيًا واجتماعيًا أيضًا.
استخدم النظام “التمكين النسائي” كواجهة لتلميع صورته، لكنه في الوقت ذاته حاصر المرأة داخل أطرٍ شكلية ومنظماتٍ رسميةٍ تابعةٍ له.
هذا الإرث لن يُمحى بسهولةٍ بسقوط النظام، لأن الذهنية التي أنتجته لم تُستبدل بعد.
فتجارب الأحزاب الجديدة التي ظهرت بعد التحرير لم تكن، في معظمها، مختلفة جوهريًا، إذ غلب عليها الطابع الذكوري في الإدارة والتفكير وحتى في الخطاب العام.
وهكذا استمرّ الغياب النسائي بوصفه نتيجةً منطقية لمنظومةٍ لم تتعلم بعد كيف ترى المرأة كفاعلٍ سياسيٍّ مستقل، وكأن المجتمع لا يزال يتعامل مع الطموح السياسي للمرأة بوصفه خروجًا عن المألوف لا ممارسةً طبيعيةً للحق.
في الحالة السورية، ما زال الخطاب السياسي متمركزًا حول صراعات السلطة، لا حول إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
لوحظ في الآونة الأخيرة مزيدٌ من التراجع في مواقف النساء أيضًا، إذ تركن الميدان تحاشيًا للمنافسة غير العادلة، في حين أعلنت أخريات أنهنّ يُفضّلن العمل المدني على السياسي، في محاولةٍ لتجنّب الصدام مع بيئةٍ لم تتصالح بعد مع حضور المرأة في الميدان السياسي.
لكن هذه الحالات الفردية، وإن بدت بسيطة، تعبّر عن خوفٍ جمعي من التغيير، وعن مجتمعٍ لا يزال يختبر حدود تقبّله للمساواة.
لقد شكّلت مشاركة النساء في كثير من الدول الخارجة من النزاعات بوابةً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
ففي بعض التجارب، كان حضور النساء في البرلمان رافعةً للمصالحة وتجاوز الانقسام، لأن المرأة مثّلت صوت الضحايا لا صوت المنتصرين.
في الحالة السورية، ما زال الخطاب السياسي متمركزًا حول صراعات السلطة، لا حول إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
وبالتالي، غابت النساء عن التمثيل لأن معايير القوة لا تزال ذكوريةً في جوهرها.
فلم يُنظر إلى الكفاءة أو الرؤية أو الخبرة، بقدر ما يُنظر إلى الانتماء والقدرة على الحشد، وهي معايير لا تمنح النساء مساحةً عادلةً للمنافسة.
ليس التمثيل النسائي ترفًا ولا مطلبًا فئويًا، بل شرطٌ أساسي لأيّ ديمقراطيةٍ حقيقية.
فالمجتمع الذي يُقصي نصف أفراده من القرار لا يستطيع أن يدّعي الشمولية أو العدالة.
وغياب النساء عن البرلمان الجديد لا يعني فقط خسارةً في الأرقام، بل خسارةً في نوعية النقاش السياسي، في اللغة التي تصوغ السياسات، وفي القيم التي تُبنى عليها الدولة.
لطالما كانت النساء في الخطوط الأمامية للمجتمع: في الإغاثة، والتعليم، والطب، والإدارة المحلية.
وعندما جاءت اللحظة السياسية، أُعيد وضعهنّ في الصفوف الخلفية.
ويبدو أن هذه المفارقة تلخّص جوهر الأزمة السورية الجديدة: إنها أزمة وعيٍ لا تزال تُكرّس التهميش بدل أن تُفكّكه.
وفي مواجهة هذا التهميش، لم تكن معركة النساء فقط مع المجتمع، بل مع ذواتهنّ أيضًا.
فسنواتٌ طويلة من التلقين الاجتماعي جعلت كثيراتٍ يشككن في كفاءتهنّ السياسية، وكأن الإقصاء المتكرر تحوّل إلى قناعةٍ داخلية بوجود سقفٍ لا يجوز تجاوزه.
وبهذا لم يعد التحدي هو انتزاع الفرصة من يد الرجل فحسب، بل إقناع الذات بأن هذه الفرصة ممكنةٌ أصلًا.
لقد خاضت المرأة السورية أقسى تجارب الحياة في فترة الحرب، لكنها تجد نفسها اليوم أمام جدارٍ صلبٍ من الأحكام المسبقة، بعضها صادرٌ من محيطها وبعضها يتسلل إلى داخلها.
فتواجه في كل محاولةٍ للتقدم نحو موقع قرارٍ بنظرات تشكيكٍ أو نبرات استهجان، وأحيانًا بتخويفٍ مُقنّعٍ يُعيدها خطوةً إلى الوراء.
ومع ذلك، فإن هذا الصراع الداخلي يكشف أن التحوّل الحقيقي لن يبدأ من صناديق الاقتراع، بل من داخل الوعي النسائي نفسه؛ من إعادة بناء الثقة بالذات، لا انتظار اعتراف الخارج.
إن فشل التمثيل النسائي في أول برلمانٍ بعد الأسد ليس مجرد انعكاسٍ لتقصير الأحزاب أو ضعف المشاركة، بل اختبارٌ أخلاقي للمجتمع السوري بكامله.
فالتغيير الحقيقي لا يُقاس بعدد المقاعد أو الأسماء، بل بمدى قدرة المجتمع على إعادة تعريف السياسة بوصفها شأنًا إنسانيًا لا ذكوريًا.
الكرسي الفارغ في البرلمان هو أكثر من مقعدٍ لم تشغله امرأة؛ إنه رمزٌ لغياب وعيٍ جمعي لم يدرك بعد أن العدالة لا تُجزّأ، وأن الديمقراطية بلا نساء ليست سوى وجهٍ آخر للسلطات القديمة.
وربما سيحتاج السوريون إلى وقتٍ طويل كي يتصالحوا مع هذه الحقيقة، لكن الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف بأن الكرسي الفارغ ليس عيبًا في المرأة التي لم تصل، بل في المجتمع الذي لم ينضج بعدُ بالقدر الكافي ليكون منصفًا.
المصدر: تلفزيون سوريا


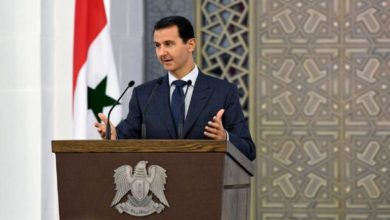
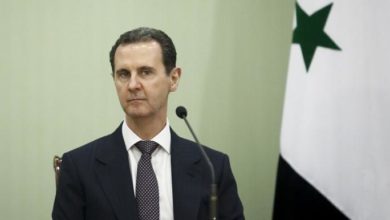




بعد صدور نتائج صناديق الإقتراع للهيئات الإنتخابية لمجلس الشعب السوري بأول انتخابات بعد سقوط النظام البائد، بوصفها علامة على ولادة مرحلة جديدة، لا مجرّد تبدّل في الأسماء. أظهرت قصور بتمثيل العديد من الشرائح المجتمعية ومنها المرأة ، لذلك كانت حصة الرئيس 70 كرسي لترميم هذه النسيج المجتمعي .