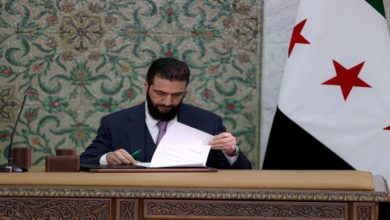تعيش سورية منذ أعوام في مناخٍ يُشبه المعسكر المفتوح لغة يومية مُثقَّلة بإشارات القوّة، ومجال عامّ أعاد ترتيب بداهاته حول يقين واسع بأن السلطة تُعرَّف بما تحمله من سلاح لا بما تُقيمه من قانون.
في هذا المناخ تصبح العقلانيةُ خروجا عن الواقع، وتتحول أي محاولة للنقاش إلى مقامرة بالنفس؛ فالردود غالباً عنيفة أو مُشوبة بظلال التهديد، ما يجعل الحجة أقلّ وزناً من البندقية، ويُغري سرديات التعبئة بأن تقدّم الأمن كبديل عن السياسة لا كثمرةٍ لها.
على نحوٍ موازٍ، بدا التيار الديمقراطي الليبرالي الذي حمل يوماً وعد الدولة العادلة منكفئاً ومجزّأً لا لأنه فقيرٌ بالحجّة، بل لأنه فشل في تحويل رصيده الأخلاقي إلى قوّة اجتماعية منظَّمة تُقنع جمهوراً مُنهكًا بأن القانون لا يُخلق بعد الأمن، بل يصنعه.
لفهم هذا الانكفاء لا بدّ من النظر إلى التشكل العميق للواقع من خلال حربٌ طويلة أغلقت بنية الفرص السياسية وأضعفت الوسائط المدنية التي تتنفّس من خلالها الديمقراطية (نقابات، جمعيات، بلديات، إعلام محلي)، واقتصاد حرب أعاد توزيع المنافع حول المعابر والجبايات والسمسرة فصار الولاء عملةً يومية والاستقلالية كلفةً باهظة.
وعلى هذا الركام نشأت هيمنة رمزية صاغت قاموساً جديداً للمعقول بحيث صار الاختلاف تهديداً وجودياً لا تنوّعاً مؤسَّساً، وغدت الطاعة قرينة النجاة، والتعددية اسماً مستعاراً للفوضى.
هنا فقد خطاب المدنيين قدرته على الإقناع؛ لأنه خاطب الضمير من خارج حساسية الخوف، ولأنه ترك لسردية الخصم امتياز تعريف الأمن بوصفه غياب الخطر لا حضور القانون.
غير أنّ هذه الصورة ليست قدراً. فالمعركة في جوهرها معركة على اللغة بقدر ما هي صراعٌ على الأدوات. من يَصنع الإطار التفسيري يَصنع الحدود الذهنية للممكن؛ لذلك نجحت القوى الراديكالية حين أقنعت جمهوراً متعباً بأن الخراب هو أثر “فوضى الحرية”، وأن الانضباط “أيّاً كان مصدره” أسرع طريقٍ إلى الاستقرار.
في المقابل، أخفق التيار الديمقراطي في إنتاج سرديةٍ مضادّة تُعيد المصطلحات إلى مواضعها بأن الأمن منتجٌ قانوني، والعدالة ليست مجرد تفصلاً أخلاقياً بل شرطاً للاستقرار، والدولة ليست جهاز تعبئة بل عقداً حيادياً يُساوي بين الناس ويقيّد القوّة. ما لم يُستعاد هذا المعنى، ستبقى السياسة مُصادَرةً باسم النجاة، وسيبقى المجتمع رهينةً لمعادلة “شرعيّة القوّة” بدل “قوّة الشرعيّة”.
لكن ثغرة الخطاب المدني ليست وحدها ما يفسّر المشهد؛ فالمشكلة السورية اليوم مزدوجة من خلال انكفاءٌ مدنيٌّ وعسكرةٌ للمجتمع.
إذ تحوّل السلاح “بكثرة الرماة وندرة العقد” إلى وثيقة تعريف سياسية واجتماعية بندقيةُ جماعةٍ أو فصيلٍ أو سلطة أمر واقع، لا بندقيةُ وطن.
هكذا غاب المعيار الجامع لاستخدام القوّة، وتراجعت الدولة من كونها مؤسّسة تحتكر العنف احتكاراً شرعياً ومراقَباً إلى ساحة تنافس بين قوى تحتكر العنف أمراً واقعاً.
وبغياب هذا الفارق الدقيق بين “الشرعي” و“الأمْرِيّ”، تشوّهت وظائف الأمن ذاتها فصار “أمن السلطة” هو المعيار، بينما انكمش “أمن المواطنين” إلى هامشٍ أخلاقي لا حماية له.
من هنا تنشأ ضرورةٌ مفهومية غير قابلةٍ للتأجيل تتجسد في أنه لا معنى لأي مشروعٍ سياسي لا يجيب صراحةً عن سؤال القوّة. ليس لأن السياسة ينبغي أن تُعسكر، بل لأن القوّة ينبغي أن تُدستَر.
المقصود بـ“دسترة القوّة” الانتقالُ من شرعيةٍ تُستمدّ من الأمر الواقع إلى قوّةٍ تستمدّ شرعيتها من قواعد عامة عبر:
سلسلة أوامر موحّدة المصدر والغرض،
مهنيةٌ تُعرِّف استخدام القوة بقواعد اشتباكٍ مُعلنة وقابلةٍ للمراجعة،
ورقابةٌ قضائيةٌ ومجتمعيةٌ تُحوّل السلاح من امتيازٍ خاص إلى وظيفةٍ عامة.
بهذه الشروط فقط تكتسب عبارة “البندقية الوطنية” معناها: بندقيةٌ تحرس القانون لا الأشخاص، وتحمي المختلف قبل الموافق، وتستمد هويتها من العقد الاجتماعي لا من راية الجماعة.
لا يقتضي ذلك ذوبان السياسة في العسكر، بل توحيد المسارين على قاعدة التفريق بين الأدوار فالسياسة تُحدّد الغاية باسم عموم المواطنين، والقوةُ المنظَّمة تُؤمّن البيئة التي تُمكّن هذه الغاية من السير في مؤسساتٍ لا في شعارات.
حين يُعاد وصل ما انقطع بين الشرعية والقوة “فتغدو الأولى مُنتجةً للثانية ومُقيّدةً لها” عندها فقط تستعيد العقلانية مكانها الطبيعي، لا لأنها نجحت في إسكات البنادق، بل لأن البنادق تعلّمت موقعها المتمثل خدمة النقاش لا مصادرته.
عندها يُصبح الأمن حليفاً للحرية لا خصماً لها، ويعود القانون تعبيراً عن المصلحة العامة لا قناعاً لهيمنة خاصة، وتستعيد الدولة تعريفها البسيط الذي لا يُخطئ “إطارٌ حيادي يضمن الحق ويحدّ القوّة.”
إنّ وحدة التيارات الديمقراطية والليبرالية والمدنية ليست مطلباً تنظيمياً فحسب؛ إنها شرطٌ لغويٌّ ومعنويٌّ لاستعادة القدرة على التعريف.
فمن دون سرديةٍ مشتركة تُخاطب الخوف بقدر ما تُخاطب العقل، سيظلّ جمهورٌ واسع يَميل إلى “حارسٍ صارم” بدل “قانونٍ عام”، لا لأنّه يعادي الحرية، بل لأنّه لم يعشها إلا بوصفها فوضى.
ووحدةُ المسارات هنا تعني:
أولاً الاعتراف بأن الاستبداد والتطرّف وجهان لمعادلةٍ واحدة لأن كلاهما يختطف الدولة ويحتكر المعنى
وتعني ثانياً استعادة البداهة التي جرى التلاعب بها وهي أنه لا أمن بلا قانون، ولا قانون بلا مساواة، ولا مساواة بلا دولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
قد يُقال إن هذا الكلام مثالي في زمن السلاح. غير أنّ الواقعية الحقيقية اليوم هي التي تُعيد تعريف القوّة داخل القانون، لا التي تُعيد تدويرها خارجَه.
فكل سلطةٍ تعجز عن تحويل قوّتها إلى شرعيةٍ قابلةٍ للمساءلة ستحتاج إلى مزيدٍ من العنف كلما تراجع رصيدها الرمزي، وهذا طريقٌ قصيرٌ إلى فوضى أطول.
أمّا حين تُصبح “قوّة الشرعية” أقوى من “شرعية القوّة”، تتراجع الحاجة إلى التلويح بالسلاح لأن العقد الاجتماعي نفسه “بمؤسساته وقواعده ورقاباته” يصير هو الضامن الأوثق للأمن.
هناك فقط يمكن للسياسة أن تُنقذ ما حاولت الغلبةُ مصادرته، ويمكن لسوريا أن تخرج من زمن الطوارئ إلى زمن الدولة..
دولة المواطنين لا الرعايا، حيث تتوحّد اللغةُ والمعنى والبندقية حول قاعدة واحدة بسيطة وعادلة تتمثل في قوّةٌ عامّة تحرس قانوناً عاماً.