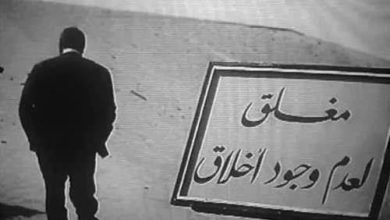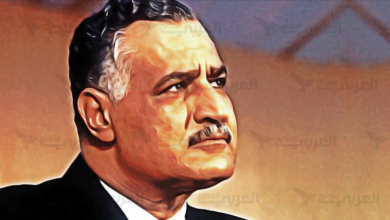التفاوض، سياسياً أو اقتصادياً أو في أي حقل كان، هو بطبيعته عملية براغماتية. الهدف منها الوصول إلى حلول وسط بين أطراف تختلف مصالحها أو رؤاها في أغلب الأحوال. وفي هذا الإطار، يبدو أن المبادئ الأخلاقية قد تكون عائقاً أو رفاهية زائدة، خصوصاً في الحقل السياسي. مع ذلك، من الصعب فصل السياسة عن الأخلاق بشكل قطعي على الرغم من كل المساعي. خصوصاً حين تتعامل السياسة مع قضايا تتعلق بالعدالة، وبالحقوق، وبالكرامة الإنسانية. في كل هذه القضايا هناك جوهر أخلاقي أساسي. فأي عمل تفاوضي سياسي، إنْ افتقر إلى أسس أخلاقية، يفقد مصداقيته أمام الشعوب. فحتى لو نجح مرحلياً، عبر تحشيد إعلامي وسياسي معين، مستغلاً حاجة وقتية أو ظرفاً إنسانيا طارئاً، إلا أنه مهدد حتماً بالانهيار من خلال فقدانه للشرعية الأخلاقية.
اليوم، المدرسة الواقعية السياسية تهيمن على سواها من المدارس. فلها منظرون ولها كتب ولها نظريات. أما المدرسة الأخلاقية والتي تستند إلى قانون دولي أو مواثيق مجمع عليها، فغالباً ما تنحصر في المواقف الفردية، أو حتى المجمع عليها، دونما إطار ناظم معتمد. من الأكيد أن هناك ظروفاً قد تدفع بالسياسي إلى تقديم بعض التنازلات الصعبة. قد تشكل هذه التنازلات نوعاً من انتهاك القيم المثالية والأخلاقية. تبريرها ممكن من خلال اعتبارها تسعى إلى تحقيق تقدم معين في مجال محدد، وصولاً إلى تحقيق المصلحة العليا. وبالمحصلة، التفاوض السياسي سيفشل إن هو تخلى عن كل الركائز الأخلاقية التي يمكن أن تضبطه. هذا في المبدأ، ولكن علمتنا الأحداث والوقائع بأنه في الممارسة الواقعية تطغى البراغماتية على الأخلاق ويؤدي هذا غالباً إلى أزمة فقدان ثقة أو إلى تشكيل شرعية مشكوك فيها.
في مؤتمر ويستفاليا 1648، والذي أعلن نهاية الحروب الدينية في أوروبا، مؤسساً اللبنة الرئيسية للعلاقات الدولية، والذي أتى بعد عقود من الحرب الدموية بين أتباع الكاثوليكية والبروتستانتية في أوروبا، تفاوض الطرفان المتحاربان، حين شعرا بالإرهاق وبالعبثية الناجمين عن هذه الحرب. وقد هيمنت الرغبة في إنهاء الصراع على المفاوضات. فسعى الطرفان إلى محاولة وقف الحرب بأي ثمن. فهنا كانت البراغماتية. وتم تجاهل المبادئ الأخلاقية التي تنص على ضرورة إنهاء القمع الديني وحق الشعوب في اختيار دينها بحرية.
تم التوصل في هذا المؤتمر إلى أن لكل أمير الحق في تحديد الدين المتبع في إمارته. أي أن مبدأ سيادة الدولة قد طبق. ولقد أنهى هذا القرار الحرب بشكل عملي. لكنه افتقد للبعد الأخلاقي الكامل لأنه ترك الأقليات الدينية من دون حماية في بعض المناطق. ولم يكن هذا عائقاً في أن يستمر السلام فترة طويلة مؤسساً لمفهوم السيادة الحديثة للدول. في حين لم تكن العدالة الكاملة لكل فرد مصانة. خصوصاً أنه جرى تقديم مبدأ استقرار الدول على مفهوم الحفاظ على حقوق الأقليات في الدول. وبالنتيجة فإن هذا الأسلوب من التفاوض السياسي احترم بعض المبادئ الأخلاقية، كالسعي لتحقيق السلام واحترام حق تقرير المصير. لكن الواقعية السياسية تغلبت على الكمال الأخلاقي التام.
في المسألة الفلسطينية، أعتقد بعض القادة، إثر بدء المحادثات السرية بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل في أوسلو أوائل تسعينيات القرن الماضي، أنهم ينطلقون من قاعدة صلبة تستند إلى حقوق أخلاقية في السعي لإنهاء عقود من الصراع، وإيجاد حل يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. الجانب الأخلاقي في هذا الملف يعتمد على ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير المصير واسترجاع حقوقهم المغتصبة منذ 1967 على أقل تقدير. ومن ثم، إقامة دولتهم المستقلة.
وكان الظن بأن اعترافاً متبادلاً بين منظمة التحرير وإسرائيل كان هو الخطوة الضرورية لكل منهما نحو احترام وجود الآخر والانتهاء من التبادلية في نفي شرعية كل طرف. كان الطموح المزيف هو تحقيق سلام عادل يستند إلى إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الأساسية. ومن خلال التوجه التخاذلي الذي اعتمده بعض القائمين على هذا الملف من الجانب الفلسطيني مسمين إياه بالبراغماتية، فقد تم تأجيل قضايا أساسية تتعلق بمصير القدس وملف اللاجئين ووضع المستوطنات والحدود النهائية للدولة. وأنشأ الاتفاق سلطة محلية انتقالية عديمة الصلاحية تقارب العمل البلدي من دون أي انهاء للاحتلال الإسرائيلي وتوسع استيطانه. وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين على الأمل الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة بابتسامة ساخرة أمام وفد فرنسي رفيع المستوى، محدداً القول بأنهم “يحلمون”.
لقد منح التاريخ فرصاً عديدة ودروساً متعددة لمن يقرأه ويتعلم منه. فلو بدا لبعض القادة حديثي العهد، بأن الواقعية السياسية المطلقة والعمياء ستصون دولتهم وتحميها من عواقب الضعف العسكري الناجم عن مساوئ نظام مستبد بائد، كما أنها ممكن ان تساعد دولتهم الحديثة على تخطي الأزمة الاقتصادية البنيوية التي أسس لها نظام الفساد المنهجي الزائل من دون رجعة، وتدفع بهم، تالياً، إلى تهميش الرادع الأخلاقي في ما يظنون بأنها مفاوضات يمكن أن تفضي إلى سلام نسبي، يرضي القوى العظمى المهيمنة ويدفعها إلى تسهيل عمل الدولة الجديدة في إعادة البناء المادي والمعنوي، في سوريا مثلاً.. فإن هذه الحسابات والتوقعات غالباً ما ستؤدي إلى الوقوع في خيبة أخلاقية وشرعية وقانونية وإنسانية، وحتى واقعية.
المصدر: المدن