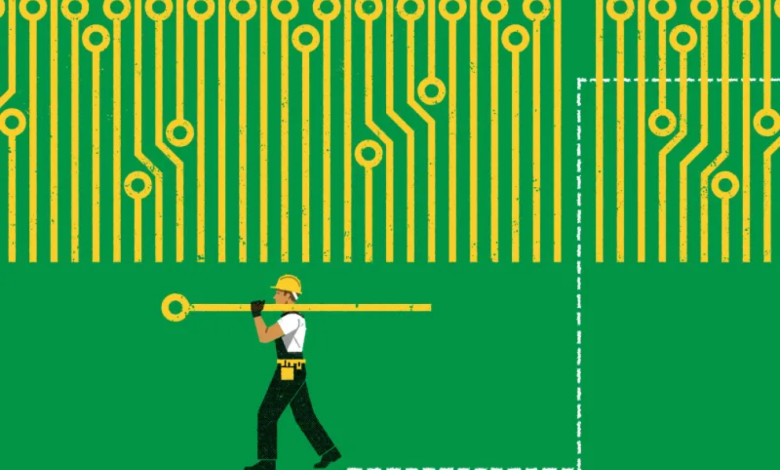
نعيش في عصر تكنولوجي، أو هذا ما قيل لنا. والآلات تعد بإحداث تحولات في كل مناحي الحياة البشرية: فالروبوتات ستقوم بالوظائف في المصانع، وستعم السيارات الذاتية القيادة الطرقات، والذكاء الاصطناعي سيتحكم بأنظمة الأسلحة.
ويعتري السياسيون والمحللون القلق من العواقب المترتبة على هذه التطورات. فهم يخشون الضرر الذي سيلحق بالصناعات والأفراد على حد سواء. وعلى الحكومات، كما يقول هؤلاء، أن تسهم في إدارة التكاليف التي يتسبب بها هذا التقدم.
وغالباً ما تتعامل هذه النقاشات مع التغيير التكنولوجي على أنه أمر لا بد من التكيف معه، كما لو أنه قوى من قوى الطبيعة، وتملي، بلا هوادة، إلى اتفاقات وافتراضات راسخة في الحياة الحديثة. وهكذا، يبدو أن وتيرة التغيير عصية على السيطرة. وأن التقنيات الجديدة ستعيد تشكيل المجتمعات لا محالة. وجل ما يسع الناس فعله هو سلوك أفضل السبل إلى التأقلم.
ولا تتجلى هذه على أوضح صورة فوق تجليها في نقاش الأتمتة وتأثيرها في الوظائف. وعلق متجر البقالة المحلي الذي أقصده، في ريف ولاية يوتا الأميركية، من غير قصد السخرية، لافتة تعلن دعم الشركة العمال الأميركيين في مقابل آلة (خدمة) التسديد الذاتي، علماً أن هذا الجهاز يتوسل بالتكنولوجيا إلى الاستعاضة عن عمل الموظف بعمل الزبون الذي يتولى بنفسه معالجة عمليات الشراء [بديلاً لأمين الصندوق].
ودبجت كتابات كثيرة في شرح تهديد الأتمتة وظائف بعض العمال من ذوي المهارات المتدنية، وفي التدابير التي لا بد من أن تتخذها الحكومات بغرض تقديم المساعدة في هذا الشأن: مثلاً، يمكن للبلدان أن تدعم مبادرات التدريب المتجدد، أو تحديث أنظمة التعليم، أو الاستثمار في مخططات توزيع الثروات.
وفي الوقت نفسه، تأمل حكومات كثيرة في أن تتمكن الآلات من إنقاذ اقتصاداتها من عواقب التقلص السكاني وشيخوخة السكان. ويقول المتفائلون بالتكنولوجيا إن الولايات المتحدة، ودولاً غنية أخرى، في حاجة إلى الأتمتة كي تعوض عن تناقص عدد السكان في سن العمل، والفجوات الوشيكة في القوى العاملة. وينوهون إلى أن تقدم التكنولوجيا يلغي المشكلات الديموغرافية.
وفاتت السجالات والنقاشات مسألة في غاية البساطة. ومهما بدا التغيير التكنولوجي مزلزلاً ربما، فهو من صنع البشر، وليس قوة طبيعية. ولا ريب في أن التكنولوجيا قد أدخلت تحسينات جذرية على حياة البشر: فلا يود أحد أن يعيش من دون كهرباء أو مراحيض حديثة أو تدفئة مركزية (في ولاية يوتا). ومع ذلك، فإن المجتمعات تحتاج، في بعض الأحوال، إلى سياسات جديدة وليس إلى تكنولوجيات جديدة.
وعلى الأغلب، تتولى الأتمتة حل مشكلة. وهذا خيار ارتآه الناس وليس قدراً، وليس ضرورة على وجه اليقين. فعلى سبيل المثل، تواجه الولايات المتحدة ندرة في سائقي شاحنات النقل. ووفق تقديرات جمعية نقل الشاحنات الأميركية، كان عدد سائقي شاحنات النقل في 2021 أقل بـ80 ألف سائق من إجمالي العدد المطلوب.
وقياساً على عمر السائقين الحاليين، لا بد من تشغيل أكثر من مليون سائق جديد في العقد المقبل. وبغية الحد من هذا العجز، استثمر كثير من أباطرة التكنولوجيا، من بينهم مؤسس “أمازون” جيف بيزوس، في بحوث المركبات الذاتية القيادة وتطويرها، وعولوا على تقليص هذه التكنولوجيا الطلب على السائقين.
وبحسب بيزوس هذه التكنولوجيا يرتجى منها فائدة في الشركات المالية. فـ “أمازون” تعتمد الشحن المنخفض التكاليف للحفاظ على تدني أسعارها. ولكن هذه التكنولوجيا لا تعود بفائدة اقتصادية أوسع على ملايين الناس، فلا ريب في أن هؤلاء تسعدهم قيادة شاحنات النقل في الولايات المتحدة، وما يرغبون فيه هو السماح لهم بالعمل في البلاد.
ولا مشكلة في العثور على أشخاص يرغبون في العمل كسائقي شاحنات نقل للمسافات الطويلة في الولايات المتحدة في أسواق خارجية، إذ يبلغ متوسط أجره 23 دولاراً في الساعة. وفي بلدان العالم النامي، يتقاضى سائقو شاحنات النقل نحو أربعة دولارات في الساعة.
إلا أنه ليس في مستطاع الشركات توظيف عمال من الخارج، وإن بأجر أعلى، بسبب القيود على الهجرة، فيفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة الآلات على العاملين، ويعوضون فقدان الوظائف باستخدام التكنولوجيا. وإذا هم استقدموا عاملين من مختلف أنحاء العالم، تضاءل دافعهم إلى إلغاء هذه الوظائف واستبدال الناس بالآلات. وما تمليه الحدود الوطنية من وقائع يوجه الشركات نحو الاستثمار في التكنولوجيا التي تعوض النقص موضعياً وليس على مستوى العالم، ولا يحتاج إليها أحد فعلاً.
وما يصح في قيادة شاحنات النقل يسري مثله على صناعات أخرى في العالم الصناعي الغني، تتطلب عمالاً غير محترفين في بيئات عمل محددة. وقدر تقرير صدر عام 2021 عن شركة الخدمات المالية “ميرسر” Mercer، أن الولايات المتحدة ستشكو في 2025، نقصاً بنحو 660 ألف مستخدم في الرعاية الصحية المنزلية، وعامل تقني في المختبر، ومساعد تمريض.
الأتمتة ليست حتمية بل اختياراً
والحق أن الحواجز التي تحول دون الهجرة تفاقم من خلال توجيه الموارد. وفي أكثر الاقتصادات إنتاجية في العالم، تحمل رؤوس أموال قادة الأعمال وطاقاتهم (ناهيك عن وقت العلماء والمهندسين ذوي التعليم العالي وكفاءاتهم) حملاً على تطوير التكنولوجيا التي تؤدي إلى تقليص استخدام واحد من أكثر الموارد وفرة على الكوكب: العمالة. وتعتبر قوة العمل العضلي أهم الأصول (وغالباً الوحيد) التي يمتلكها ذوو الدخل المنخفض في أنحاء العالم كله. والدافع إلى صنع آلات تؤدي وظائف في مقدور الناس إنجازها بسهولة لا يهدر المال وحده، بل يسهم في إبقاء الناس الأشد فقراً معوزين.
ومن وجه آخر، لا شك في مشروعية مخاوف اجتماعية وسياسية تثيرها حركة المهاجرين الاقتصاديين العابرين للحدود. ويتعلق بعض هذه المخاوف بكيفية التعامل مع موجات الهجرة، وتأثيرها في العاملين في الخدمة المنزلية، وتسببها في اضطرابات اجتماعية. ومن حق أصحاب هذا الرأي أن تقلقهم سبل حماية العمال المهاجرين من الاستغلال. ومن منظور الشركات والصناعات، يبدو ابتكار وسيلة تمكن الذكاء الاصطناعي من قيادة الشاحنة أيسر من تقليص القيود البيروقراطية على الهجرة.
لكن إيثار الأجهزة على الأشخاص خطأ. فهو يحرم العالم من المكاسب الاقتصادية والإنسانية الحقيقية التي قد يجنيها من إجازة انتقال البشر إلى حيث تلح الحاجة إليهم، عوض السعي في ابتكار آلات تحل محل البشر. وحظر عبور الحدود الوطنية على المهاجرين الاقتصاديين، ولا سيما من يطلب منهم الانخراط في وظائف لا تتطلب سوى مهارات أولية، (هذا الحظر) يحرف مسار التحول التكنولوجي على نحو يحط بأحوال فقراء العالم، أولاً، وبأحوال البشر عموماً.
صعود نجم الآلات
ويشيع في الغرب رأي يزعم أن دول المجتمعات الثرية في غنى عن استقدام أعداد إضافية من العمال إلى بلدانها. ولو صح هذا الرأي، لوسع الدول إزالة الحواجز لأن التقدم التكنولوجي يقضي على ما يسمى بالوظائف المتدنية المهارات. ولكن المسألة أخطر من ذلك.
فبعض التغيرات التكنولوجية مصدرها التقدم في العلوم الأساسية. وغالباً ما تفترض المناقشات حول مستقبل العمل أن مسار التطور التكنولوجي ونمطه قد تقررا فعلاً، وأن التأثير في الوظائف والعاملين مجرد نتائج طبيعية لتقدم العلم الحتمي. إلا أن الاقتصاديين طوروا فهماً دقيقاً للسبل التي نظم بواسطتها التحول التكنولوجي أسواق العمل والأجور تنظيماً جديداً، وبرهنوا على أن الابتكار نتيجة للأكلاف التي تترتب على الشركات، ليس مجرد سبب، يؤدي إلى تقليصها.
طوال عقود من الزمن، اتسمت المناقشات الاقتصادية والسياسية حول أسواق العمل والتكنولوجيا بالتركيز على انعكاس مهارات العمال في مرآة تحولات الأجور. وعوملت “المهارة” على أنها مرادف لـ”المهارة المعرفية”، واعتبر مستوى التعليم النظامي الرسمي للعامل قياساً تقريبياً للمهارات المعرفية.
وذهب التحليل الطبيعي إلى أن التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساعدت في زيادة دخل العمال ذوي التعليم العالي، فيما أدت إلى تراجع مداخيل العمال الأقل تعليماً وذوي المهارات المتدنية. لكن الواقع لم يكن على ذلك النحو: فعلى رغم ارتفاع أجور ذوي المهارات العالية في الولايات المتحدة منذ عام 1979، مقارنة بأجور الوسط الواسع من أصحاب الدخل المتوسط، ارتفعت الأجور في المهن ذات الأجور المتدنية في العادة كذلك، في الحساب المئوي، أكثر من الأجور في المهن المتوسطة الأجر، وعلى مدد تساوي مدد الأجور المدفوعة في المهن ذات الرواتب العالية.
ويظهر بحث أنجزه الخبيران الاقتصاديان ديفيد أوتور وديفيد دورن وآخرون، أن الطلب على المهن المختلفة الاستجابة للتكنولوجيا لا يتغير بالتوازي مع مهارة العامل، بل يعتمد على طبيعة المهمات التي يتوجب على العامل أن يؤديها. وتشتمل الوظائف في الخدمات، من قبيل إعداد الطعام والتنظيف وأعمال الحراسة والصيانة والمساعدة الصحية الشخصية والأمن، على مهمات يدوية وغير روتينية. ومن الصعب جداً أتمتة كثير من المهمات اليدوية غير الروتينية، أو نقلها إلى خارج البلاد، لأنها تقتضي الوجود المادي المباشر للعامل. وتظل هذه الوظائف مطلوبة، وحافظت أجورها على مستواها حتى في أعقاب التقدم التكنولوجي.
ولا ريب في أن تغيرات ثورية حقاً حصلت في طريقة تواصل الناس بعضهم مع بعض، وفي كيفية بحثهم عن المعلومات، وتنظيم البيانات ومعالجتها، والترفيه عن أنفسهم. ولكن القول إن التطور التكنولوجي السريع الذي شهدته العقود الأخيرة في بعض قطاعات الاقتصاد، أفضى إلى تسريع وتيرة تحول الاقتصاد برمته، يجافي الواقع.
الحق أن نمو الإنتاجية الاقتصادية في البلدان الصناعية ماشى المقياس التقليدي لنمو “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج” (الذي يحتسب الإنتاجية بقسمة إجمالي الإنتاج، أو الناتج، على التكاليف، أو المدخلات) أبطأ كثيراً في العقود الأخيرة مقارنة بما كان عليه بين أوائل القرن الـ20 و1970. وكل الدول المتقدمة تقريباً سجلت تباطؤاً كبيراً في نمو الإنتاجية منذ 1980.
وفي الوقت نفسه، سجل توافر العمال للمهمات اليدوية غير الروتينية تراجعاً واضحاً في البلدان الصناعية الغنية، نتيجة الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة، وارتفاع مستويات التعليم. وعلى نحو مطرد، لا يتناسب عدد الوظائف الشاغرة مع عدد المرشحين المحليين المتاحين لشغل تلك الوظائف.
ويتوقع كتيب التوقعات المهنية الصادر عن “مكتب إحصاءات العمل” (بلس) في الولايات المتحدة أن تشهد الفئات المهنية التي لا تتطلب شهادة جامعية، ويبلغ متوسط دخلها الحالي أقل من 40 ألف دولار، ارتفاعاً صافياً يتخطى خمسة ملايين وظيفة جديدة بين 2021 و2023، أي بزيادة نحو 924 ألف وظيفة في مجال المساعدة الصحية المنزلية والرعاية الشخصية، و419 ألف وظيفة من الطهاة.
إلا أنه وفق التوقعات الديموغرافية لمنظمة “الأمم المتحدة”، فإن عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة في الولايات المتحدة (من دون الأخذ في الاعتبار الهجرة) سينخفض إلى أكثر من ثلاثة ملايين في المدة عينها. ويبدو مستقبل المواطن المولود في العالم الصناعي الغني، على مدى متوسط، واضحاً فعلاً: بحلول أربعينيات القرن الحالي، لن يتوفر على أداء الأعمال غير الروتينية واليدوية، في البلدان المتقدمة، سوى بضعة ملايين من السكان المحليين.
وأفضت زيادة القدرة الحاسوبية التي تجاوزت تريليون ضعف في أثناء القرن الماضي إلى تغير جذري في المهن التي يضطلع فيها الموظفون بمهمات روتينية ومكررة. والنساء الأميركيات من أصول أفريقية اللاتي جعلن الهبوط على سطح القمر ممكناً (واشتهرن في فيلم “هيدن فيغرز”) عملن في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” كما لو أنهن “أجهزة كمبيوتر”، إذ انشغلن بإجراء كثير من العمليات الحسابية التي تنجزها الآلات الآن في لحظات فقط. وانتفى وجود “الحواسيب البشرية” اليوم.
وتتسم الآلات التي تسمى أجهزة كمبيوتر بفاعلية أكثر من البشر في مجال الحوسبة. ولكن زيادة قوة الحوسبة لن تجعل كثيراً من المهمات أكثر ملاءمة لتولي الآلات أداءها. وليست الآلات أفضل من البشر في العناية الشخصية، وليست أكثر مهارة من الطهاة في شغل هذا العمل، ولن تكون بالضرورة أكفأ من السائقين في قيادة شاحنات النقل.
وإذا انتشرت شاحنات النقل الذاتية القيادة، في نهاية المطاف، على الطرقات الأميركية، فلن تكون دليلاً على دوام مسيرة التقدم العلمي من غير توقف. واستخدامها قد يكون قرينة على أمر آخر تماماً: الآثار المترتبة على المعوقات التي تعترض انتقال العمالة، وتخلق حوافز مالية خاصة ضخمة، فتدفع هذه بدورها الأشخاص والشركات القوية إلى توظيف استثمارات هائلة من الموارد البشرية النادرة في الابتكار التكنولوجي، ويستعاض عن الناس بالآلات. وفي نهاية المطاف، تختار الشركات الأميركية الأتمتة لأنها تيسر الحلول للمشكلات التقنية الصعبة، من قبيل المشكلات التي تحاول آلات التسديد الذاتي والمركبات الذاتية القيادة حلها.
مكانة رفيعة
وتترك الوقائع القاسية المتصلة بمكان الميلاد والجنسية والمواطنة تأثيراً عميقاً في صميم حياة الناس. فمكان ولادة الناس، والبلاد التي في وسعهم السفر إليها والتنقل فيها، تحدد بصورة حاسمة مداخيلهم على مدار حياتهم. ويؤدي انتقال الناس عبر الحدود إلى فوارق كبيرة في الأجور بين العمال المتساوين في الإنتاجية.
وفي بحث تعاونت على إعداده مع باحثين مشاركين، تناولنا أرباح العمال المولودين والمتعلمين في 42 دولة مختلفة. وعقدنا مقارنة بين المكاسب التي حصل عليها أشخاص بقوا في بلدانهم الأصلية، وتلك التي جناها أشخاص اشتغلوا في الولايات المتحدة. ثم أجرينا تعديلات على تلك الأرباح كي تتناسب مع فروق في أسعار السلع والخدمات بين البلدان مراعاة للتفاوت في القوة الشرائية. وتراوح الفرق في الأجور بين العاملين المتساوين في الإنتاجية، في 42 بلداً المشمولة في الدراسة وبين الولايات المتحدة من ضعفين إلى عشرة أضعاف، ومتوسط يبلغ أربعة أضعاف. وتبرز هذه المعدلات في مختلف المهن (بما في ذلك الخدمة التي يقدمها النوادل في المطاعم وقيادة شاحنات النقل)، وفي المؤهلات العلمية والمهارات المختلفة.
وهذه الفجوة بين أجور العمال المتساوين في الإنتاجية، في مختلف البلاد، صورة عن تشوه الأسعار الناجم عن السياسات في العالم اليوم (وربما في تاريخ البشرية برمته). وتخلق المعوقات من دون الهجرة نقصاً مفتعلاً في العمالة. وتواجه صناعات غير قليلة في الولايات المتحدة عسراً في العثور على عمال بأجور معقولة. ويدعو هذا العجز الشركات إلى البحث عن حلول من طريق الأتمتة والتكنولوجيات الأخرى غير الضرورية وغير الفاعلة.
وتظهر التجربة أن السماح بدخول مزيد من العمال إلى بلد ما يحدث تحولاً في أنماط الابتكار. وسبق أن خاضت الولايات المتحدة هذه التجربة، إنما في اتجاه معاكس. ففي منتصف القرن الـ20، سمحت الولايات المتحدة بالهجرة الموسمية للعاملين في الزراعة والوافدين إليها من المكسيك تحت مسمى “برنامج براسيرو”.
وفي آخر المطاف، أبطأت الحكومة تنفيذ البرنامج إلى أن أوقفته تماماً في 1964. وقارن الباحثون بين أنماط التوظيف والإنتاج في الولايات التي فقدت عمال “براسيرو”، والولايات التي لم تستقدم عمالاً أبداً. فوجدوا أن تعليق استقدام هؤلاء العمال لم يؤد إلى زيادة في توظيف العمال المحليين في القطاع الزراعي، على الإطلاق.
عوض ذلك، رد المزارعون على نقص العمال الناشئ باعتماد متعاظم على الآلات والتقدم التكنولوجي. فعلى سبيل المثل، تحولوا إلى زراعة نباتات معدلة وراثياً تتولى الآلات قطافها، مثل الطماطم السميكة القشرة، وتخلوا عن زراعة محاصيل مثل الهليون والفراولة، جراء ضيق خيارات حصادها آلياً.
وقد تكون الضرورة أم الاختراع، ولكن الضرورة الزائفة أم الاختراعات الغبية. وأدى حظر الولايات المتحدة المشروبات الروحية، في أوائل القرن العشرين إلى منع استيرادها، وإنتاجها، ونقلها، وبيعها في الولايات المتحدة.
وعادت تلك القيود بالخير العميم على منتجي خمور “مون شاين” moonshine غير القانونية [سميت “مون شاين” (سطوع القمر) لأنها كانت تحضر خلال الليل بعيداً من الأعين]، مع تعاظم الطلب على الخمر. واحتاجوا إلى شحن منتجهم إلى المتعطشين إلى الخمر. ولم يكن إخفاء القناني في الأحذية boots (أصل مصطلح bootlegger، مهرب البضائع، بالإنجليزية) لم يكن كافياً.
وفي سبيل نقل كمية أكبر من “مون شاين”، طور المهربون “آلات تهريب مون شاين”: وهي مركبات يمكنها بسرعة نقل شحنات ثقيلة من “مون شاين” خفية. ويقتضي تطوير “آلات تهريب مون شاين” براعة تكنولوجية وابتكاراً، لكنها لا تزال تعتبر اختراعاً غبياً. ولم يؤد حظر عملية اقتصادية عادية تماماً، هي شراء الكحول، إلى تطوير شاحنات خمور أكثر كفاءة، بل إلى ابتكار شاحنة تبدو مركبة عادية تماماً، وكان هذا تبديداً للوقت والموهبة.
المسار الأسهل
يصر أنصار معوقات انتقال البشر والهجرة على ضرورة حماية لأجور المواطنين، ولكنهم على خطأ. ففي بعض أوقات القرن الماضي، اعترى الحكومات شعور بالقلق جراء عجز بلادها على توفير وظائف كافية لمواطنيها. ولكن التركيب السكاني المتغير للعالم الصناعي الغني قلب هذا المنطق رأساً على عقب.
وفي المستقبل المنظور، يكون التحدي هو توافر عدد العمال الذي يملأ الوظائف المتاحة. وحتى البلدان التي لم ترحب تقليدياً بالمهاجرين، مثل اليابان، تحرص اليوم على توظيف عمال أجانب. وتخطو الدولة هذه الخطوة وهي تدرك أن المهاجرين لا يؤثرون سلباً بالضرورة في أجور المواطنين.
وخلصت مراجعة صدرت عن “الأكاديمية الوطنية للعلوم”، عام 2017، إلى أن التأثير الصافي للهجرة في متوسط أجور العاملين في الخدمة المنزلية في الولايات المتحدة كان إما صفراً أو إيجابياً بعض الشيء، على الأرجح.
ومن الناحية الاقتصادية، ليس المهاجرون بدائل للعامل الأميركي العادي، بل إنهم يسدون النقص في مجال عملهم، ولذا فإن مجيء عدد أكبر من المهاجرين يرفع متوسط أجر المواطنين. وتوافر مزيد من الأيدي العاملة المساعدة، مثلاً، لا يتسبب في خفض أجور العمال المهرة، كالممرضين والممرضات، بل هو يرفعها، وذلك من طريق توفير مزيد من الوقت لأداء أعمال تحتاج إلى مهاراتهم الفريدة.
وقد تنشأ بطبيعة الحال منافسة على الوظائف بين بعض العمال الأميركيين، من فئات المجتمع المعوزة، وبين المهاجرين. ولكن القيود المفروضة على الهجرة ليست وسيلة فاعلة أو مجدية لمساعدة العمال المحليين. وبرامج، مثل الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب، وسيلة نافعة في دعم أجور العاملين في الخدمة المنزلية. وقمت بعمليات حسابية كشفت عن أنه، حتى في ضوء أكثر الافتراضات تشاؤماً حول التأثير السلبي الذي يؤثره المهاجرون في أجور العمال المحليين المعوزين، يقتصر المطلوب على زيادة متواضعة في الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب للتعويض عن هذه الخسائر، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالخسارة الاقتصادية التي تنجم عن حظر انتقال المهاجرين.
وتبقى الخسارة الاقتصادية الأكبر الناجمة عن القيود التي تفرضها البلدان الغنية على انتقال العمالة، من نصيب فقراء العالم. وعقود برامج التنمية الصادقة، ومبادرات المعونة، لا توازي الفائدة التي تنجم عن السماح لشخص واحد، في بلد فقير، بالعمل في بلد أكثر ثراء وإنتاجية. إذا أراد مواطنو الدول الغنية مد يد المساعدة لفقراء العالم، فعليهم أن يفهموا أن مشاريع التنمية ذات القيمة، وبرامج مكافحة الفقر، والمساعدات الخارجية للدول الفقيرة، يبقى تأثيرها كلها ضئيلاً، وعديم الأهمية، مقارنة بفوائد الاقتصار على فتح الحدود أمام العاملين للانتقال إلى البلدان الغنية التي تحتاج إليهم، والعمل في مقابل أجر مستدام تبرره إنتاجيتهم.
وعلى سبيل المثل، تناولت ورقة بحثية، استشهد بها على نطاق واسع عام 2015، ونشرت في مجلة “ساينس” العلمية، الآثار التي ترتبت على أحد برامج مكافحة الفقر قضى بنقل الماشية عبر ستة بلدان فقيرة، على أمل زيادة دخل الأسر التي تكابد عوزاً مزمناً.
وأنفق البرنامج أربعة آلاف و545 دولاراً لكل أسرة في السنتين الأوليين منه. وفي السنة الثالثة، كان الاستهلاك المنزلي السنوي أعلى بـ344 دولاراً فقط، في المتوسط، في خمسة من البلدان الستة التي أدى فيها البرنامج إلى نتائج إيجابية – إثيوبيا وغانا والهند وباكستان وبيرو. (في هندوراس، نفقت جميع الماشية تقريباً). ولما كانت بعض محاولات خاضتها مشاريع شبيهة بهدف زيادة دخل الفقراء انتهت بالفشل، اعتبر الباحثون هذه الزيادة المتواضعة في الاستهلاك المنزلي السنوي، البالغة 344 دولاراً أميركياً من طريق إنفاق أربعة آلاف و545 دولاراً أميركياً، نجاحاً كبيراً.
وفي المقابل، يدل بحثي على أن العمال غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يجنون، في المتوسط، ما يصل سنوياً إلى 13 ألفاً و119 دولاراً في الولايات المتحدة أكثر من نظرائهم في الدول الخمس التي شملتها الدراسة. حتى لو أن عشرة في المئة من الفوارق في الأجور أنفقت على تكاليف التنقل جيئة وذهاباً طوال عام من الزمن، سيؤدي السماح لنفس العمال المحدودي المهارات بمزاولة العمل في الولايات المتحدة، بدلاً من إرسالهم إلى وطنهم، إلى زيادة الدخل بمعدل 35 مرة أكثر من نتيجة يحققها برنامج فاعل وجيد التصميم والتنفيذ لمكافحة الفقر.
وليست ظاهرة الفقر العالمي اليوم عبارة عن “فقراء”، فهؤلاء أناس محاصرون في “أماكن فقيرة”، وعاجزون عن شد الرحيل بعيداً منها بسبب حواجز تقيد حركتهم. وتقول الصورة الكاريكاتورية الساخرة عن الفقر أن الناس فقراء لأنهم يفتقرون إلى “رأس المال البشري”.
والحقيقة هي أن التوسع الهائل في التعليم، في العالم النامي، منذ خمسينيات القرن الـ20، أدى إلى حصول متوسط البالغين في هايتي، اليوم، على مستوى تعليم أعلى من المستوى الذي حصله متوسط البالغين في فرنسا عام 1970. ولكن هايتي بلد تعمه الفوضى، ومنخفض الإنتاجية، بما يحول دون استخدام أي صنف من رأس المال، بما في ذلك رأس المال البشري.
بالتالي، فإن معظم سكان هايتي الذين أفلتوا من الفقر وسعهم ذلك بمغادرة بلادهم. وقد يتخوف بعضهم من “هجرة الأدمغة”، وهي فكرة زائفة تزعم أن الدولة الفقيرة إذا هجرها أفضل عقولها وألمعها، تردت إلى دولة معوزة. وقد يكون السبب في جاذبية فكرة “هجرة الأدمغة” هذه brain drain أن الكلمتين بالإنجليزية drainوbrain قافيتهما واحدة. ولم يتوافر دليل واحد على أن الهجرة، ألحقت أي ضرر في مستقبل البلاد. وكثير من أغنى دول العالم اليوم، من بينها الدنمارك وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد، استقبلت بعضاً من أعلى معدلات الهجرة في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20.
والفروق في الأجور تبعث رغبة عميقة في اجتياز الحدود الوطنية. وبين 2015 و2017، سألت مؤسسة “غالوب” الناس في مختلف أنحاء العالم عما إذا كانوا سينتقلون بشكل دائم إلى بلد آخر إذا أمكنهم ذلك، وإذا حصل ذلك فأية دولة سيختارون الانتقال إليها. وفي ضوء الأجوبة يمكن للمرء أن يقدر أن نحو 750 مليون شخص يؤثرون مغادرة بلدانهم الأصلية على نحو دائم، إذا استطاعوا (بل إن أعداداً أخرى مستعدة للانتقال إلى بلاد أخرى موقتاً). بناء على الاستطلاع، يرغب 158 مليون مهاجر إضافي في القدوم إلى الولايات المتحدة، وينوي التوجه إلى أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حوالى 30 مليون مهاجر إضافي. ولا يعني ذلك أن على هذه البلدان أن تستوعب، أو تستقبل أعداداً كثيرة من المهاجرين، بل هو يدل على كفاية أعداد الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى البلدان الغنية والعمل فيها.
والقيود المفروضة على الانتقال، وتتسبب في نقص العمالة في البلدان الغنية، تكرس الفقر في أوساط ملايين الأشخاص الراغبين في العمل المنتج، والقادرين عليه، ويمنعون منه. ويحمل النقص الشركات على الإسراف في الاستثمار في تكنولوجيا لا حاجة إليها. وفي عبارة أخرى، ليست الأتمتة قدراً لا مفر منه، بل الباعث عليها هو نقص العمالة المفتعل. وتفضل الشركات الآلات على الأشخاص، وحافزها مالي. ومن دونه، ترجح الشركات والأسر خيارات مختلفة.
ولا يحلو للشركة الأميركية “وول مارت” أن تتولى بنفسك تخليص مشترياتك بواسطة أجهزة التسديد الذاتي لأنها تظن أن لديك رغبة دائمة في العمل في الشركة، بل لأنها لا تعثر على العمال الذين تحتاج إليهم ويتقاضون أجوراً معقولة. ويمكن للأسر أيضاً اتخاذ قرارات مختلفة تفيد جميع المعنيين.
ويظهر بحث في سنغافورة أن النساء ذوات المهارات العالية يعمدن إلى دخول سوق العمل عندما يفسح مجال أداء المهمات المنزلية في وجه العاملين في رعاية الأشخاص. ويتيح توافر المساعدين المنزليين بقاء المسنين خارج الرعاية المؤسسية مدداً أطول، ويحسن نوعية الحياة بكلفة أقل كثيراً.
أبواب في الجدران
ولن تكون معرفة كيف يمكن للبلدان أن تدرك إمكانات العمالة المتاحة في العالم، أمراً يسيراً. وقد تحتاج منظمات التعاون العالمي البارزة، وعلى الأخص المؤسسات التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، مثل “الأمم المتحدة”، و”صندوق النقد الدولي”، و”البنك الدولي” – إلى عولمة أسواق السلع ورؤوس الأموال. ولكنها لم تنشئ بنية أساسية مجدية لدعم انتقال العمالة وتعزيزها. وخلافاً للبشر، تدفقت الأموال، وحاويات الشحن البحرية، عبر الحدود.
واليوم، تقيد كل دولة على حدة دخول الرعايا الأجانب. وعلى خلاف كلام حزب اليمين السطحي الذي يقول إن الولايات المتحدة تبقي “حدودها مفتوحة”، أو مزاعم مشكوك فيها شبهة بأن العالم “مسطح”، أغلقت جميع الدول الغنية حدودها على شاكلة الحصون، وأوجبت عتبة دخول قانونية عالية، غالباً ما تتعذر تلبية شروطها. وتفرض الدول هذه القيود من طريق كلفة باهظة ونتائج متباينة. وفي 2022، خصصت الولايات المتحدة 26 مليار دولار على حماية حدودها، علماً أن هذا الرقم يفوق الموازنة التي صرفتها، في معظم السنوات، على “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.
وعوض صرف الموارد إلى السعي المستحيل في تكنولوجيا تقضي على وظائف يتولاها البشر، الأجدر بالدول أن تواصل جهودها في سبيل تحقيق تعاون دولي ينظم انتقال اليد العاملة. والحق أن المكاسب المحتملة للبلدان التي يهاجر منها الناس، ومكاسب المهاجرين أنفسهم، والبلدان التي تستقبلهم، تبدو هائلة. وعلى الدول الغنية أن تسمح لمزيد من الناس بالعيش والعمل فيها، ليس بدافع الإيثار [تفضيل الغير على النفس] بل بمنطق الضرورة الديمغرافية المتعاظمة.
والحل في إنشاء إوالية عالمية تتولى تنظيم انتقال اليد العاملة. والأجدر بها أن تختار توظيف العمال بشكل عادل من دون أكلاف باهظة، وبناء على معلومات وعقود موثوقة. وعليها أن توجههم إلى وظائف تتناسب مع قدراتهم، وتحميهم من سوء المعاملة أثناء وجودهم بعيداً من بلدانهم الأصلية، وتسهيل عملهم في إطار اتفاقات انتقال لأجل، والعودة إلى الوطن بشكل منظم.
وتتطلب موجات الهجرة الاقتصادية الكبيرة قطاعاً يتولى مهمات التوظيف والتدريب وتحديد المستوى والحماية والعودة إلى الوطن. ولا يتوقع من قطاع النقل بالشاحنات، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الضيافة أن تشرف على انتقال العمال بين الدول أو أن تلبي حاجات الانتقال. وبدلاً من ذلك، يجب أن تتولى مهمة نقل الناس مجموعة من المنظمات والأفراد المتصلة عالمياً، والمرتبطة شبكياً. ومن الضروري، طبعاً، تنظيم هذا القطاع ومراقبته بعناية، فمخاطر إساءة استعماله فادحة. ولكن يسع قطاعاً عالمياً أخلاقياً يعمل بكفاءة، وينقل العمال، أن يشكل قوة هائلة تخدم الخير إذا هو جمع بين الأشخاص الساعين إلى الوظائف وبين الشركات التي تحتاج إليهم.
وتتعاون المنظمات العالمية فعلاً مع الصناعة والحكومات من أجل الحصول على نتائج إيجابية لحركة انتقال الأشخاص والسلع. وأدعو القارئ إلى قراءة المقالة قليلاً والنظر من حوله، فيرى سلعاً ومواد انتقلت حول العالم كجزء من 11 مليار طن من الشحن البحري سنوياً. إذا كنت تقرأ بواسطة الإنترنت، فلا تكلف نفسك عناء النظر هنا أو هناك، ذلك أن جهازك المحمول واحد من تلك السلع لا ريب.
وسافر أكثر من 4.5 مليار راكب على خطوط الطيران حول العالم في 2019، وسجلت 283 حالة وفاة فقط (علماً أن ولاية يوتا حيث أعيش، وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، شهدت وحدها 320 حالة وفاة مرورية في عام 2022). وساندت الحكومات، والمؤسسات الدولية، والمجموعات الصناعية، السفر الآمن على متن خطوط شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم. وفي 2018، سافر 1.4 مليار سائح، بدعم من مجموعة متنوعة من الصناعات والجمعيات الصناعية التي تعمل على تسهيل هذه الحركة الهائلة للأشخاص بأمان وموثوقية.
وتعوق حواجز سياسية حركة انتقال البشر المنظمة عبر الحدود من أجل العمل. وتبدو البلدان عالقة في حال متناقضة لا يسع الفرد الخلاص منها بسبب الشروط المتناقضة، أو ما يسمى “كاتش 22”. ولا يسن السياسيون قوانين وسياسات ولوائح تنظيمية تسمح لبرامج تنقل العمالة بالازدهار، قبل ضمان أمن هذه البرامج وفاعليتها وجدواها. ولكن الفروق بين الأجور في البلدان الغنية والفقيرة، والطلب الثابت على العمال، يعني أن انتقال الناس لا راد له، ولكن من دون إذن قانوني، وبتواطؤ من أصحاب العمل. وهذه الحركة غير آمنة على الدوام، ويقع المهاجرون ضحية الاستغلال وإساءة المعاملة، ولا يمكنهم العودة بسهولة إلى ديارهم. وعليه، تلابس انتقال اليد العاملة أفكار مشوشة.
وقد يبدو الأمر متناقضاً، ولكن عيوب انتقال اليد العاملة في الوقت الحاضر قد تؤدي إلى مزيد من الحركة، ومن طريق قنوات قانونية ومحكمة. وتسهيل انتقال الناس إلى حيث مصدر رزقهم يعود بالنفع على الأطراف المعنية كافة. وحري بالمجتمعات الغنية والديمقراطية أن تتوقف عن السعي الأعمى في التقدم التكنولوجي الذي يقتصد في العنصر المتوافر في أنحاء العالم. والبلدان الغنية طورت حوافز قوية حملت الشركات والمبتكرين على إيثار الآلات على الناس. لكن الوقت حان للمراهنة على مستقبل يبنيه الناس من أجل الناس.
*لانت بريتشيت مدير أبحاث في منظمة Labor Mobility Partnerships، ومدير بحوث في برنامج “رايس” RISE [برنامج البحث في تحسين نظم التعليم] في كلية بلافاتنيك للتنمية في “جامعة أكسفورد”، وخبير اقتصادي سابق في “البنك الدولي”.
مترجم من فورين أفيرز، مارس (آذار) / أبريل (نيسان) 2023
المصدر: اندبندنت عربية







