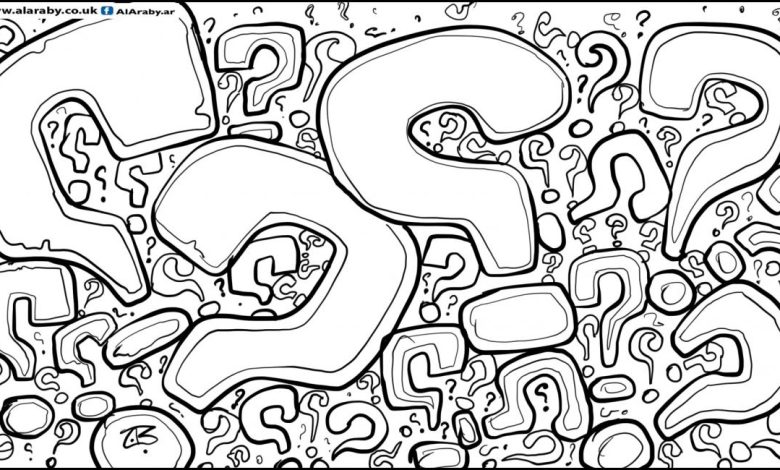
لم يعد استهداف إسرائيل مواقعَ ومقرّات عسكرية وأمنية تابعة لإيران ومليشياتها في سورية أمراً يوصف بأنه “تصعيد”، ولا هو بالتطوّر الخطير على الساحة السورية، حتى وإن كان مسرحه قلب العاصمة دمشق، فالمسألة باتت شبه روتينية، في إطار سياسة إسرائيلية واضحة في تعاملها مع طبيعة الوجود الإيراني المتنامي في سورية، والنظام السوري ليس المستهدَف فعلياً، وإن وجدها في كلّ مرة مناسبةً لاجترار ادّعاءاته بشأن “المقاومة والصمود” و”المؤامرة الكونية”.
منذ بداية تدخّل إيران المليشياوي، ثمّ النظامي، لدعم سلطة الأسد في مواجهة الثورة السورية، لم تكن إسرائيل ضدّه من حيث المبدأ، ولم يُزعجها أن تكون إيران فاعلاً من بين فاعلين آخرين في المشهد السوري، ضمن فوضى أمنية محصورة داخل الحدود السورية. لكن مع مرور الوقت، ووضوح الجهود الإيرانية المستمرّة لتعزيز القدرات العسكرية في سورية، كمّاً ونوعاً، والسعي إلى جعلها قاعدة مركزية في إطار استراتيجيّة إيران التوسّعية في المنطقة، وجد الإسرائيليون أنّ عليهم كبح جماح التمدّد الإيراني. من الناحية العملية، لن تؤدّي الرسائل الإسرائيلية النارية المتكررة لإيران، عبر صندوق البريد السوري، إلى طرد الأخيرة من سورية، فهذا ليس هدف الغارات أصلاً. أقصى ما في الأمر تحجيم الوجود الإيراني في سورية ضمن مستوياتٍ يمكن ضبطها، والحدّ من تهريب أسلحةٍ متطوّرة إلى حزب الله في لبنان.
ثمّة توازناتٌ وتفاهماتٌ ضمنية، استقرّ عليها شكل الصراع بين طهران وتل أبيب، وهو صراع فيه من الضجيج الأيديولوجي والتهويل الدعائي أكثر بكثير من حقيقته الواقعية. وكثيراً ما يجد فيه حكّام البلدين مخرجاً من أزماتهم السياسية في الداخل، فيعمدان إلى التراشق الإعلامي، وحتى الصاروخي في بعض الأحيان، بغرض شدّ انتباه الجمهور إلى خطر خارجيّ مزعوم، في مؤشّر على دور وظيفي لهذا العداء المزمن. يمكن قول الشيء نفسه عن علاقات الولايات المتحدة وإيران، على مدى أربعة عقود من عمر “الجمهورية الإسلامية”، فالموقف العدائي الرسمي بينهما، وسياسة الضغط والعزل التي مارستها واشنطن تجاه طهران لم تمنع حصول تنسيق هنا أو توافق مصالح هناك.
لعلّ فضيحة “إيران – كونترا” (أو إيران غيت)، وكانت إسرائيل طرفاً فيها، من أبرز الدلائل على الطبيعة الملتبسة لهذا النوع من “العداء”. فإنّه بين عامي 1985 – 1986، باعت الولايات المتحدة أسلحةً لإيران عن طريق إسرائيل، في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، على الرغم من دعم واشنطن وحلفائها المعلن للعراق، واستخدَمت أموال الصفقة لدعم مقاتلي “الكونترا” الذين كانوا يسعون إلى إطاحة الحكومة اليسارية في نيكاراغوا. في المقابل، ضغطت طهران على مليشيات مرتبطة بها في لبنان، من أجل الإفراج عن رهائن أميركيين محتجزين لديها، وذلك كله خلافاً للموقف الأميركي الرسمي الذي يصنّف إيران بلداً معادياً ويفرض عليها عقوبات مختلفة، منها تشريعات الكونغرس التي تحظر بيع السلاح لإيران. وفي سورية، كان تذبذب السياسات الأميركية حيال الملف السوري من عوامل تمدّد النفوذ الإيراني، سيما في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، أوباما، الذي كان حريصاً على إنجاز الاتفاق النووي مع إيران، وهي فرصةٌ استغلّها الإيرانيون ببراعة، في سورية كما على غير جبهة في المنطقة.
من الواضح أنّ التركيز الإسرائيلي منصبّ على الشق العسكري والأمني للوجود الإيراني في سورية، من دون إيلاء اهتمامٍ يُذكر لنفوذ إيران الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، فالخطط الإيرانية لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل استراتيجية متعدّدة المستويات، وُضِعت من أجل وجودٍ راسخ ومستدام، عبر وسائل اقتصادية وثقافية وتعليمية، فضلاً عن تلك الديموغرافية، بشقّيها التبشيري أو الناجم عن التهجير القسري للسكّان. وقد أُبرِمت اتفاقيات رسمية طويلة الأمد بين حكومتي إيران ونظام الأسد، بهدف إضفاء الشرعية على التغوّل الإيراني الذي أصبح يطاول جوانب الحياة كافّة. ولا تخفى حالة التنافس بين الجانبين، الروسي والإيراني، على النفوذ والموارد في ما تبقّى من سورية، ما سهّل على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مع الروس، تتيح لها مزيداً من الحرّية في ضرب الأهداف الإيرانية على الأراضي السورية.
وإذ تعمل إيران على تعزيز مواقع مليشياتها في مختلف المناطق السورية، حيث لا تُستثنى أي منطقة من اهتمامها، وفق تدابير متنوّعة تفرضها ظروفُ كلّ منها، فإنّ ما يثير قلق إسرائيل هو أنشطة إيران التي تتجاوز أدوات السيطرة في سورية، مثل تطوير أنظمة صاروخية وأسلحة غير تقليدية في منشآت عسكرية سورية، بعيداً عن الرقابة والقيود التي تفرضها العقوبات الدولية على إيران، وكذلك تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، إلى درجةٍ قد تخلّ بالتوازنات القائمة. وعلى الرغم من اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ونوعيّتها، تستمرّ لعبة عضّ الأصابع، ويمضي الإيرانيون في مشروعهم، وعينهم على ما هو أبعد من الحدود السورية.
المصدر: العربي الجديد







