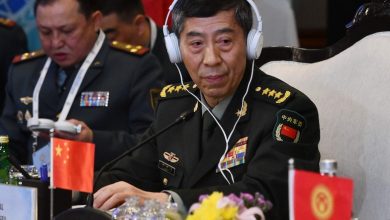إذ تشوب وضع الصين باعتبارها “ورشة العالم” أخطار سياسية متزايدة، ونمو متباطئ، وسياسات “صفر كوفيد” التي تتراجع بسرعة إمكانية تبريرها، لا يبدو أي بلد قادراً على الاستفادة أكثر من الهند. في مايو (أيار) نشرت “إيكونومست” موضوع غلاف عن الهند، فسألت عما إذا كانت المرحلة الحالية تمثل فرصة البلاد الأنسب – وخلصت إلى الإجابة بنعم على الأرجح. وفي وقت أقرب، أعلن الاقتصادي في جامعة ستانفورد الحائز على جائزة نوبل مايكل سبنس أن “الهند هي البلاد صاحبة الأداء المتميز الآن”، مشيراً إلى أنها “تظل المقصد الاستثماري الأكثر تفضيلاً”. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توقع تشيتان أهيا، كبير الخبراء في الاقتصاد الآسيوي لدى “مورغان ستانلي”، أن يشكل الاقتصاد الهندي خمس النمو العالمي على مدى العقد المقبل.
لا شك في أن الهند قد تكون على أعتاب ازدهار تاريخي – إذا تمكنت من زيادة الاستثمار الخاص، بما في ذلك اجتذاب أعداد كبيرة من الشركات العالمية من الصين، لكن هل ستتمكن نيودلهي من اغتنام هذه الفرصة؟ ليست الإجابة واضحة. عام 2021، قدمنا تقييماً واقعياً لآفاق الهند في “فورين أفيرز”. وأشرنا إلى أن الافتراضات الشائعة في شأن ازدهار الاقتصاد كانت غير دقيقة. والواقع أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد تعثرت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتوقفت تماماً بعد عام 2018. وجادلنا بأن السبب وراء هذا التباطؤ يكمن عميقاً في الإطار الاقتصادي للهند: تركيزها على الاعتماد على الذات والعيوب التي تشوب عملية وضع السياسات الخاصة بها – “الأخطاء في البرمجية” كما سميناها.
وبعد سنة واحدة، وعلى رغم الصحافة المتحمسة، ظلت البيئة الاقتصادية في الهند من دون تغيير يذكر. ونتيجة لهذا، لا نزال نعتقد أن تغييراً جذرياً في السياسات مطلوب قبل أن تتمكن الهند من إحياء الاستثمار المحلي، ناهيك بإقناع أعداد كبيرة من الشركات العالمية بنقل إنتاجها إلى هناك. ومن بين الدروس المهمة التي يتعين على واضعي السياسات أن يتعلموها هو غياب الحتمية، وانتفاء الخط المستقيم للسببية، بين انحدار الصين وصعود الهند.
أرض موعودة؟
من بعض النواحي، تبدو الهند وكأنها أرض موعودة للشركات العالمية. هي تتمتع بمزايا بنيوية، ولدى منافسيها المحتملين عيوب خطيرة، وتعرض الحكومة حوافز استثمارية ضخمة.
فلنبدأ بالمزايا البنيوية، إذ تملك الهند مساحة أكبر بتسعة أضعاف من مساحة ألمانيا وكتلة سكانية ستتفوق قريباً على الصينية باعتبارها الأكبر عدداً على مستوى العالم، هي تعد واحداً من البلدان القليلة التي تتمتع بالحجم الكافي لاستيعاب عديد من الصناعات الضخمة، التي تنتج في البداية لصالح الأسواق العالمية وفي النهاية للسوق المحلية المزدهرة. وهي فضلاً عن ذلك ديمقراطية راسخة ذات تقاليد قانونية طويلة، وقوة عاملة تتميز في شكل لافت بأنها شابة وموهوبة وناطقة بالإنجليزية. كذلك حققت الهند بعض الإنجازات الكبيرة لصالحها: تحسنت بنيتها التحتية المادية في شكل كبير في السنوات الأخيرة، في حين تجاوزت بنيتها التحتية الرقمية – ولا سيما نظامها الخاص بالمدفوعات المالية – تلك الخاصة بالولايات المتحدة على نحو ما.
وبعيداً من هذه المزايا، هناك مسألة البدائل. إذا لم تذهب الشركات الدولية إلى الهند، فأين قد تذهب؟ قبل بضع سنوات، ربما كانت بلدان أخرى في جنوب آسيا تعتبر مرشحة جذابة، لكن هذا تغير. على مدى العام الماضي، شهدت سريلانكا أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية مصيرية. وأضرت بباكستان صدمة بيئية أدت إلى تفاقم ضعفها الاقتصادي الكلي الدائم وعدم استقرارها السياسي المستمر. وحتى بنغلاديش، التي ظلت لفترة طويلة جذابة في مجال التنمية، اضطرت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع كبير في أسعار السلع، ما استنفد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وفي خضم هذه “الأزمة المتعددة” التي ضربت جنوب آسيا، على حد وصف المؤرخ الاقتصادي آدم توز، تبرز الهند باعتبارها ملاذاً مستقراً.
والأمر الأكثر أهمية هنا هو المقارنة بالصين، المنافس الاقتصادي الأكثر وضوحاً للهند. على مدى العام الماضي، كان نظام الرئيس الصيني شي جينبينغ يعاني تحديات متعددة، بما في ذلك نمو اقتصادي بطيء وانحدار ديموغرافي يلوح في الأفق. وزادت الإغلاقات الصارمة في ظل كوفيد-19 التي يتبناها الحزب الشيوعي الصيني الطين بلة. في الأسابيع الأخيرة، واجهت بكين اضطرابات متفاقمة في صفوف السكان، بما في ذلك أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة انتشاراً في البلاد على مدى عقود، هذا التحول نحو الحكم الاستبدادي في الداخل والعدوان في الخارج – والحكم العاجز الذي أساء إلى “النموذج الصيني” الأسطوري – جعل الهند الديمقراطية تبدو أكثر ترحيباً.
وأخيراً، اتخذت الهند خطوات من شأنها، على الورق، اجتذاب الشركات الدولية. في أوائل عام 2021، قدمت الحكومة برنامجها للحوافز المرتبطة بالإنتاج بهدف توفير الحوافز الاقتصادية لكل من شركات التصنيع الأجنبية والمحلية التي “تصنع في الهند”. ومنذ ذلك الحين، حققت مبادرة الحوافز المرتبطة بالإنتاج – التي تعرض إعانات كبيرة على المصنعين في القطاعات المتقدمة مثل الاتصالات، والإلكترونيات، والأجهزة الطبية – نجاحات قليلة ملحوظة. في سبتمبر (أيلول) 2022، مثلاً، أعلنت “أبل” أنها تخطط لإنتاج ما بين خمسة إلى 10 في المئة من طرز “آيفون 14” الجديدة في الهند، وفي نوفمبر، أعلنت “فوكسكون” أنها تخطط لبناء مصنع لأشباه الموصلات بقيمة 20 مليار دولار في البلاد إلى جانب شريك محلي.
الخطابة في مقابل الواقع
لكن إذا كانت الهند حقاً الأرض الموعودة، لا بد وأن تنضم إلى المثلين أعلاه أمثلة أخرى عديدة. يتعين على الشركات الدولية أن تصطف لنقل إنتاجها إلى شبه القارة، في حين تعزز الشركات المحلية استثماراتها لتستفيد من الازدهار. وعلى رغم هذا لا تزال الإشارة إلى أي من هذين الأمرين ضئيلة. ووفق عديد من المقاييس، لا يزال الاقتصاد يكافح من أجل استعادة مركزه الذي كان قبل انتشار الجائحة.
فلنأخذ الناتج المحلي الإجمالي الهندي. صحيح أن النمو على مدى العامين الماضيين كان سريعاً في شكل استثنائي، وكان أعلى منه في أي دولة رئيسة أخرى – وهذا ما لا يتوقف المعلقون المتحمسون عن الإشارة إليه، لكن هذا النمو وهم إحصائي إلى حد كبير. الأمر المستثنى هو أن الهند، أثناء السنة الأولى من الجائحة، عانت أسوأ انكماش في الناتج لدى أي دولة نامية كبيرة، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي، قياساً إلى عام 2019، هو اليوم أكبر بنسبة 7.6 في المئة فقط، مقارنة بـ13.1 في المئة في الصين و4.6 في المئة في الولايات المتحدة التي تشهد نمواً بطيئاً. والواقع أن معدل النمو السنوي في الهند على مدى الأعوام الثلاثة الماضية سجل 2.5 في المئة فقط، وهذا أقل كثيراً من معدل السبعة في المئة السنوي الذي تعتبره البلاد نموها الممكن. ولا يزال أداء القطاع الصناعي أضعف.
وليست المؤشرات الاستشرافية أكثر تشجيعاً. عاودت الإعلانات عن المشاريع الجديدة (مقاسة من قبل مركز مراقبة الاقتصاد الهندي) التراجع بعد انتعاش قصير في مرحلة ما بعد الجائحة، وتظل أدنى كثيراً من المستويات التي تحققت أثناء الازدهار الذي شهدته السنوات الأولى من هذا القرن. والأمر الأكثر لفتاً للنظر هو أن الأدلة التي تشير إلى أن الشركات الأجنبية تنقل إنتاجها إلى الهند ليست كثيرة. على رغم الأحاديث كلها عن الهند باعتبارها المقصد الاستثماري المختار، ظل الاستثمار المباشر الأجنبي عموماً راكداً طيلة العقد الماضي، وظل مساوياً لاثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن في مقابل كل شركة احتضنت الفرصة الهندية، كانت لشركات أكثر بكثير تجارب غير ناجحة في الهند، بما فيها “غوغل”، و”والمارت”، و”فودافون”، و”جنرال موتورز”. حتى “أمازون” عانت، إذ أعلنت في أواخر نوفمبر أنها كانت تعمل على إغلاق ثلاثة من مشاريعها الهندية، في مجالات متنوعة مثل تسليم الغذاء، والتعليم، والتجارة الإلكترونية بالجملة.
لماذا تتردد الشركات العالمية في نقل عملياتها الجارية في الصين إلى الهند؟ للسبب نفسه الذي يجعل الشركات المحلية تتردد في الاستثمار: لأن الأخطار تظل شديدة الارتفاع.
أخطاء في البرمجية
من بين الأخطار العديدة التي تهدد الاستثمار في الهند، ثمة خطران على قدر كبير من الأهمية. أولاً، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن السياسات القائمة عندما تستثمر لن تتغير في وقت لاحق، على نحو يجعل استثماراتها غير مربحة. وحتى إذا ظل إطار السياسات جذاباً على الورق، لا تستطيع الشركات أن تتيقن من أن القواعد ستطبق من دون تحيز وليس لصالح “الشركات الوطنية الرائدة” – أي التكتلات الهندية العملاقة التي تفضلها الحكومة.
على هذه المشكلات تترتب بالفعل عواقب وخيمة. تتبدد الأرباح الخاصة بشركات تعمل في مجال الاتصالات بسبب السياسات المتغيرة. وتواجه جهات مزودة لخدمات الطاقة صعوبة في تمرير الزيادات في الكلف إلى المستهلكين وجمع عوائد موعودة من مجالس الكهرباء الحكومية. وتكتشف شركات تعمل في التجارة الإلكترونية أن الأحكام الحكومية في شأن الممارسات المسموح بها يمكن قلبها بعد أن تكون الشركات ضخت استثمارات كبيرة وفق القواعد الأصلية.
وفي الوقت نفسه كانت الشركات الوطنية الرائدة تتمتع بأعظم قدر من الازدهار. بحلول أغسطس (آب) 2022، كان ما يقرب من 80 في المئة من الزيادة التي بلغت خلال سنة 160 مليار دولار في رسملة سوق الأوراق المالية في الهند راجعاً إلى تكتل واحد، “مجموعة أداني”، التي أصبح مؤسسها فجأة ثالث أغنى شخص في العالم، بمعنى آخر، ليست الفرص متكافئة.
كذلك لا تستطيع الشركات الأجنبية أن تقلل من الأخطار التي تواجهها من خلال إبرام شراكات مع شركات محلية ضخمة، ذلك أن الدخول في أعمال مع الشركات الوطنية الرائدة أمر محفوف بالأخطار، إذ تسعى هذه المجموعات إلى الهيمنة على المجالات المربحة نفسها، مثل التجارة الإلكترونية. ولا ترغب شركات محلية أخرى في التعامل مع القطاعات التي تهيمن عليها جماعات حصلت على خدمات حكومية واسعة النطاق على صعيد التنظيمات.
ثمن الدخول
بعيداً من الأخطار المرتفعة، هناك عديد من الأسباب الأخرى التي قد تبقي الشركات الدولية قلقة من الهند. مثلاً، يتلخص أحد العناصر الرئيسة الخاصة ببرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج في رفع الرسوم الجمركية على المكونات المصنوعة في الخارج. وتتلخص الفكرة في تشجيع الشركات على الانتقال إلى الهند لشراء المدخلات في السوق المحلية، لكن هذا النهج يعرقل في شكل كبير عمل غالب الشركات العالمية، ذلك لأن المنتجات المتقدمة في عديد من القطاعات تصنع عادة من مئات بل وحتى آلاف الأجزاء التي يجري الحصول عليها من أكثر المنتجين تنافسية في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه الأجزاء، قدمت نيودلهي عاملاً مثبطاً قوياً إلى الشركات التي تفكر في الاستثمار في البلاد.
بالنسبة إلى شركات مثل “أبل” تخطط لبيع منتجاتها في الهند، قد تكون الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات مسألة أقل أهمية، لكن هذه الشركات نادرة، ذلك أن سوق المستهلكين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة في الهند لا تزال صغيرة إلى حد مدهش – لا تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار مقارنة بسوق عالمية تبلغ نحو 30 تريليون دولار، وفق دراسة أجراها شوميترو تشاتيرجي وأحدنا (سوبرامانيان). لا يمكن اعتبار سوى 15 في المئة من السكان من الطبقة المتوسطة وفق التعريفات الدولية، بينما يميل الأغنياء المسؤولون عن حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ادخار حصة كبيرة من عوائدهم. يحد كل عامل من العاملين من استهلاك الطبقة المتوسطة. وبالنسبة إلى غالب الشركات، تفوق أخطار مزاولة الأعمال في الهند المكافآت المحتملة.
مع إدراك نيودلهي التوتر المتصاعد بين سياساتها الحمائية وهدفها المتمثل في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للهند، تفاوضت أخيراً على اتفاقيات للتجارة الحرة مع أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هذه المبادرات – مع اقتصادات أصغر حجماً وأقل ديناميكية – تتضاءل إلى حد كبير مقارنة بمثيلاتها لدى البلدان الآسيوية المنافسة للهند. توقع فيتنام، مثلاً، اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2010، بما في ذلك مع الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فضلاً عن شركائها الإقليميين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
حالات عجز خطيرة
في أي بلد، هناك شرط مسبق معروف للإقلاع الاقتصادي، وهو وجود مؤشرات رئيسة للاقتصاد الكلي تكون في توازن معقول: يجب أن يكون عجز المالية العامة وعجز التجارة الخارجية منخفضين، وكذلك معدل التضخم، لكن في الهند اليوم، ليست هذه المؤشرات سليمة. قبل أن تبدأ الجائحة بوقت طويل، كان معدل التضخم أعلى من السقف القانوني المقرر من المصرف المركزي والبالغ ستة في المئة. ومن ناحية أخرى، تضاعف عجز الحساب الحالي في الهند إلى نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث من عام 2022، إذ تعاني البلاد من أجل زيادة الصادرات في حين تستمر وارداتها في النمو.
لا شك في أن عديداً من البلدان تعاني مشكلات خاصة بالاقتصاد الكلي، لكن متوسط هذه المؤشرات الثلاثة في الهند أسوأ من أي اقتصاد ضخم آخر، باستثناء الولايات المتحدة وتركيا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العجز الحكومي العام في الهند، الذي يبلغ نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يعد واحداً من أعلى المستويات في العالم، إذ تمثل أقساط الفائدة وحدها أكثر من 20 في المئة من الميزانية (بالمقارنة، تمثل مدفوعات الدين ثمانية في المئة فقط من الميزانية الأميركية). ومما يزيد الموقف سوءاً محنة شركات توزيع الكهرباء التي تديرها الدولة في الهند، والتي بلغت خسائرها الآن نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن حالات العجز في المالية العامة.
ويتلخص الحاجز الأخير الذي يعرقل النمو في تحول بنيوي عميق أدى إلى تقويض ديناميكية المشاريع الخاصة وقدرتها على المنافسة. يعاني القطاع غير الرسمي البالغ الضخامة في الهند من أضراراً كبيرة في شكل خاص: أولاً بسبب سحب الأوراق المالية ذات القيمة الاسمية الكبيرة من التداول عام 2016، مما وجه ضربة مدمرة إلى الشركات الأصغر حجماً التي أبقت رأس مالها العامل نقدياً، ومن ثم بسبب ضريبة جديدة على البضائع والخدمات العام التالي، وأخيراً بسبب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لهذا، هبطت معدلات تشغيل العمالة من ذوي المهارات المتدنية إلى حد كبير، وانخفضت الأجور الحقيقية في المناطق الريفية بالفعل، الأمر الذي اضطر السكان الفقراء من ذوي المداخيل المنخفضة في الهند إلى خفض استهلاكهم.
تشكل نقاط الضعف هذه في سوق العمل تذكيراً تحذيرياً بأن القطاع الرقمي الذي يتباهى به البلد – الذي يبدو وعده بالفعل غير محدود تقريباً ــ يوظف عاملين من ذوي المهارات العالية يشكلون جزءاً ضئيلاً من القوة العاملة. وعلى هذا، يبدو من غير المرجح أن يولد صعود الهند باعتبارها قوة رقمية، مهما بلغ نجاحها، المنافع الكافية على مستوى الاقتصاد بالكامل من أجل التأثير في التحول البنيوي الأوسع الذي تحتاج إليه البلاد.
خيار الهند
بعبارة أخرى، تواجه الهند ثلاث عقبات رئيسة في سعيها إلى التحول إلى “الصين التالية”: أخطار الاستثمار أكبر مما ينبغي، وانغلاق السياسات على الذات قوي بشدة، واختلال التوازن في الاقتصاد الكلي أضخم مما يجب. ولا بد من إزالة هذه العقبات قبل أن تستثمر الشركات العالمية، لأنها تملك بدائل أخرى. هي تستطيع إعادة عملياتها إلى بلدان “آسيان”، التي كانت بمثابة المصنع الأساسي للعالم قبل أن ينتقل هذا الدور إلى الصين. وهي تستطيع إعادتها إلى أوطانها في البلدان المتقدمة، التي أدت هذا الدور قبل بلدان “آسيان”. أو هي تستطيع إبقاءها في الصين، وقبول الأخطار على أساس أن البديل الهندي ليس أفضل.
إذا كانت السلطات الهندية راغبة في تغيير مسارها وإزالة العقبات التي تحول دون الاستثمار والنمو، قد تصح حقاً التصريحات الوردية التي يدلي بها الخبراء، لكن إن لم يحدث ذلك، ستستمر الهند في تدبر أمورها كيفما اتفق، وسيكون أداء أجزاء من الاقتصاد طيباً، لكن البلاد ككل ستفشل في تحقيق إمكاناتها.
قد يستسلم واضعو السياسات في الهند إلى إغراء الاعتقاد أن انحدار الصين يؤدي إلى معاودة الهند البروز على نحو مذهل، لكن في نهاية المطاف، ليس احتمال تحول الهند إلى الصين التالية من عدمه مسألة تتعلق بالقوى الاقتصادية العالمية أو العوامل الجيوسياسية فحسب. هو أمر سيتطلب تحولاً جذرياً في السياسات تقوم به نيودلهي ذاتها.
* أرفيند سوبرامانيان زميل أقدم في جامعة براون وعمل ككبير المستشارين الاقتصاديين لحكومة الهند بين عامي 2014 و2018.
* *جوش فيلمان هو مدير في “جاي أتش للاستشارات” وكان الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في الهند بين عامي 2006 و2008.
مترجم عن فورين أفيرز، 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022
المصدر: اندبندنت عربية