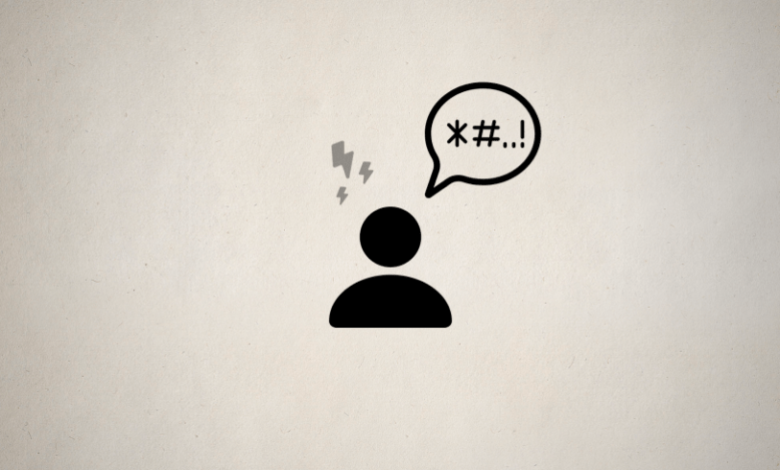
عبر التاريخ كان الكذب عارضاً في الفضاء العام رغم أنه لم يغب عن أيٍّ من المجتمعات وهذا أمر مفهوم. ولطالما اعتبرته الأعراف والأديان والأخلاقيات الاجتماعية خطأً مذموماً، وحضَّت على اجتنابه. بل ووسمت ممارسيه برذيلة تلك الصفة. وعلى الدوام كان بالإمكان عزل وتقليص تبعاته وتأثيره إلى الحدود الدنيا.
كارثتنا المعاصرة اليوم أننا لم نعد أمام ظواهر فردية، إنما ظاهرة عامة مكتملة الأركان، مع جمهور واسع يصغي للكذّابين الجدد ممن يُطلَق عليهم اليوم توصيف المؤثرين “Influencers”. جمهورٌ يتلقّى هذا الكذب بشغف وتصديق، وليس على مضضٍ كما هو مألوف، حتى عندما يكون الزيف فاقعاً وساذجاً إلى حدّ إهانة العقل، عدا الذكاء.
هذا الجمهور، كما يمكن ملاحظته، ينقسم إلى مجموعتين. الأولى، وهي الأخطر سياسياً، تتكون من أناسٍ ذوي سويّة ثقافية عالية أو معقولة بالحد الأدنى، لكن تحكمهم الرغبات والأمنيات، بعيداً عن الحقائق والوقائع. هؤلاء يفتّشون على الدوام عمّا يؤكّد ميولهم المسبقة واصطفافاتهم، دون التوقّف عند المنطق المتهافت فيما يسمعون، ما يمنحهم شعوراً بالانتصار الوهمي أو الطمأنينة النفسية التي يحتاجون إليها بشدّة. بعبارة أخرى هم يستبعدون المنطق طوعاً وبكرمٍ فائض. رغباتهم وأمنياتهم تطيح وتُذْهِب بمعظم هذا المنطق الذي يمكن أن يحاكِمَ به أي متلقٍّ المعلومةَ التي تصل إليه.
أما المجموعة الثانية، فهي أقل عدداً ربما، لكنها تمتلك، للأسف، الصلابة ذاتها في تعطيل أية إمكانية للرؤية وبالتالي للنقاش العقلاني. نوعٌ من الجمهور تربّى لعقود على عدم امتلاك أدوات التفكير النقدي، ولذا لا يرى في التناقض أو الفجاجة أو الكذب مشكلة تستحق التوقف عندها. وهذه طبيعة شخصية يصعب علاجها، لأن هؤلاء أصلاً لا يرون ولا يدركون المرض.
في سوريا اليوم هناك كثير من هؤلاء ممن يلعبون بالنار فوق برميل البارود تماماً. تتوزّع هذه الظاهرة على الخطوط الدينية والطائفية والعرقية بوضوح مقلق.
في هذا السياق، أنا لا أتحدث فقط عن “المؤثر” بوصفه مجرد ناقل رأي أو صانع محتوى مهما كان مضمون ما يقدّمه، بل أحاول الحديث عن تحوّله إلى نوع من الفاعل الاقتصادي. فالكذب والتهويل والتحريض، وركوب الموجة “الترند”، جميعها تحوّلت، في عالم اليوم، إلى أدوات ضمن مهنة مربحة مادّياً على وسائل التواصل. فكما بتنا نعلم جميعاً، فإن ارتفاع منسوب الاستفزاز سيرفع المشاهدات، وكلما ازداد الغضب ازدادت الأرباح. هكذا تتحوّل العواطف الجمعية إلى مادة خام يتم الاستثمار بها، ويُعاد تدويرها، بين تجار هذا المجال، في سوقٍ اقتصاديّ لا أخلاقي. يجب أن نلاحظ أن هذه التطبيقات تُقدَّم لنا مجاناً،
نستخدمها من دون أيّ مقابل ماديّ، والسبب هو أننا نحن السلعة في هذا السوق الاقتصادي. هذه الظاهرة هي إحدى منتجات العقد الأخير، وهي للأسف ليست بريئة، ولا عابرة. ظاهرةٌ تسهم، في حدودها المتطرفة، بصناعة الهشاشة إلى حدِّ تفكيك المجتمعات من دون أن تكتفي بتشويه الوعي فقط، خصوصاً تلك المجتمعات الهشّة، الخارجة لتوّها من نزاعات طويلة، والتي تحاول، بشق الأنفس، رأب الصدوع لا تعميقها.
للشعور بشيء من المواساة، يمكن القول إنها ظاهرة لا تقتصر على مجتمعنا وحسب، بل تعمُّ العالم كله. هناك كثير من الأمثلة العالمية قاد فيها “المؤثرون” مجتمعاتهم إلى الهاوية في بعض الحالات. في ميانمار، لعب فيسبوك ومؤثروه دوراً مركزياً في تأجيج الكراهية ضد الروهينغا. حسابات مؤثرة، بعضها ديني وبعضها قومي، بثّت الأكاذيب والشائعات، وشيطنت جماعة كاملة، ما مهّد الطريق لواحدة من أبشع عمليات التطهير العرقي في العصر الحديث. كذلك حدث ما يشبه هذا في الهند وسريلانكا، عندما أسهم مؤثرون قوميون ودينيون في تحويل الخلافات الهوياتية إلى عنف مباشر في الشارع، عبر مقاطع قصيرة مشحونة تتعمّد الاستفزاز وشيطنة الآخر المختلف، لتصل بعدها إلى جمهور جاهز للاشتعال.
في سوريا اليوم هناك كثير من هؤلاء ممن يلعبون بالنار فوق برميل البارود تماماً. تتوزّع هذه الظاهرة على الخطوط الدينية والطائفية والعرقية بوضوح مقلق. هناك مؤثرون سنّة وعلويون وكرد ودروز وغيرهم، لا يتورّعون عن تبنّي خطاب اصطفافي فجّ، يبث الأحقاد ويعيد إنتاج سرديات المظلومية والتخوين وتحقير الجماعات الأخرى، عبر توصيفات وتسميات ساخرة ومهينة والأدهى أنها تعميمية. يترافق ذلك مع بعض الطرافة عند استعراض هؤلاء لانتباجٍ هويّاتي فيه كثير من البلاهة. كلٌّ من موقعه، وكلٌّ باسم “الدفاع عن جماعته” من شعوب الله المختارة!
الخطير أن هذا يحدث في لحظة احتقان قصوى وغير مسبوقة، حيث لا تزال الذاكرة السورية الجمعية مثقلة بالدم والخوف والشكوك المتبادلة. في مثل هذه الظروف، يتحول هذا الأمر إلى فعلٍ سياسي له تبعات مادية دامية ومباشرة، متخطياً حرية الرأي والتعبير. الاعتداءات على عائلات كردية وعربية في الجزيرة السورية التي يتم تناقل أخبارها، والهجومات التي شهدناها مؤخراً على محال عربية خلال تظاهرات كردية في أوروبا، والجرائم المتنقلة على الدراجات النارية بحق علويين لمجرّد انتمائهم الطائفي، ليست معزولة عن هذا المناخ التحريضي العابر للحدود، والذي تُغذّيه منصّات التواصل ومؤثروها
المتموضعون خلف متاريسهم على خطوط الصدوع السورية، ويسهمون يومياً في رفع منسوب الكراهية.
في مجتمع كالمجتمع السوري، الخارج من جرح عميق، فإن “المؤثر” المحرض شريك في الجريمة الرمزية، وهو مرتكبٌ مشاركٌ فيما يستتبع ذلك من جرائم مادية لاحقاً..
السؤال الذي يتبادر للذهن هنا، لماذا يبدو تأثير المؤثرين الإيجابيين أقل، رغم أنهم ليسوا قلّة؟ بالنسبة لي الإجابة مؤلمة لكنها واضحة. الخطاب العقلاني ليس مثيراً فلا يثير “الدوبامين” في الدماغ، والدعوات إلى التهدئة لا تصنع الترند ولا تحدث تفاعلاً كبيراً. فالمحتوى الذي يحترم التنوع وضرورات السلم الأهلي، والأهم يحترم العقل والمنطق والحقائق، لا يمكن أن ينافس الفيديوهات التي تقدّم عدوّاً واضحاً ضمن قصة سطحيّة بلغةٍ يفحُّ منها الغضب. بتنا نعلم اليوم أن خوارزميات المنصّات تميل إلى الانفعالات والتطرف عموماً، ولا يناسبها الاتزان. طبعاً هذا لا يعني أنها متآمرة وشريرة بقدر ما هي تجارية، فما يُبقي المستخدم ملتصقاً بها لأطول فترة هو ما يُغضبه أكثر، وهنا يكمن ربح تلك المنصات. وهذا ما لا يتوفر لدى المؤثر الإيجابي الذي غالباً يضع لنفسه سقفاً أخلاقياً. أما التحريضي المنحاز فلا سقف لديه ولذا تغدو المنافسة هنا غير متكافئة.
ما نواجهه اليوم، بغياب أية محاسبة قانونية، وهذه مسؤولية الدولة دون شك التي لم تفعل شيئاً جدّياً تجاه هذه الظاهرة الخطيرة، هو انفلات في المسؤولية وفوضى في التعبير، وهو ما يختلف تماماً عن حرية الرأي. فلا يجوز السماح لمن استطاع امتلاك جمهور ما أن يعبث بالنسيج الاجتماعي. وإن تَرْكَ الحبل على الغارب في هذه الجزئية، إضافةً إلى أنه ليس فيه من الحكمة أي شيء، فإنه لا يمكن أن يندرج تحت عنوان حماية الحريّات، فهو ليس في هذا الحقل إطلاقاً، والأجدر بل ومن الطبيعي اعتباره في حقل الجريمة.
في مجتمع كالمجتمع السوري، الخارج من جرح عميق، فإن “المؤثر” المحرض شريك في الجريمة الرمزية، وهو مرتكبٌ مشاركٌ فيما يستتبع ذلك من جرائم مادية لاحقاً. لأن وقع الكلمة هنا كمن يُلقي حجراً في الماء، ما تلبث أن تتسع دوائره إلى ما لا يمكن ضبطه. إن أخطر ما في “اقتصاد الكذب” هذا، ليس الكذب بحد ذاته، فهو لطالما كان موجوداً عبر التاريخ، إنما في تحوّله إلى مهنة وهوية نفسية متضخمة، والأدهى إلى مصدر رزق لا يستهان به. ومما لا شك فيه، فإنه عندما تتحول الكراهية إلى سلعةٍ مُربحة، فإن أول من سيُستهلَكُ هنا هم أفراد المجتمع، وبالطبع المجتمع ذاته تالياً.
المصدر: تلفزيون سوريا



