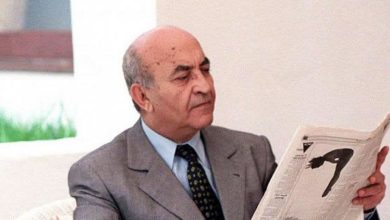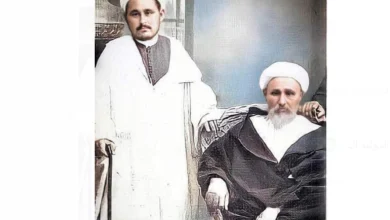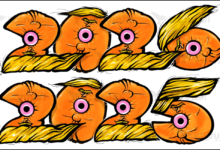تعالت في الفترات المتأخرة دعوات متكرّرة تطالب المثقف بالظهور العلني في الساحة العمومية، والتعبير عن الرأي السياسي، لا عن الثقافي بحكم مجال العمل والاختصاص، فيما يجري ويدور من حوله، خصوصاً مع وجود كثير من الصراعات السياسية وتناميها، وغير السياسية، التي تدور في مختلف المحيطات المرتبطة بالحياة الثقافية والفكرية، وبالمجتمع وَفِعْلِ بنياتِه في تطوره واستمراره، ثم أنْ يكون هذا التعبير بالموقف المنطقي، أو البديهي، أو المسؤول، أو الأخلاقي إلخ… المطلوب منه، أي بالصورة المرجوة والمنتظرة منه في الدعم، أو المساندة، أو فقط لمجرد تسجيل موقف (يُفترض أن يكون استثنائياً و”نَبَوِيّاً”)، والاستناد إليه في تحميسِ تَصَوُّر من التصوّرات، أو عملية من العمليات الجارية، أو التي يمكن أن تجري في المجال المشترك. وقد لاحظنا بروز تلك الدعوات في المغرب، وهناك حالات مماثلة في الدول المغاربية الأخرى، منذ فترة بعيدة نسبياً (“الربيع العربي” و”الحَرَاكَات” المختلفة في تونس والجزائر والمغرب في الجنوب وفي الشمال الشرقي…) في ارتباط، من ناحية، بتقلص النفوذ التقليدي للأحزاب السياسية التي تكفل لها الدساتير إلى جانب النقابات في النظم الديمقراطية، أدواراً متفاوتة في التنظيم والتأطير والتوجيه. وفي تطور ملحوظ، من ناحية ثانية، بما آلت إليه الأوضاع العامة من تدهور رَفَع من حدة التوتر الاجتماعي، وبلور صيغاً متجددة للصراع المباشر سواء من خلال المقاومة المدنية (“التنسيقيات” في المغرب)، أو بالتعبير السياسي المعارض مباشرة، وهو مكلف ويُعَرّض الفاعل لعقوبات مختلفة في جو من انعدام الحريات الأساسية التي يمكن أن تحدد ذلك وتنظمه، منعاً للحروب الأهلية، بالشكل المطلوب.
بناء تصوّر مشترك عن الأدوار المفترضة للمثقف ضمن مشروع ثقافي معين هو من اختصاص العاملين في المجال الثقافي نفسه
أُسَلِّمُ أن تلك الدعوات إنما تَقَوَّت، وفي بعض خطاباتها سَادَت لفترة، في علاقة بعوامل أذكر منها: تطور “حياة وَمَجَال” الشبكات الاجتماعية على النّت، والتعبير الذي يبثه المُسَمَّون بـ”المؤثرين” فيها على جميع المستويات وبمختلف التطبيقات أو الوسائط. وثانيها في ارتباط مع تطور حركات النضال الاجتماعي والسياسي وغيرها في كثير من البلدان والسياقات، ونلاحظه بصورة أقوى في بعض الأحيان، ولو أنه لا يحظى بالاهتمام المؤكد ولا بالإعلام المصاحب، في أكثر من دولة مغاربية بالنظر إلى كثير من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها تلك البلدان في الميادين الاقتصادية (السوق والاستغلال) والدستورية (الديمقراطية وطبيعة الحكم) والحقوقية (الحرّيات العامة والخاصة) إلخ، ثم قد نجده في المستوى الثالث في علاقة بضمور دور الأحزاب السياسية وغياب الفضاءات الثقافية التي كانت في سابق التجربة بالنسبة إليها مجالاً خصباً لنشر دعواتها وأيديولوجيتها، معارضة أم موالية.
ولا أخْفِي أنّ الحديث عن المثقف ودوره في المجتمع ارتبط تاريخياً، وفي العصور الحديثة على وجه الخصوص، بعاملين اثنين: أولهما تم على ضوء سؤال النهضة الذي مهد وساوق حركة التحرير الوطنية العامة من الاحتلالات الغربية الاستعمارية وغير الاستعمارية، أي إنه وليد صدمة تاريخية بلورت إحساساً قوياً بالأوضاع المتخلفة القائمة في بلدان الاستقبال، فجاءت صياغته على قدر الوعي الذي صاحب تلك البلورة من قبل النخب الوطنية في معظم الأحيان. ويمكن الحديث، في ارتباط مع هذا، عن سؤال آخر ارتبط به، أعني به سؤال الأيديولوجية في علاقةٍ مُدرَكة وإرادية أيضاً بالعقيدة الاشتراكية، أو الماركسية، أو الشيوعية (أي بحسب درجة فهم وتمثل الصيغة الأيديولوجية المتداولة..).. فجاء الفهم على قدر الاختيار الأيديولوجي. فَجَرَى تداول المفهوم (المثقف) اعتباراً للدور التعبوي الذي أنيط بالعاملين في ميدان التحرير إناطة شاملة. ولهذا الأمر لم يكن الفرق إلا من حيث الصفة بين المثقف والسياسي (النقابي أيضاً) مع أن مجالات العمل والاختصاص، إذا جاز القول، كانت متباينة إلى حد ما، وإن يكن التباين ضمن منظومة مشتركة للعمل والنضال في سبيل التحرير، أو ما كان ينظر إليه بوصفه تحريراً من السيطرة. والنموذج الفانوني (فرانز فانون) (أميكال كبرال، المهدي بنبركة وغيرهما..) واضح في هذا المجال على الصعيد الأفريقي.
يضاف إلى هذا، وهو العامل الثاني، أن واقع البلدان المستعمَرة، على غير ما كانت عليه البلدان المستعمِرة، بحكم التخلف والتأخر التاريخي عن نموذج الترقي المعلوم، كانت تدعو بصورة واضحة إلى إعمال وعي جديد يبرر النضال الوطني للخروج من التخلف والتبعية بطبيعة الحال، وهو ما سارت عليه مختلف الحركات التحريرية على المستوى الفكري في ارتباط مع تعبيراته الأيديولوجية كـ”السلفية الجديدة” في المغرب، ودعوات جمعية علماء المسلمين في الجزائر، والحركة الثعالبية في تونس وغيرها، وكان الارتباط هنا بالوطنية الوليدة المتصادمة مع أشكال الاستعمار والحماية، مِنْ وَعْيِ واستعدادِ وفعلِ الطبقات الاجتماعية المدينية ذات الاهتمام التجاري والنَّفَس البورجوازي في عمومها.
لهذا وجدنا مفهوم المثقف في كثير من مراحل الصراع الوطني والديمقراطي كذلك متشابكاً، إلا فيما ندر، مع مفهوم السياسي والحزبي والنضالي، فصيغ مفهوم الالتزام بدوره انطلاقاً من الدور التعبوي الذي كان له في هذه البنية، فأصبح لصيقاً بوجوده كما لو كان بديهية أو مسلمة لاختياره. مبدأ الانتماء (إلى الحركة، إلى الحزب، إلى السياق الوطني..) جاء في القاعدة من تلك الصياغة حتى أصبح من يحيد عنها، خلال مراحل الصراع أو السلم الاجتماعي، في عداد المرتد، أو الخائن، أو الفرداني، أو اللّامسؤول… وقس على ذلك. ويهمني أن أشير، بهذا الصدد، إلى أن كثيراً من المبادرات الثقافية في المغرب الحديث ارتبطت، منذ فترة بعيدة وإن يكن على نحو محدود، بهذا الصنف من المثقف المنخرط، إلى حد ما، في السيرورة الاجتماعية المُعَارِضَة (معارضة سلطة الحماية والسلطة الاستقلالية على السواء).
الصراع ضد السلطة القائمة ليس قدراً حتمياً، أو خصيصة متميزة ترتبط بوجود المثقف، بل هو اختيار نابع من وعي وتقدير
هذا ما يفهمنا، على وجه التحديد، لماذا تفاعلت الأحزاب المعارضة في المغرب، خصوصاً بعد الاستقلال، وبالأخص في المرحلة التي أعقبت حالة الاستثناء (1965)، مع الثقافة والعمل الثقافي، وكذا دور المثقف والارتباطات التي يجب أن تكون له ببعض البنيات الاجتماعية ووسائط التداول المرشحة للدفاع عن القيم الإيجابية بشكل عام. ومن المعلوم أن القيم الإيجابية تجلت، في ذلك الإبان، في كل ما كان له علاقة بالنضال ضد السلطة القائمة، وضد سياساتها العامة التي وُصِفت باللّاشعبية واللّاوطنية…إلخ. وهو نفسه الذي يفسر، إلى حدٍّ ما، غياب المثقف الديمقراطي المستقل الواعي بطبيعة إنتاجه الثقافي، وبالأدوار التي يمكن أن تنتج عن إدراكه لمسألة المشاركة، أو النضال، أو الارتباط… إلخ. السياق العام لوجود المثقف هو المجتمع الثقافي، ولا يمكن أن يكون دوره شيئاً آخر غير الإنتاج الثقافي إلا إذا أدرك، بصورة واعية، الأهمية التي يُقَدِّرُها لذلك الدور من خلال تحليل بنيوي لأوضاعه ولعلاقاته وأنماط الوجود فيه. الدور عند المثقف ليس إلا صفة مدركة من خلال الوعي السياسي الاجتماعي، كما أن الصراع ضد السلطة القائمة ليس قدراً حتمياً، أو خصيصة متميزة ترتبط بوجود المثقف، بل هو اختيار نابع من وعي وتقدير… وفي ارتباط مع هذا، وضد كل أسطرة لمفهوم المثقف وطبيعته، يمكن القول إن دور المثقف اليوم، انطلاقاً من وعيه بمعضلات التطوّر الديمقراطي في بلده، ووعيه الأشمل بما يجري في سياقات ومحيطات أخرى، فضلاً عن وعيه بطبيعة النماذج المؤثرة التي صارت أيديولوجيات بديلة للهيمنة المادية المباشرة، يتمثل بصورة خاصة في الانحياز إلى قيم العدالة والحرية والديمقراطية الحقة، فضلاً عن العمل في هذا الاتجاه لمقاومة “الانبعاث” الأصولي المرتهن للإحياء الماضوي وصنوه الآخر في شكله المتطرف الإرهابي الذي يحيق بكثير من المجتمعات في مرحلة تمثل فيها العولمة الشاملة، فيما يبدو، صيغة اقتصادية وسياسية وتكنولوجية لإعادة تقسيم العمل على الصعيد الدولي… هذا فضلاً عن المخططات المتفرعة عن ذلك لإعادة ترتيب الكون وفق المستجدات التي كشفت عنها الألفية الثالثة على جميع المستويات الفكرية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها. أقول هذا في العموم لتأكيد أن بناء تصوّر مشترك عن الأدوار المفترضة للمثقف ضمن مشروع ثقافي معيّن هو من اختصاص العاملين في المجال الثقافي نفسه في ارتباط مع القوى الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي في المسار العام للتطور… وهو للإنجاز المشترك أيضاً بناء على القواسم التي تساعد على التفاعل والحوار وصوغ المقترحات الرشيدة من منظور ديمقراطي على قواعد الاختلاف والتنوع والتعدد، بعيداً عن اللجوء إلى الشرعيات والتعلات الوهمية.
المصدر: العربي الجديد