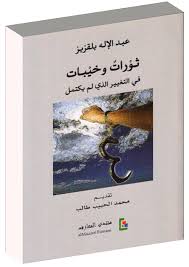
عبد الإله بلقزيز مفكر مغربي معاصر، مواكب للشأن الفكري والسياسي العربي، عبر إنتاج غزير يمتد لسنوات طويلة، وهو علامة بارزة في الفكر العربي المعاصر، قرأت أغلب إنتاجه الفكري والأدبي. قدم للكتاب محمد الحبيب طالب، ينوه بالكاتب وشهادته في مرحلة مهمة ومصيرية في الواقع العربي.
ثورات وخيبات كتاب يطال مرحلة الثورات العربية التي حصلت أوائل سنة ٢٠١١م، في تونس ثم مصر وامتدت إلى ليبيا واليمن والمغرب العربي ووصلت إلى سورية. الكتاب عبارة عن نصوص كُتبت على شكل متابعة شبه يومية للثورات في زمن يمتد لسنة كاملة تنتهي مع نهاية عام ٢٠١١م.
(النصوص) تتحدث عن الثورات بشكل متداخل حسب التطورات في الميدان، وحسب ما يراه الكاتب من تنوير أو رصد أو نقد ما يحصل أول بأول، سنتابع القراءة والنقد لكل تجربة بذاتها، خاصة أن سنوات مضت على الحدث في هذه البلدان وكان لها مآلات مختلفة تتطلب دراسة كل حالة بذاتها.
أولا: الثورة التونسية.
إن حرق محمد البوعزيزي لنفسه في تونس كرد على إساءة الشرطي التونسي، واقعة تتجاوز حالته الشخصية لتكون بداية عصر جديد في تونس والبلاد العربية وانعكس امتداده على العالم. حيث خرج الشباب التونسي ومن خلفهم الشعب متحدين ضد نظام زين العابدين بن علي ومطالبين برحيله، كان ذلك مفاجئا وصادما للسلطة التونسية وعلى رأسها بن علي نفسه، ولم تستطع أجهزته الأمنية ولا شرطته أن توقف الثورة التي ستكون أول ثورات ما سمي الربيع العربي، خاصة مع رفض الجيش التونسي النزول للشارع لمواجهة المتظاهرين، مما جعل بن علي يناشد الشعب ويعتذر له، ويعد بالتغيير والمحاسبة للمسيئين والمقصرين، ولم يكن أمامه أخيرا وبعد ثلاثة أسابيع على الثورة إلا أن يتنحى عن الحكم ويغادر…
يتحدث الكاتب عن الأسباب الذاتية والموضوعية المؤدية إلى ثورة الشباب والشعب التونسي، مؤكدا على تميز الشعب التونسي بنسبة التعليم العالي، والخبرة الحزبية والنقابية، وأن تونس ومنذ أيام رئيسها الحبيب بورقيبة الذي كان أول رئيس بعد الاستقلال عن الفرنسيين، وأنه أعتبر نفسه بمثابة أبا للشعب التونسي، وأنه عمل بدأب ليلحق تونس بالعالم الأوروبي، وكيف كان بن علي وزيره الأول في أواخر أيامه، وكيف انقلب على الحكم وأصبح الرئيس الجديد لتونس.
يوضح الكاتب كيف استغل بن علي القوى السياسية والنقابية اول اطاحته البيضاء بالحبيب بورقيبة الذي كان طريح الفراش، وأنه سيقدم إلى الكل مكتسبات في المطالب الديمقراطية ودولة المؤسسات. لكن ما أن أصبح رئيسا واستتبت له السيطرة على الحكم حتى أظهر استبدادا ومعاملة أمنية مع أغلب القوى السياسية، وألغى نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت تقدم التيار الإسلامي بقيادة راشد الغنوشي، وكيف زج الناشطين في السجون ووضع تونس تحت سلطة الأمن والشرطة وحكمها بالقوة العارية. هذا عدا عن النهب الاقتصادي للبلد حيث أطلق يد عصبته وعائلته في كل المناشط الاقتصادية لتونس وحولها إلى مزرعته الخاصة. انعكس كل ذلك على حياة الناس شقاء وفقرا ونقصا في فرص العمل وانعدام الأفق الحياتي أمام الشعب وخاصة جيل الشباب الذي لجأ الى الهجرة لأوربا حيث سدّت السبل في وجهه في تونس. هذه هي الظروف التي كانت تختمر لتكون الدافع المباشر للثورة في تونس.
يتوقف الكاتب عند الثورة التونسية بصفتها نموذج جديد للثورات في العالم؛ فمن قام بالثورة هم الشباب ومن ورائهم الشعب دون أي تنظيم حزبي او نقابي، كما انهم لم ينطلقوا من رؤية وبرنامج سياسي يتحركون وفقه إلى أهداف محددة، بل كانت الثورة اندفاعة المظلومية المجتمعية ضد السلطة السياسية ورئيسها كرمز لواقع حياتهم الذي يرفضونه. ومن هنا كان الخوف وعدم الوضوح حول مآلات هذه الثورة، التي كان أهون أعمالها (على عظمتها وأهميتها) هو اسقاط السلطة السياسية ورأسها بن علي حيث لم تجب على سؤال مركزي في أي ثورة: ما العمل بعد إسقاط النظام ؟، وهنا كان الجواب الممكن واقعيا وهو دخول القوى السياسية والمدنية على خط تحديد المطالب وتحقيقها، عبر الوسائل المتاحة ضمن خطوط استراتيجية عريضة من خلال تعبيراتها الديمقراطية؛ البرلمان، الدستور، الانتخابات بأنواعها حيث يتبلور مسار الدولة المرجوة، وهنا وجد الشباب صنّاع الثورة أنفسهم خارج معادلة صياغة المستقبل السياسي لتونس. حيث تتنازع القوى السياسية والمدنية على السلطة وفق رؤيتها السياسية والعقائدية المستقبلية، وبعضها متناقض خاصة بين التيار الإسلامي والعلماني في تونس، كان قبول الكل بالخيار الديمقراطي صمام أمان عند التونسيين وفي رسم معالم مستقبلهم، بغض النظر عن قبول الأطراف بما تفضي إليه الديمقراطية الوليدة.
تنتهي السنة الاولى على الثورة التونسية ومازالت التجاذبات في تونس بين الأطراف قائمة، لكنها ستكون مضبوطة بالخيار الديمقراطي للدولة والسلطة والقوى السياسية والمجتمع. وهذا ما يجعلها تتقدم ولو ببطء لتحقيق جوهر ثورة الشباب والشعب التونسي.
ونحن نقول الآن وبعد مضي حوالي تسع سنوات على الثورة التونسية انها استطاعت ان تعبر الى بر الامان، وان تحقق للشعب التونسي الدخول في العصر الديمقراطي، رغم ما يشوبها من أخطاء وعثرات، وهذا طبيعي وجزء من واقع كل ثورة وتجديد سياسي وممارسة مختلفة عن السياق السابق بأي تجربة. مع التأكيد على أن الثورة التونسية ومن بعدها كل ثورات الربيع العربي لم تسلم من التدخلات العلنية او السرية من قوى دولية وإقليمية للتأثير في مسار التغيرات في تونس وفق مصالح كل طرف. وليس سرا أن الربيع العربي وثوراته لم يكن لترضى عنه هذه القوى الاقليمية والدولية، وأن التجربة التونسية موضوعة دائما ضمن امتحان النجاح أو الانتكاس، وأن واقع التجربة للآن هو نجاحها في قيادة المركب الديمقراطي التونسي. حيث استطاعت انجاز دستورها، وانتخابات رئاسية شعبية مباشرة حصلت فيها منافسات وفرص متساوية للمتنافسين، وأن التجربة البرلمانية نجحت في خلق توليفة بين الإسلاميين والعلمانيين وقوى المجتمع المدني خاصة الاتحاد العام للشغل. واستطاعوا كلهم أن يكونوا حاضرين في تجربة بناء الدولة الديمقراطية التونسية على اختلاف اجندتهم وعبر توافقات الخيار الديمقراطي في الممارسة السياسية للدولة والمجتمع.
وهذا عين الديمقراطية المطلوبة.
نستطيع القول ان التجربة التونسية بعد الثورة قد وصلت الى بر الامان وتصنع نفسها اولا بأول.
ثانيا: الثورة المصرية.
لم يكد يمضي اسبوعين على اندلاع الربيع التونسي حتى لحق به الربيع المصري، الذي نزلت به جموع الشباب والشعب بمئات الالاف تملأ الشوارع والساحات مطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك واسترداد حقوقها المهضومة والمسلوبة. كان مبارك قد جاء إلى الحكم بعد اغتيال الرئيس السادات ١٩٧٩م. وكان نائبا له ومن مؤسسة الجيش المصري عينها، تعامل مع السلطة والدولة المصرية بصفتها مزرعته الخاصة، هو و أعوانه وشبكته العائلية، استمر بعلاقته المهادنة والتابعة للغرب وأمريكا بشكل أساسي، استمرّ بالعلاقة مع العدو الصهيوني واعتبرها من ثوابت السياسة المصرية، كما أنه فكر بتوريث الحكم لأولاده من بعده، وبدأ بتجهيز ابنه جمال عبر تدرجه في المواقع السلطوية وصعوده إلى أعلى الهرم، مستفيدين من نموذج وراثة بشار الأسد والده حافظ الأسد في السلطة في سورية. كانت الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل في اسوأ حالاتها، كان الاستغلال ونهب البلاد وتوزعها على أركان الحكم يهيمن على الواقع المصري، لذلك غادر اغلب الشباب المصري الى الخليج أو أوربا وأمريكا باحثا عن فرصة عمل وحياة أفضل. لكل ذلك لم تكن الثورة المصرية مستغربة من منظور التحليل السياسي الاجتماعي. لكن الكاتب يتوقف عند ظروف الثورة العفوية التي لا يقودها تنظيم أو مؤسسة، وبدون برنامج سياسي محدد، سوى اللهم المظلومية التي يعيشها الشباب والشعب المصري.
لم يكن الشعب المصري بعيدا عن ممارسة السياسة المعارضة عبر عشرات السنين، لكن النظام حاصر وقمع القوى السياسية بتنوعها العلماني واليساري والاسلامي (الإخوان المسلمين وغيرهم)، مع اختلاف في الدرجة والحدة. وجعل جميع القوى السياسية المعارضة، في حال عجز عن النجاح أو يغيرون في معادلة السلطة في مصر، لقد كانت أقرب لحالة الفلكلور السياسي المجتمعي، منها لأن تكون قوى سياسية فاعلة وذات حضور مجتمعي. لذلك لم يكن لتلك القوى السياسية أي حضور في الثورة الحاصلة، الا للبعض وبصفة فردية. وبما أن حسني مبارك لم يستطع الصمود أمام المد الثوري أكثر من اسبوعين ورحل هو ايضا، اصبحت مصر أمام استحقاق الجواب عن السؤال: من يحكم مصر؟، وما هي اجندة الحكام الجدد. وهنا وقعت الثورة أمام مفارقة مهمة أن الشباب يقومون بالثورة، والأحزاب هي من تجني ثمار الثورة وتعمل لأن تقود التغيير وفق أجنداتها الخاصة.
ستمضي السنة الاولى للثورة حيث ينتهي الكتاب بتوثيقه، والحالة المصرية تراوح بين قوى سياسية تصارعت على اجنداتها العقائدية وبرامجها السياسية. وبما أن المجتمع المصري والسياسيين مستقطبين بين الإسلاميين والعلمانيين حول كل الأمور، ظهر ذلك في البحث في الدستور الجديد وكذلك في البرلمان المنتخب وفي العمل لانتخابات الرئاسة. ولأن الإسلاميين أكثر تنظيما وحضورا فسيكون لهم الغلبة في هذه الاستحقاقات.
ينتهي الكتاب بعد سنة من اندلاع الثورة والحالة في مصر غير متبلورة لكن تحمل فيها صراع مختفي وظاهر على صورة السلطة القادمة وكعكتها.
ونحن نتابع ما لم يتحدث عنه الكتاب وذلك بعد مضي تسع سنوات على الثورة المصرية الآن في عام ٢٠٢٠م.
التطور الميداني في الثورة المصرية:
لم يمض العام الأول على الثورة المصرية حتى كانت قد أنجبت دستورا جديدا واُنتخب برلمانا، كما انتخبت محمد مرسي رئيسا للبلاد، كل ذلك حصل وكان اللون الاسلامي طاغي في هذه الانجازات. كل ذلك كان مقدمة اصطفاف تصادمي أضر بالثورة المصرية وبالشعب المصري من بعد ذلك. هذا الاصطفاف العلماني الإسلامي الذي عمل لخلق تعبيراته في الميدان. كان ذلك مدخلا ساعد القوى الخارجية الاقليمية وعلى رأسها (اسرائيل) وبعض دول الخليج، كما أمريكا والغرب الأوربي، الذين وجدوا كل من موقعه ومصلحته، أن الثورة المصرية قد أسست لما يضر بمصالحهم ووجودهم في مصر والبلاد العربية على المدى الاستراتيجي، وهذا دفعهم للنفخ في نار الفرقة والصراع، سواء داخل الشباب الثائر وعبر الميادين، ومن خلال العمل على استعادة دور الجيش المصري ليكون أداة إسقاط الثورة المصرية. خاصة وأن الجيش في بداية الثورة آثر أن يأخذ موقف الحياد ولم ينزل الى الميادين مناصرا لنظام مبارك كما فعل الامن السياسي والشرطة، وأنه رعى العملية الديمقراطية التي حصلت في السنة الاولى للثورة. لكن التطورات بعد ذلك، أعادت الجيش ليكون الفاعل الأول في الانقلاب على الثورة من خلال دور وزير الدفاع إبن المؤسسة العسكرية عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الثورة واستند على الحراك الذي حصل في الميادين في مواجهة اسلامية السلطة الجديدة، والذي سمي (ثورة التصحيح)، والتي أعادت الحالة في مصر إلى ما كانت عليه في عصر مبارك؛ ملغية الدستور الجديد وحلّت البرلمان المنتخب وأسقطت الرئيس المنتخب محمد مرسي وسجنته، وأدخلت البلاد في لعبة انتخابات رئاسية جديدة بقوة الجيش؛ نصبت عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر الى فترات متتالية لعشرات السنين. لقد أعاد الجيش تمركزه في السلطة وتقاسم المغانم واستمرت التوافقات الدولية والاقليمية من حيث العلاقة مع العدو الصهيوني والحضور الأمريكي والغربي، وكذلك الدعم المادي من بعض دول الخليج. طبعا حصل كل ذلك وكان ضحيته المباشرة الشباب الثائر في الساحات وحصلت مذابح لفض الاعتصامات مثل اعتصام رابعة وغيره. وانعكس ذلك على الشعب المصري الذي أُعيد الى دوامة الركض وراء لقمة العيش العصية على أغلب الناس. مضاف لذلك الظهور الكاريكاتوري للرئيس المصري السيسي الذي أبّد سلطته وبرر سوء المعيشة للشعب المصري. وكان من المفارقات المؤلمة أن يحاكم أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بالعصر الحديث ويموت أو يقتل وهو يحاكم. وأن يبرأ مبارك واولاده واركان حكمه على آلاف الانتهاكات في الارواح والاملاك بحق الشعب المصري للأسف.
كانت الثورة المصرية بارقة نور في سماء مصر والعرب، وهي عتبة مهمة في السياق التاريخي للانتقال مجددا الى مربع المطالب المشروعة للشعب المصري بالدولة الديمقراطية، لتحقق لكل الشعب حقوقه بالحرية والكرامة والعدالة والحياة الافضل، اسوة بكل الامم التي سبقتنا إلى ذلك.
لا حل آخر.







