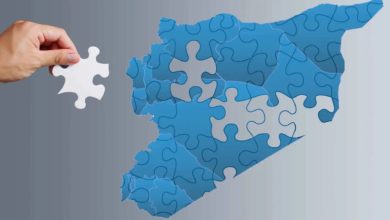بعد دراسات مقارنة مابين القبيلة والطائفة، يمكن القول بوجود نقاط تشابه واختلاف بين كل من البنيتين مثلما هناك اختلاف في الدور الذي تلعبه كل منهما. يمكن تتبع نقاط محورية على صعيد البنية والفاعلية والدور؛ تعتبر مؤشرات تفيد في فهم أكثر قربا لواقع كل منهما. حيث يتوزع الثقل الرمزي والسلطة لكل بنية منهما بين مركزين منفصلين أحدهما الشيخ وثانيهما المقدم أو الأمير أو القائد، غالبا ما كان منصب الشيخ متوارثا، سواء كانت المشيخة قبلية أم دينية كما لدى الطائفة، أما المقدم فهو شخصية اجتماعية أو عسكرية أو سياسية، قد يبرز دورها أكثر من الشيخ والمرجعية الدينية، تبعا لعلاقته مع السلطة منذ العهد العثماني.
يحسب للطائفة أنها احتملت وجود المقدم مع تبادل الأدوار مع المشيخة حتى زالت الحدود بينهما وبقيت المرجعية الدينية مستقلة أو محايدة بعيدة عن الدور السياسي. في حين أن القبيلة عجزت فيما بعد عن تظهير قائد أو مقدم لها وفقا لحسابات المشيخة القبلية وأنساقها، بالمقابل غالبا ما تحولت المشيخة الدينية لدى الطائفة إلى تابع للمقدم أو القائد، وعند ظهور قائد/مقدم جديد ينقلب على القديم، أو يستفيد من جملة عوامل داخلية وخارجية فيخضِع مشيخة الطائفة له لتكون أكثر استجابة لتطلعاته، وقد يستبدلها بأخرى، وقد حفلت الطائفة الدرزية بإمكان التغيير والتنافس والثورة على المشيخة تبعا لصراع المصالح، والصراع الطبقي بين الفلاح والإقطاع منذ القرن الثامن عشر، وكلنا يعلم موقف الدروز قبل قرن ونيف من الحناوي المقدم والشيخ القبلي ورؤية القواعد له، كالإقطاعيين من آل حمدان والحناوي أنموذجا، والثورة الداخلية التي أعلنها سلطان الأطرش وبعد انتصاره قبلت به مشيخة العقل وسعى لاستبدالها وفقا لروايات أبناء الطائفة، ولا يغيب عن أحد قيمة التأطير والتكريس الذي تبديه وتسوقه أي قوة اجتماعية ناجزة ضد قوة صاعدة قد تنافسها، فتمكن الأطرش من إزاحة آل حمدان وتَبوُّءِ الرياسة وقد عبر الأطرش في لحظة ذروة تاريخية عن أحلام كثير من الفلاحين، وبعد استلامه زمام الأمور في الجبل أعاد إنتاج العائلة الإقطاعية من جديد؛ هنا لا يمثل الإقطاع جزءا من سياق عام بل النفوذ والسلطة وإمكان الاضطلاع بدور يقاس نسبة لسياقات العمل الدولتي حينها، وقد حاول القنصل الفرنسي في سوريا اللقاء بالمشيخة الدينية ومنع من اللقاء بمشيخة العقل من قبل آل الأطرش حينها، ما يدل على قدرة التحكم والضبط من قبل المقدم أو الوجيه أو الشيخ القبلي ذي المكانة الاجتماعية؛ خارج إطار المشيخة الدينية على ضبط كثير من الفعل في محيطه، من هنا نجد إمكان انفتاح الوسط الدرزي على فاعلين حقيقيين ونخب جديدة تلعب دور المقدم وهي النخبة السياسية والمثقفة، من دون أن تحارب المشيخة الدينية بل تستبدلها بتظهير قيادة عقل جديدة، ضمن مشيخات معتدلة موجودة في الساحة، وهي بذلك تضمن بقاء قوة التحشيد الديني منضبطة ضمن إطار وطني يتفق وأهداف النخبة الجديدة التي تلعب دور المقدم، يتحول شكل المقدمين هنا والقادة من أفراد إلى موجة أو حالة ثقافية ووطنية يحملها كثير من ناشطيهم ومثقفيهم شرط قدرتهم على تجاوز التحشيد المضاد والوصول للقواعد الشعبية.
تُحدِثُ معظم الهزات التاريخية التي تلم بمنطقة أو دولة تغيرا في موازين القوى دوليا ومحليا، ويعقبه أو يسبقه أحيانا تغير في موازين توزع القوى المشيخية والجهوية في البيئات المحلية
تُحدِثُ معظم الهزات التاريخية التي تلم بمنطقة أو دولة تغيرا في موازين القوى دوليا ومحليا، ويعقبه أو يسبقه أحيانا تغير في موازين توزع القوى المشيخية والجهوية في البيئات المحلية، يرتبط هذا التغير بسرعة استجابة المرجعيات الاجتماعية والدينية هذه ومرونتها في تحسس التغيير وبالتالي يمكن لقبيلة أو طائفة وهما تسيران بنفس الوتيرة تقريبا والناظم الذي يجمعهما هو الموقف من التغيير وسرعة الاستجابة لهذا التغيير أو ذاك فيتحرك كل منهما تحت عنوان الحفاظ على مصلحة الجماعة إلى تغيير بالموقف يضمن بقاء المرجعية والمشيخة، هذا مالم تكن المشيخة أصلا منقسمة بمبدأ توزيع الأدوار بين مع وضد ليكون الموجود في الطرف المنتصر ضامنا للخاسر، نجد ذلك قبليا في موقف حاكم بن مهيد ومقاومته لفرنسا وأخيه مجحم بن مهيد الذي أقر باحتلال فرنسا لسوريا وعمل كقائد محلي معترف به، وتوسط لصلح أخيه معها بعد خسارة الأخير للدعم التركي حينها. لا يمكن الجزم بوجود اتفاق بين الأخوين ولا يمكن التقليل من قيمة المقاومة التي اتخذها المقاوم منهما؛ لكن عرف القبيلة يقضي بعدم ضرب الطرف الخاسر في أقل تقدير مثلما يلعب الموجود في الطرف المنتصر دوراً في أن يهيئ هدنة أو صلحا يجنب السلطة المنتصرة مغبة مقاومتها فيما بعد.
بعد عقود من صناعة المشيخة والمرجعية الدينية في البيئة العلوية، وتفتيت جبهة رجال الدين العلوي الأقدمين عمل الأسد على تعويم متقاعدي مخابرات ومؤيدين له؛ ليصبحوا مشايخ دين تحتكر تمثيل الطائفة بما يتفق وسياسته، ولعل ذلك يذكرنا بعرف درجت عليه بيئات اجتماعية كثيرة في استتباع المقدم/ للمشيخة إن لم يستطع استقطابها.
وفي خلاصة مبسطة حول القبيلة والطوائف في سوريا يمكن القول أنه لدى الطائفتين العلوية والدرزية يظهر جليا وجود هوة بين توجه المثقفين من ذوي نهج الدولة الوطنية ويتبعه عامة قواعد كل من البنيتين من البسطاء من خارج ضحايا التحشيد؛ وبين موقف المرجعية الدينية باعتبار كل من المرجعيتين متأخر كثيرا عن موقف الشارع الثائر ضمن البنيتين؛ ولعبت على عقدة الخوف؛ وكل مظهر تشهده الساحة السورية ماهو إلا نتاج تمكن كل طرف من التعبير عمن يمثله مابين الشارع والتكية والزاوية، سواء اتسع هذا الشارع أو كان هامشيا، أما في الطائفة الإسماعيلية فقد أبدت موقفا مدنيا بعيدا عن أطر التحشيد السابقة، ومثلت دورا وطنيا وازنا كتبت عنه صحف غربية، ويحتاج تسليط الإضاءة عليه ودراسته عن قرب.
إن القبيلة تخلت أو عجزت عن طرح نفسها كشريك سياسي، في حين تقدمت الطائفة كقبيلة – وفقا للتصور النمطي عن القبيلة- لتطرح نفسها كشريك سياسي، وظهر أنها تحاول أن تكون كيانا سياسيا ماقبل دولتيّ لا بنية اجتماعية؛ مستغلة امتلاكها إطار تحشيد ينبع من رصيدها الاجتماعي، والديني الخاص بها كذهنية تفارق عن الآخر وهوية مفارِقة سياسيا، هنا يبدو افتراق المثقفين من ذوي التوجه الوطني من أبناء الطائفة عن تلك الأطر وازنا؛ لكنه قوبل بنفس الوقت بمثقفين اتفقوا مع أطر التحشيد تلك؛ وصاروا جزءا منها لصالح المشيخة الدينية. هنا يتم تغييب المشترك الديني العام مع الآخر، وتظهير موقف التفارق بآلية وعصبية قبلية، ويمكننا القول أن العصبية هنا دينية لدى جزء من الطائفة، وهوياتية لدى جزء آخر لم يدرك معنى انغمار الجزء في الكل الدولتيّ وضرورة عدم التناقض معه، وقبلية لدى قسم من المثقفين العلمانيين الذين انخرطوا في أطر التحشيد التابعة للمشيخة رغم كونهم غير مؤمنين.
إن العمل الوطني عبر منظمات مجتمع مدني سورية حديثة، إضافة لنشاط أحزاب جديدة، لابد وأن يؤدي لانزياح تدريجي عن الرؤى السابقة عبر تأطرها في مشتركات عامة تيارية ملتصقة بالواقع السوري؛ المتفق مع مرحلة البناء وغير المتعالي على المرحلة، والكفيل بضخ دماء جديدة في الأفق السياسي، كما ستلعب البرجوازية الصاعدة دورا مهما ووازنا يخترق سائر البنى التقليدية لتنحسر إلى مستواها الرمزي وتترك السياسة لأبنائها لتحقيق دولة المواطنة والتعدد والحريات.
المصدر: تلفزيون سوريا