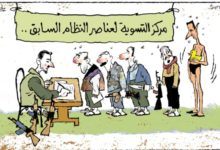يتعلق الأمر في العنوان بأحد رجالات النضال الوطني المغربي التقدّمي الذي جَسَّدَ، بسلوكه السياسي وتجربته النضالية الطويلة، مَسِيراً قلّ أنْ تَحَقَّق لغيره من المعارضين، إلا على نحو جزئي، في ثلاثة أشياء متداخلة، أعرضها دفعة واحدة من دون تفصيل: الميل إلى المساومة والدفاع، العمل بالمفاوضات والإعلام، الوعي النقدي والإقرار بالغَلَبَة. وإذا أضفتُ إلى هذا، وهو منه، ارتباطه الأكيد منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بالحركة الشاملة للمعارضة السياسية المغربية، ولعله كان واحدا من قادتها والفاعلين في أحداثها سياسيا وإعلاميا (رئيس تحرير صحيفة “التحرير”)، فلا مفرّ من الإقرار بأنه أبلى البلاء القوي، بتضحياتٍ غير محسوبة منذ استقلال 1956، في مواجهة النظام السائد، وإنْ بدرجات مختلفة من الوعي شابتها مساوماتٌ غير مجدية، ثم انتقل بحركة راديكالية فأصبح من المناضلين المحترفين في المنفى، خصوصا بعد اغتيال الزعيم الأممي المهدي بن بركة، فأشرف على أجهزة ثورية في المواجهة، وَمَثَّل الحركة التحريرية في محافل كثيرة، ورافع عن قضية الثورة في المغرب داعيا إلى القضاء على النظام الملكي الذي عاداه وهجّره وطارده في المنافي. والأهم، وهو ما أريد الوصول إليه، أنه ساهم، كما كتب ونشر بعض رفاقه في الحركة الثورية، في الانقلاب عليه بِدَوْرٍ معيّن، وأصبح لا يُذْكَرُ هذا، إلى جانب أفراد من قيادة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلا من خلال “التنسيق”، غير المباشر ربما، مع جنرال عسكري كانت أفعاله القمعية الإجرامية موشومة على أجساد “اتحاديين كثيرين” قبل غيرهم، ولم يكن الهدف، الصريح أو المبيّت، إلا الانقلاب الفاشل في 16 أغسطس/ آب 1972.
غير أن الانقلاب الحقيقي في حياة هذه الشخصية كان، في الواقع، على علاقة بموقفين بارزين، هذا مع وجود مبرّرات أو عوامل أخرى مختلفة لعبت أو أثرت في ذلك. أعني، في الموقف الأول، أن المنظور الذي تبلور من خلال المعارضة الشاملة والمطلقة للنظام الملكي، وتجسّد بصورة فعلية وحركية في مشروع “الثورة”، من خلال التنظيم السري والكفاح المسلح، وقد قاده اليوسفي مع الفقيه البصري وآخرين. لم يوفق في بلوغ ما خطّط له وعمل من أجله على أي نحو فعلي، أي تحقيق تلك الثورة من خلال القضاء على النظام الملكي، وبناء الجمهورية بديلاً استراتيجيّاً متصوّراً، وربما أيضا على النمط الذي كانت عليه الجمهوريات القومية في المشرق العربي (العراق، سورية، مصر…) والمغارب (ليبيا، الجزائر..)، وهو النموذج الأقرب إلى المخيلة “الاتحادية” في تلك المرحلة. ومن الوارد أن يُقال فيه إن النخب المغربية التي حلمت به وحملته لم تتمكّن، في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، من تنفيذه كما جرى في تونس مع البايات الحسينيين على أيدي الحبيب بورقيبة وصحبه.
لم يوفق اليوسفي في بلوغ ما خطّط له وعمل من أجله، أي تحقيق الثورة من خلال القضاء على النظام الملكي، وبناء الجمهورية بديلاً استراتيجيّاً متصوّراً
ولو شئتُ أن أضع تاريخاً فعلياً لنهاية الاختيار الثوري في معرض الحديث عن الموقف الثاني البارز، فلن يكون إلا في علاقة بالانتفاضة المسلحة التي نفذت في الأطلس المتوسّط، وظروف تنفيذها محفوفة بكثير من الأسرار والقضايا الخلافية والمشاكل الحقيقية الناتجة عن سوء التقدير والتنسيق، والمقصود هنا هو تاريخ 3 مارس/ آذار 1973، زمن انطلاق العملية العسكرية وفشلها في اليوم نفسه. ولن أتكلم عن الخسائر والضحايا، فعلى ذلك ما يفيد من الكتابات وشهادات الناجين منها، ولأن الكلام المفيد، في ارتباط مع شخصية عبد الرحمن اليوسفي، هو المتعلق بالنتائج الفورية التي تسبّبت فيها تلك الأحداث على الصعيد الداخلي، صعيد الاختيار الثوري، الحامل والحابل بالمشروع. وفي علاقة بهذا بالدور القيادي الذي كان له، اليوسفي نفسه، في حركته، وإن كان الفقيه البصري هو محرّكه والمسؤول المباشر عنه إلى أن طرد منه. ذلك أن فشل الثورة المسلحة، وقد رآها اليساريون الشباب في تلك المرحلة مفاجِئة ونعتوها بـ”البلانكية” (من له الحديد له الخبز)، أنهت بصورة فعلية وجود الحركة الثورية، بعد أن حكمت عليها بالإفلاس التام، انطلاقا من الفشل الذي مُنيت به في المواجهة. والمقصود بالإفلاس أنه سياسي وأيديولوجي وتنظيمي دفعة واحدة: برزت تناقضات كثيرة مُخَرِّبَة، كما لم يتوقع كثيرون من المنتمين إلى الحركة، رغم انتقادهم سلوك الفقيه البصري وأسلوبه في إدارة معارك التحرير، وتهاوت مواقع كانت فعلية تحت ضربات القمع الوحشي، فانتفى وجودُها بما كان فيها من سلاح، أو اعتقل من كان يتولاها وغُيّب وجوده إلى الأبد. وفوق هذا، أصبح اليأس الشعور الدائم بالعجز عن القيام بأية مبادرة في الاتجاه نفسه. هنا برز النظام الملكي، الذي أريد إطاحته، ليؤكد لمن شاء أن يقتنع بالتأكيد المتاح أن القبول الآخر لن يكون إلا بالشرعية والموالاة و”البركة” الراعية للأسرة الحاكمة، ولنظامها السياسي في قيادة البلاد.
يمكن الظن أن عبد الرحمن اليوسفي، على هذا الأساس، كان أول المنتقدين، وأول اليائسين، وأول القائلين بالاستحالة، وأول من قاد الجيل الاتحادي الذي سانده إلى عهد جديد في إطار انتقال الملك، فأنهى به مشواره وحياته السياسية على جميع المستويات، بما في ذلك يوم “الخروج” من الحكومة، بعد استغناء الملك محمد السادس عن خدماته، الذي سمّاه، لاسترضاء المعارضة الحزبية، بالخروج عن “المنهجية الديمقراطية”. فبين مارس/ آذار 1973 ومايو/ أيار 1998 تمكن اليوسفي، بناء على تجارب عملية ومنظورات سياسية إصلاحية وثورية، أن يشكل مصيره الشخصي وفق قناعة مختلفة، أصْطُلِحُ على تسميتها: مقولة الشرعية، التي هي بالأساس مبدأ الاعتراف بأن الوعي النقدي، الذي مني بالفشل التاريخي، المبرّر السياسي والأيديولوجي للقبول بالأمر الواقع.
هذا استنتاج عام أيضا حَوْصَلَهُ اتحاديون مِنْ هزيمةٍ، فأصبح موقفاً دان به معظمهم من جيل عبد الرحمن اليوسفي، إلا مَنْ مات منهم في المعارك التي قادوها أو شاركوا فيها، وكثير من هؤلاء، ومن اليساريين بعامة، وقّعوا به على صكوكٍ يمكن تسميتها من الناحية الرمزية “صكوك الغفران”، ولو أن المحمول المسيحي لهذا التعبير يثقل الفهم السياسي بالإيحاء الديني الذي لم أقصده بتاتا.
كان اليوسفي مقتنعاً بأن المرحلة التي كان يجتازها المغرب، بعد فشل أهم المحاولات لقلب أوضاعه، تتطلب استقراراً معيّناً
والذين راهنوا على أن يقوم عبد الرحمن اليوسفي بالنقد الذاتي من تلقاء نفسه، تماما كمراهنتهم على غيره من القادة الاتحاديين في ذلك، لم يدركوا، في ما أتصوّر، أن المناضل التقدّمي المعارض، وقائد ما عرف بـ”التناوب التوافقي”، كان في حِلٍّ منه. وقد يكون خامره في لحظات إحراج، أو شقاء وعي، ولكنه، فيما يبدو، لم ير أية ضرورة تدعو إليه، لِمَا قد ينتُج عنه من تأويل خاطئ لتجاربه المختلفة في الحقل السياسي وغيره. ولكن المثير، مع ذلك، أنه بسط أطوار حياته النضالية بإسهاب في حوارات واستجوابات نشرت، فيما بعد، في كتب ضخمة. وتقديري يقول إن اليوسفي كان متصالحاً مع القناعة التي تبلورت في تجربته العملية، بل ومقتنعاً، على نحو ما، بأن المرحلة التي كان يجتازها المغرب، بعد فشل أهم المحاولات لقلب أوضاعه، تتطلب استقراراً معيّناً قد يكون في حَلٍّ عادلٍ قِوَامُهُ التسوية. والمشهور أنه كان “الرجل المناسب” لقيادة مرحلة انتقال الملك في اتجاه تغيير بعض الأوضاع الاستثنائية التي تسبّب فيها النظام القائم واستفاد منها لترسيخ حكمه المطلق.
لعل عبد الرحمن اليوسفي كان براغماتيا بالمعنى الحصري الذي له في علم النفس العصبي، أي مفاده: الشخص الذي لا يختار فكرة ما إلا إذا كانت بالنسبة إليه جيدة، فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق العملي، وبالنتائج المفيدة التي تترتّب عنها. وينطبق هذا بصورة خاصة على المرحلة التي اقتنع فيها اليوسفي، بصورة نهائية، بأن تجاربه السابقة، في السياسة والكفاح والحياة، لم تكن كلها مُجدية، فتحوّل مع التحوّلات التي مَسَّت تنظيمه واستراتيجية كفاحه، ومسَّت المغرب ونظامه السياسي الاستبدادي، ومسَّت الحياة السياسية بفعل الصراعات التي لابست مختلف البني الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وسوى ذلك، فكان عليه، حسب منطق التحولات وتفاعلاتها، أن يصبح من دُعاة الشرعية التي انعقدت للنظام السياسي السائد، لضمان الاستمرار والاستقرار، منذ التصويت الجماعي تقريباً على الدستور الممنوح لسنة 1996. أما ما تلى ذلك، فلم يكن، حسب الوعي المكتسب الجديد، إلا من قبيل تحليل التحولات، في تلك المرحلة، على ضوء ميزان القوى المحلي والدولي، أخذاً بالاعتبار الاختيارات المطروحة التي ترافقت معها، والتي في معانيها، بشكل عام، أن التطور الإنساني، عندما يبلغ مداه من الأزمة البنيوية، يُفْرِجُ، من جانب، عن تسوياتٍ واتفاقاتٍ تاريخية كبرى أو صغرى بين الأطراف المأزومة، تكون في اتجاه المستقبل لتجاوز الماضي الذي عيش كله، أو أغلبه، في مِحَنٍ خاصة وعامة، ويسعى من الناحية الأخرى وفي الآن نفسه بما يضاد ذلك، أي إبطال عناصر الثورة التي تحتشد عادة في مناخ الأزمة وفي عقول المأزومين.
المصدر: العربي الجديد