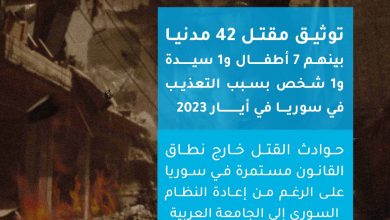هناك فكرة رئيسة أكَّدت أهميتها مرّات عدة، منذ آذار/ مارس 2011، تتمثَّل بأهمية السياسة وبناء الحقل السياسي، وأولويته على أنواع النشاط الأخرى، ولا سيَّما في لحظة سياسية تتطلَّب تصنيع بديل سياسي لما هو قائم. لكنَّ أوهام إسقاط النظام في سورية سريعاً، على طريقة ما حدث في ليبيا ومصر، كانت قد سيطرت على الوعي العام، ولا سيَّما وعي الأغلبية من “النخبة الثقافية السياسية” السورية، ما أدّى إلى الإعلاء من شأن الثورة والحطِّ من قيمة السياسة أو النظر إليهما بوصفهما قطبين متعارضين. وفي مرحلةٍ لاحقة، أصبح صوت السلاح هو الأعلى (اختزال الثورة بالعسكرة) ردًّا على جرائم السلطة السورية، ما منع السوريين من فرصة التأمل في مسار ثورتهم وإعادة ترتيب أوراقهم استعداداً لمواجهة من نوع آخر، مواجهة حقيقية وفاعلة. لكن بدءًا من أوائل عام 2014 على أقل تقدير أصبحنا أمام حالة من الإفلاس السوري العام الذي تجلَّى بتكرار التجارب المحكومة سلفًا بالإخفاق، وبالإصرار على السير في الطرق المسدودة وغير المنتجة ذاتها.
على المستوى السياسي، كان جميع ما أنتجه السوريون ينحشر في الاستجابة للحظات سياسية مؤقتة وحسب؛ أي استجابة لمعطيات ومتطلبات إقليمية دولية في لحظة ما، ولذلك لم يكن لدينا منتوج سوري واحد لديه القابلية الذاتية للاستمرار والفعل، ما حوَّلنا تدريجيّاً إلى أداة بيد الخارج. يمكن تسمية هذا النمط من الأداء السياسي بالممارسة التجارية للسياسة القائمة على الفهلوة والشطارة واقتناص الفرص في لحظةٍ ما، بينما تسعى الممارسة الصناعية للسياسة، إن جاز التعبير، لبناء أعمال متأنية لديها القابلية لإحداث التراكم، ولديها القدرة على الصمود، ما يحوِّلها تدريجًا إلى جزء أصيل من الواقع ومن ميزان القوى.
يعلم من يتوافر لديهم حدٌّ أدنى من المعرفة بالنظام السوري أنَّ طبيعته لا تسمح بالتفاوض، وأنَّ موافقته المعلنة في لحظةٍ ما تأتي في سياق تلبية بعض الضغوط الخارجية عليه، ليلجأ بعدها إلى المماطلة منتظراً توافر أوضاع وأحوال دولية إقليمية تسمح له بالتنصّل من أيِّ التزامات. ولا بدَّ من الإقرار بخبرته الواسعة في التفاوض والمناورة والالتفاف وتجنّب الضغوط. ويمكن القول إنَّ أيَّ مفاوضاتٍ بين النظام والمعارضات السورية ستكون مشابهة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين (والعرب عموماً) إن جاز التعبير، من حيث آلياتها ونتائجها، فهو يسعى دائماً إلى خفض مستوى ما سيجري التفاوض بشأنه، فيفاوض الدول والمعارضات على “إزالة آثار عدوانه” في أحسن الأحوال، أي التفاوض على النتائج التي ترتبت على عدوانه على السوريين بعد مارس/ آذار 2011 وحسب؛ مثل: عودة اللاجئين، الإفراج عن عدد من المعتقلين، الإعمار… إلخ، وليس التفاوض على وجوده وبنيته وطبيعته، طامحًا إلى تحويل المعارضات إلى مجموعات مشاركة في “مكافحة الإرهاب”، تماماً كما عملت إسرائيل على تحويل السلطة الفلسطينية، برضاها أو رغماً عنها، إلى دورٍ كهذا. هذا يعني أنَّ باب إحداث التغيير من خلال التفاوض كان مغلقاً، وسيظل كذلك، بحكم موازين القوى التي تميل بقوة إلى مصلحة النظام، ولا سيَّما أنَّه بدا واضحاً، منذ خمس سنوات على الأقل، أنَّ المسار العام للوضع السوري يذهب في اتجاه عودة سيطرة النظام على كامل حدود الدولة السورية بالتوازي مع التطبيع العربي والإقليمي والدولي المتدرّج للعلاقات معه.
إدراك المسارات العامة للواقع أمر مركزي كي نغادر ساحة الأوهام والشعارات. لقد جرّ النظام السوريين إلى العسكرة وانجرّوا معها، لأنه يعلم بعدم قدرتهم على مجاراته في هذا الميدان، ولا شك في أنَّ استنفار الطاقة كلها في هذا الميدان، بما فيها طاقة “النخب الثقافية السياسية”، واختزال الثورة إلى فصائل إسلامية مسلحة كان عملاً ينتمي إلى دائرة الحماقة، وقد حطَّمها تدريجاً، لأنه لم يترك أي مساحة أو أهمية للعمل السياسي/ المدني المنظّم أو لأيِّ عملٍ آخر، فعندما تحقَّقت الهزيمة العسكرية لم يجد السوريون بين أيديهم ما يمكن أن يسند طموحهم إلى دولة وطنية ديمقراطية. لا توجد سوى غرف الواتس وبعض المؤسسات التي قد تطير بنفخة.
هذا يعني اليوم ضرورة الإقرار بأنَّه لا توجد حلول سريعة للكارثة السورية كما نرغب ونشتهي، ومن ثمّ يغدو مهمًاً تأكيد أهمية الأعمال التأسيسية، لكن هذا لا يعني حكماً إدارة الظهر للحظة الراهنة والابتعاد عن العمل فيها، بل يعني الاقتناع بأنَّ أيَّ أعمالٍ نبدأ بها اليوم لن تثمر سريعاً، فلسنا الفاعلين الوحيدين في الواقع السوري، ويعني أيضاً أن نضع في حسباننا ضرورة تحسين ميزان القوى الوطني العام؛ يحشر بعضهم ميزان القوى في الحيز العسكري، في حين أنَّ المطلوب هو تعديل ميزان القوى بمعناه الشامل: بالدرجة الأولى والأهم سياسيّاً وثقافياً وإعلاميّاً ومدنيّاً. ربما سنكون أمام حلٍّ تسووي، عاجلاً أم آجلاً لمصلحة النظام السوري، لكنه سيكون حلًّا مؤقتًا بالضرورة كونه لن يقترب من المشكلة المركزية، ما يعني أهمية تصنيع مسارات تغيير حقيقية مغايرة لمنطق الحلِّ التسووي ونتائجه التي لا تصبُّ في مصلحة سورية والسوريين.
المسار الثقافي التنويري؛ سورية في حاجة إلى مبادرة نوعية من مجموعة من المثقفين السوريين المهمومين بالشأن العام لإطلاق سيرورة صناعة رأي عام سوري بشأن عدة قضايا ذات العلاقة ببناء الهوية الوطنية الديمقراطية السورية، وصناعة الروح الوطنية وتحفيزها، وتقديم رؤى عقلانية تجاه قضايا خلافية تتسبب بتشظي الحقلين، السياسي والمجتمعي، وتمزّق الروح السورية، مثل قضية الإثنيات والقوميات وقضية العلاقة بين الدين والدولة، إضافة إلى انتزاع دور رئيسي في مراقبة أداء الحقل السياسي السوري.
المسار السياسي؛ من الحكمة أن نركِّز بوصلتنا على إعادة بناء السياسة بوصفها مسألة جوهرية، فأول الحياة سياسة وآخرها سياسة. لعل أهم ما يمكن القيام به في هذا السياق بناء حقل سياسي سوري متماسك له قواعده ومحدِّداته وضوابطه ومحرّماته التي تنظِّم العمل السياسي، وتراقب أداء العاملين في الحقل السياسي، ولا سيَّما بعد سيطرة قانون التشظي والتفسخ أكثر من عشر سنوات. على الرغم من أن القوى السياسية الحاضرة في المشهد السوري صغيرة وضعيفة في معظمها، وعلى الرغم من أوزانها وأدوارها غير الفاعلة حاليًا، إلَّا أنَّ بناء الدولة الوطنية والنظام الديمقراطي يتوقّفان، في الحصيلة، على نمو القوى السياسية وفاعليّتها.
المسار المدني؛ لا تشكِّل المنظمّات القائمة مجتمعاً مدنيّاً سوريّاً حقيقيّاً، لأنَّ أغلبية المنظّمات السورية الحالية تفتقد صفتي الكفاحية والتطوّعية المركزيتين في صناعة مجتمع مدني؛ فكثير منها أقرب إلى بنية الشركات الخاصة وأدائها بحكم أنَّ أعضاءها جميعهم موظفون، ويكاد يقتصر المستفيدون منها على أعضائها وحسب، وتذهب نتائج عملها غالباً إلى الداعمين، ولا تؤثر في، أو تتفاعل مع، المجتمعات السورية التي تعمل فيها، فضلاً عن تشظّيها وتأثرها باعتبارات دينية وطائفية وإثنية وأيديولوجية.
المسار الاقتصادي؛ تحتاج سورية إلى ما يشبه المعجزة الاقتصادية، ولا شك في أنَّ أي عمل يخدم في تنظيم صفوف الاقتصاديين ورجال الأعمال السوريين، وتشاركهم على أساس الوطنية الديمقراطية من جهة، ورسم مسار لنهوض اقتصادي سوري ومستلزماته من جهة أخرى، يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة الكارثة.
المسار العسكري؛ تشكّل عملية بناء جيش وطني سوري موحّد جزءاً مركزيّاً من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، لأنَّ الجيش هو إحدى أدوات إخراج الجماعات المسلحة والجيوش الأجنبية، وضمان سلامة الأرض السورية، لكن عملية بناء هذا الجيش ستكون، اليوم ومستقبلاً، رهينة الصراع الإقليمي الدولي ومتطلباته، ما لم تحدُث مبادرة عسكرية سورية، بدفع من الحقول السياسية والمدنية والاقتصادية السورية، لضمان قيام الجيش بدوره المأمول المتوافق مع النظام الوطني الديمقراطي.
أخيراً، لا شك في أنه سيكون لتماسك هذه المسارات وتنظيمها دور في تعديل ميزان القوى نسبيّاً، وسيؤثر في مسارات اللحظة الراهنة، في حال حدوث تفاوض، ولو بدرجة بسيطة، على وقع ضغوط إقليمية ودولية بدرجةٍ ما، لكن بالتأكيد سيكون له الدور الأكبر مستقبلاً في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية والروح السورية.
المصدر: العربي الجديد