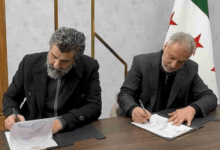لا تتمتع هذه القصة، المنسوبة إلى عمر بن الخطاب، بسند متين. فهي لم ترد في المصادر الموثوقة بل في كتاب «الكامل في اللغة والأدب» للمبرّد. وفيها أن الخليفة الثاني قال لرجل: «والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم»، وذلك لأن أبا مريم هذا كان قد قتل زيداً بن الخطاب، أخا عمر، في معركة اليمامة في أثناء حروب الردة الشهيرة مع مسيلمة، عندما كان هذا الصحابي أحد أنصاره قبل أن يرجع إلى الإسلام ثانية. وفي الرواية ردّ أبو مريم على أمير المؤمنين سائلاً عن نتيجة هذا الكره: «أتمنعني حقاً؟»، فقال: «لا»، فختم معقباً: «إنما يأسف على الحب النساء»!
لا تتسق هذه الحكاية تماماً مع بعض معالم عصرنا، بفظاظتها الذكرية، لكنها جديرة بالتفكّر فضلاً عن طرافتها.
فمن الواضح أن الشقوق الطائفية بين السوريين تزداد استفحالاً وعمقاً، وترتكز على درجات وأشكال من الشعور بالكره الصارخ أو المستتر. ولا سيما بين الطرفين اللذين تقشر عنهما النزاع الدموي؛ العلويين والسنّة على وجه الإجمال لا الحصر.
ومن الطبيعي أن هذا الكره، في ظل صراع مسلح لا يتورع عن إبراز ملامحه الوحشية، يؤدي إلى نتائج ملموسة تجلت في ارتكاب المجازر واستخدام أعتى أنواع الأسلحة وتصفية المعتقلين، مما كان للنظام حصة «الأسد» في ابتدائه وفي عدد ضحاياه.
غير أنه من الواضح أيضاً أن خطاب الانتقام، وبالطريقة نفسها، صار شائعاً في صفوف جمهور الثورة، بعد الحقد المتراكم عبر اثني عشر عاماً من التعرض للظلم المنفلت من عقاله، و«قهر الرجال» الذي أصاب كل من فقد عزيزاً أو عاش الرعب تحت القصف، أو هُجِّر من دياره، وغير ذلك.
يستند المتسامحون مع أصوات الحقد إلى المشاعر السلبية المحتقنة لتبرير ما يصدر عن أي شخص في هذا الإطار، سواء أكان ممن تعرض لهذه الجرائم أو ممن شارك الضحايا مشاعرهم. ومن المفهوم أن هذا «التسامح» مقدمة نظرية لأفعال مشتهاة عملياً، يمنع حصولها نقص القدرة فقط. مما يجعل التساهل موافقة ضمنية على قاعدةٍ تسود وتنتظر فرصة التطبيق، ويصبح نقاشها أمراً محتماً.
وفي مقابل هذه النزعة تصدر، بين حين وآخر، أصوات باهتة لمثقفين وسياسيين وناشطين، فرادى أو مجتمعين، تشدد على نبذ الطائفية بطريقة تنحو إلى المناورة حول واقعها، ولغة عمومية تشبه، جزئياً، ما كانت تصدّره سلطة حافظ الأسد. تُرفض الطائفية هنا بالاستناد إلى مفاهيم غير متجذرة كفاية لدى السوريين كالمواطنة، وأن الانتماء إلى بلد واحد يجب أن يعلو على ما عداه مهما كانت الوقائع، بما يعبّر عنه البعض بتعبير «حبوا بعض».
والحق أن الحقد والحب ليسا من الأساسات التي يجب أن تُبنى عليها السياسات، لا سيما إن كانت نتائجها مضرجة بالدماء. وإذا أفردنا مشاعر الكراهية تجاه العلويين بالكلام، بما أنها الأوضح، فمن البدهي أن «تحصيل الحقوق» التي انتهكها كثير من أبناء هذه الطائفة لا يكون بمحاسبتها طائفياً وجماعياً كما يرغب البعض. وأن كل الشرائع، وأبرزها الإسلام هنا، والقوانين، وأقربها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقضي بأن ينضبط ذلك بشروط أساسية ثلاثة:
أولها رفض العقوبة الجماعية التي لا تفرّق بين المرتكبين وبين المعارضين، مهما كان عددهم محدوداً، وبين المحايدين الذين تجنبوا الانخراط لأسباب مختلفة.
وثانيها التمييز الصارم بين المجرمين وبين مؤيديهم اللفظيين. فلا عدالة في الكون يمكن أن تسوّي بين من أطلق السلاح الكيماوي وبين من فرح به وخرج في مسيرات تؤيده. يستحق الأخيرون عقاباً رمزياً غير شخصي، وهو ما يمكن تحقيقه بخطوات معنوية عامة في المستقبل، مما له أمثلة سابقة كثيرة.
وثالثاً أن العقوبة يجب أن تطول المتورطين بحسب أفعالهم. ويترتب على ذلك ألا تكون على درجة واحدة، وأن تقع على المنتهكين بالنظر إلى ممارساتهم لا إلى طوائفهم، مما يشمل من شارك من السنّيين وغيرهم في جرائم النظام، ومن ارتكب انتهاكات تجاه حياة الناس وحقوقهم من خارج معسكره أصلاً.
هذه قواعد بدهية لأي عدالة. وهي ليست نظرية فقط بل عملية، لأن توعّد طائفة مسلحة بأكثريتها، وليست قليلة العدد، بالإبادة خيار سيدفعها إلى مزيد من الإصرار في الدفاع عن نفسها حتى النهاية.
وإذا كان من غير الممكن الآن، وحتى وقت طويل كما يبدو، للسوريين أن يتعايشوا في بلد واحد بمشاعر ودودة أو محايدة، فعلى الأقل يجب أن لا تكون الأحقاد أعمدة في أساسات البلد الجديد القادم ولو طال الزمن.
الأساس الثاني، سوى المشاعر، الذي لا يصلح للنظر إلى العلويين هو المنظور العقائدي. وهو ما يستند إليه إسلاميون وبعض جوارهم الإيديولوجي حين يرجعون إلى بعض الكتب المنشورة عن المذهب العلوي، أو المسرّبة له، ويلتقطون منها عبارات تشي بالخروج عن الدين، ويبنون على ذلك نزعة حربية ترتكز على مفهوم الردة.
لا يصح هذا المنظور لأسباب عديدة؛ أولها أن «استلام الدين»، وهو الوصف الشائع لتلقي التعاليم العلوية بعد البلوغ، لا يشمل النساء بحكم المذهب نفسه، مما يُخرج نصف الطائفة من المعادلة المعتمدة على محتوى الكتب. وثانيها أن هذه الخطوة اختيارية حتى للذكور، فمنهم من رفض تلقي التعاليم مع انتشار التعليم الحديث أو لأسباب علمانية. وتختلف نسبة من تلقوها ومن لم يفعلوا بحسب المرحلة وتنامي شعور الانتماء الطائفي أو تراجعه. وثالثها أن عدد من التزموا بهذه التعاليم، التي تصف شهادات عديدة غموضها وتفككها، يبدو قليلاً للغاية بالقياس إلى من أرادوا الاطلاع عليها من باب الفضول أو الالتزام الاجتماعي المحيط.
لا تصلح الكتب، لو صحّت نسبتها أصلاً، لفهم العلويين، لأن عدد المتدينين منهم نادر ومحدود الجاذبية والنفوذ. وما يتبقى من المذهب لدى العلوي العادي في حياته اليومية هو الاعتقاد بقوى خارقة للإمام علي الذي يحوز مكانة مقدسة، والإيمان بقدرات عدد كبير من الأولياء المدفونين في مقامات تُقصد للزيارة، وبعض الأفكار المتناثرة الأخرى. أما ما يحركه اليوم فهو الإحساس بالخطر الشخصي والخوف على الطائفة لا بالنظر إلى محتواها العقائدي بل بوصفها جماعة سياسية قادها الأسد الأب إلى نقلة نوعية في طريق من القمع طال السوريين، وتخشى الطائفة دفع ثمنه في طريق نزولها الذي لا يبدو آمناً بالمرّة، خاصة مع توسع الورطة بالارتكابات المريعة التي حصلت في أثناء الثورة، ولذلك تصرّ على التمسك برأس الهرم في حرب تراها صراع وجود، حياة أو موت، على خلفية مخاوف تاريخية شائعة ومؤثرة، سواء أكانت حقيقية أم متوهمة. ولا يفعل أعداؤها من أصحاب خطابات الانتقام العام والاستئصال غير تعزيز قناعاتها هذه.
وأخيراً فإن محاكمة الناس غير المبنية على أفعالهم الفردية، بل على ما يعتقدونه أو ما تدين به الجماعة التي ولدوا فيها، جديرة بأن تجعل من مهامها فحص كتب الدروز والإسماعيليين أيضاً، وتحويل شُرطتها إلى قبيلة طوعية ذبّاحة على طول البلاد وعرضها!
المصدر: موقع تلفزيون سوريا