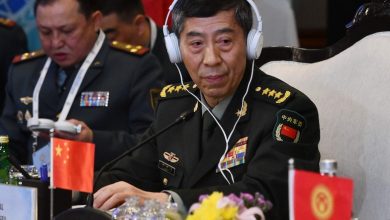طوال العقدين الماضيين كان رهان واشنطن، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ذا تبعات كبيرة، فهي حسبت أن معاملة الهند كشريك أساسي سيساعد الولايات المتحدة في سياق تنافسها الجيوسياسي مع الصين. وابتداء من ولاية جورج دبليو بوش قام الرؤساء الأميركيون المتعاقبون بتعزيز قدرات الهند، مفترضين أن ذلك سيساهم تلقائياً في تعزيز القوى المؤيدة للحرية في القارة الآسيوية. وتبنت إدارة الرئيس جو بايدن بحماسة هذا التوجه. لا بل إنها، فعلاً، خطت به خطوة إلى الأمام. فأطلقت هذه الإدارة مبادرة جديدة طموحة لتسهيل حصول الهند على تكنولوجيات أميركية بالغة التطور، وتعميق التعاون الدفاعي بين البلدين، وجعل “الرباعية” (“المباحثات الأمنية الرباعية” Quadrilateral Security Dialogue)، التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة ركيزة لاستراتيجيتها في ذاك الإقليم (منطقتي الهندي والهادئ). وتغاضت إدارة بايدن عن سياسات هندية تقوض الديمقراطية وتنتهج نهجاً غير مفيد في السياسة الخارجية، مثل رفضها إدانة العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا. وما قامت به الإدارة الأميركية الحالية يفترض أن نيودلهي سترد إيجاباً بالانحياز إلى واشنطن في أزمات قد تنشأ في الإقليم.
ولكن توقعات واشنطن الراهنة من الهند في غير محلها. والضعف الملحوظ الذي تعانيه الهند مقارنة بالصين، وقربها الجغرافي منها الذي لا يمكن تجاهله، يرتبان على نيودلهي ألا تقحم نفسها في أية مواجهة أميركية – صينية لا ينجم عنها تهديد مباشر لأمنها القومي. فالهند تثمن التعاون مع واشنطن بسبب الفوائد الملموسة الناتجة منه، لكنها لا ترى أن عليها، لقاء ذلك، تأييد الولايات المتحدة تأييداً فعلياً في أية أزمة تقع بين القوتين – حتى لو كان مصدر الأزمة الصين، وتهديدها الهند والولايات المتحدة معاً.
والمشكلة الأولى هي تباين ما ينتظره البلدان من الشراكة الأمنية التي تجمعهما. وعلى نحو ما فعلت مع حلفاء في أنحاء مختلفة من العالم، سعت واشنطن إلى تقوية موقف الهند ضمن إطار النظام الدولي الليبرالي، وتتوقع منها الإسهام في تحالف دفاعي. أما نيودلهي فترى الأمور على نحو مختلف. فهي لا تلتزم التزاماً صارماً مسألة الحفاظ على النظام الليبرالي الدولي، وتنفر بقوة من الانضمام إلى حلف دفاعي مشترك، وتسعى إلى الحصول على تكنولوجيات متطورة من الولايات المتحدة تعزز قدراتها الاقتصادية والعسكرية، وتسهم في تحولها إلى قوة عظمى قادرة بقواها الذاتية على التوازن مع الصين. وهي لا ترى أن المساعدة الأميركية توجب عليها التزامات إضافية. لذا، فيما تمضي إدارة بايدن قدماً في توسيع استثماراتها في الهند، عليها بناء سياساتها على مراجعات واقعية للاستراتيجية الهندية، وليس على أوهام تفترض تحول الهند إلى “رفيق سلاح” في أزمة مقبلة مع الصين.
أصدقاء على جناح السرعة
في معظم حقبة الحرب الباردة لم تنخرط الهند والولايات المتحدة في مفاوضات دفاعية جدية. فطوال تلك الحقبة حاولت نيودلهي تجنب تعقيدات الانضمام إلى حلف مع الولايات المتحدة أو إلى معسكر الاتحاد السوفياتي. ولم تزدهر الشراكة الأمنية بين البلدين (الهند والولايات المتحدة) إلا بعد أن اقترح بوش على الهند معاهدة جوهرية في المجال النووي المدني. وجراء هذا الاختراق القوي في العلاقة، خطا التعاون الأمني الهندي – الأميركي خطوات مذهلة، عمقاً وعرضاً. والعنصر الأول والأبرز في هذا التعاون هو الاستشارات الدفاعية. ويثابر القادة المدنيون ومساعدوهم، في كلا البلدين، على المباحثة المنتظمة في قضايا كثيرة، منها سياسات الصين، ومشتريات الهند لتكنولوجيات العسكرية الأميركية المتطورة، وتجهيزات المراقبة البحرية، وتقنيات الحرب في أعماق البحار. وتتنوع المحادثات بين البلدين من ناحيتي المستوى والعمق، ولا تنفك مهمة، في كل الأحوال، لمراجعة المواقف الاستراتيجية، وتحديد أبعاد التعاون المرغوب ومقاييسه، وابتكار أدوات لتطبيق السياسات (المطلوبة). وفي نهاية المطاف، تتعاون الولايات المتحدة والهند في مجالات لم يكن في الإمكان تصورها في أثناء الحرب الباردة. فهما تتعاونان، مثلاً، على رصد أنشطة الصين الاقتصادية والعسكرية في أنحاء منطقة المحيط الهندي كلها، واستثمرتا أخيراً في تشارك المعلومات شبه الآنية عن حركة النقل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع دول مشاطئة.
أما الجانب الآخر لنجاح العلاقة الأميركية – الهندية فالقرينة عليه هي التنسيق المباشر بين جيشي البلدين، ويحصل شطر كبير منه بعيداً من الأنظار. فبرامج زيارات الضباط الكبار (المتبادلة)، والمناورات العسكرية الثنائية أو المتعددة الأطراف، والتدريبات المشتركة، كلها تواترت في العقدين الماضيين على نحو مدهش. والمناورات المشتركة مرآة للمستوى العالي الذي بلغته العلاقة المتنامية وتنوعها: فمناورات “مالابار”، وهي تجمع البحرية الأميركية والبحرية الهندية، توسعت لتضم اليابان وأستراليا بصورة دائمة. وتتيح مناورات “كوب إنديا” (Cope India) فرصة للقوات الجوية الأميركية والهندية للتدرب على العمليات الجوية المتطورة. هذا وتضم سلسلة مناورات “يوده أبهياس” (Yudh Abhyas) القوات البرية الأميركية إلى القوات الهندية وتنسق عمليات إعدادية بينهما في مراكز القيادة وفي حقول التدريب.
ونجحت الشركات الأميركية، في هذا المجال، نجاحاً ملحوظاً في دخول سوق التجهيزات الدفاعية الهندية. وبعد أن كانت أعتدة الجيش الهندي، قبل نحو عقدين، خالية تقريباً من الأسلحة الأميركية، تحتوي ترسانته اليوم على طائرات أميركية للنقل الجوي والعمليات البحرية، إلى طوافات للخدمات المدنية والمهمات القتالية، وصواريخ مضادة للسفن وقطع مدفعية. وبلغ حجم التجارة الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، وهي كانت ضئيلة مطلع القرن (الحالي)، فوق 20 مليار دولار عام 2020.
غير أن حقبة عمليات الحصول على المنصات “العسكرية” الرئيسة من الولايات المتحدة قاربت نهايتها اليوم. وتنافس الشركات الأميركية بقوة في عدد من برامج الشراء الهندية المهمة، لكن من غير المرجح، على ما يبدو، أن تحظى بحصة مهيمنة في السوق الهندية للواردات الدفاعية. فالمشكلات في هذا السياق بنيوية. وعلى رغم التهديدات الأمنية الداهمة والمحيطة بالهند، تبقى موازنة مشترياتها الدفاعية معتدلة قياساً على إجمالي السوق في الدول الغربية. ومنعت متطلبات التنمية الاقتصادية الحكومات الهندية المنتخبة من زيادة الإنفاقات الدفاعية على نحو يتيح عقد عمليات شراء ضخمة من الولايات المتحدة الأميركية. وأكلاف الأنظمة الدفاعية الأميركية عموماً أغلى من أكلاف أنظمة يصنعها منتجون غير أميركيين. وذلك بسبب تكنولوجياتها المتطورة. وهذا امتياز لا يغري الهند على الدوام. وتفضل نيودلهي أن تتحول الشركات الأميركية من بيع التجهيزات إلى إنتاجها مع شركاء محليين في الهند – وهذا يفترض نقل حقوق الملكية الفكرية – الأمر الذي لا يتمتع بجاذبية تجارية لضيق سوق الدفاع الهندية.
الهند تتولى الأمور بمفردها
ونظير النجاح الملحوظ الذي حققه التعاون الأمني الهندي – الأميركي، تواجه الشراكة الدفاعية الكبيرة بين الهند والولايات المتحدة تحديات مهمة. وإذا صح أن البلدين يريدان تعزيز العلاقات التي تتوثق بينهما، وتسعى إلى تقييد قوة الصين، فإنهما يفترقان افتراقاً ظاهراً على النهج الذي يحقق هذه الغاية.
وتهدف الولايات المتحدة، من طريق التعاون المباشر بين الجيشين الأميركي والهندي، إلى تمتين أطر العمل المشترك: فالبنتاغون يرغب في الارتقاء إلى مستوى يمكن معه التنسيق مع جيش أجنبي في عمليات مشتركة تتطور إلى تحالف عسكري. ولكن الهند ترفض مشاركة قواتها العسكرية في عمليات عسكرية خارج إطار الأمم المتحدة. وعليه، قاومت فكرة الانخراط في عمليات مشتركة تترتب عليها تبعات، وعلى الخصوص مع القوات الأميركية، خوفاً من المساس باستقلاليتها السياسية، أو من الدلالة على توجهها نحو تقارب سياسي وثيق مع واشنطن. وفي آخر المطاف، قد تنمي التدريبات العسكرية الثنائية (بين الهند والولايات المتحدة) احتراف الوحدات المشاركة في التدريبات وأداءها، لكنها لا تطور العمل المشترك إلى مستوى قد تقتضيه عمليات مشتركة كبيرة ضد عدو متمكن. أما الرؤية الهندية للتعاون العسكري، فهي تشدد على نسج روابط دولية متعددة، وهذا تحد إضافي للشراكة. فالهند تعامل تلك التدريبات العسكرية على أنها رموز سياسية أكثر من كونها استثمارات لزيادة الاحترافية في تنفيذ العمليات. لذا فإن قواتها العسكرية تتدرب مع عدد كبير من الشركاء وبمستويات متفاوتة التطور والتعقيد. كما تحرص الولايات المتحدة نسبياً، في المقابل، على خوض تدريبات عسكرية مكثفة مع عدد مماثل من الشركاء.
وتولي الهند الأولوية إلى المساعدات الأميركية في إطار بناء قدراتها الوطنية الخاصة التي تمكنها من مواجهة الأخطار باستقلالية. وقطع الطرفان شوطاً بعيداً في هذا المجال، وذلك، مثلاً، من خلال تعزيز قدرات الهند الاستخبارية على الأنشطة العسكرية الصينية، على طول حدود الهملايا وفي منطقة المحيط الهندي. وهندس الطرفان، في الإطار نفسه، تشارك معلومات استخبارية على قاعدة التبادل والمنفعة المشتركة. ولما تتفوق قدرات الولايات المتحدة على جمع المعلومات كثيراً قدرات الهند، يبدو تدفق المعلومات المفيدة، في أغلب الأحيان، كأنه في اتجاه واحد.
وركزت الهند، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أكثر فأكثر على التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وعدته محركاً أساسياً لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة. وهدفها الأول، من هذا التعاون، هو تأمين استقلالها التكنولوجي. وهي سعت على الدوام، ومنذ قيامها كدولة حديثة، إلى إتقان صناعة العناصر الدفاعية والتكنولوجيات الثنائية الاستخدام، العسكرية والمدنية. وفي مسارها هذا، أنشأت مشاريع كبيرة في القطاع العام، وأرادت إنجاز سبق عالمي. ولأن حلمها هذا لم يتحقق بعد، قدمت نيودلهي اليوم دعم واشنطن طموحاتها الصناعية في المجال الدفاعي على الأولويات الأخرى، في موازاة شراكات أقامتها مع فرنسا وإسرائيل وروسيا، ودول صديقة أخرى.
وحاولت واشنطن طوال أكثر من عقد مساعدة الهند في تطوير قاعدة تكنولوجياتها الدفاعية، ولكن تلك الجهود انتهت إلى الإخفاق. وفي أثناء ولايتي الرئيس باراك أوباما أطلق البلدان “مبادرة التجارة والتكنولوجيا الدفاعية” التي رمت إلى تشجيع التبادل التكنولوجي والإنتاج المشترك للأنظمة الدفاعية. ورأى المسؤولون الهنود أن المبادرة تمكنهم من الحصول على بعض التكنولوجيات العسكرية الأميركية المتطورة، مثل التكنولوجيات المرتبطة بمحركات الطائرات، ومنصات المراقبة والاستطلاع، وتقنيات الأسلحة الشبحية، ومن المشاركة في صناعتها وفي تطويرها في الهند. إلا أن تردد واشنطن في إجازة نقل هكذا تكنولوجيات اقترن بامتناع شركات التصنيع الدفاعي الأميركية من التخلي عن حقوق الملكية الفكرية، والاستثمار في فرص تجارية ضئيلة.
رهان واشنطن الكبير
وتنتهج إدارة بايدن الآن، بثبات، نهجاً يخالف المسار الذي أدى بـ”مبادرة التجارة والتكنولوجيا الدفاعية” إلى الفشل. وأعلنت هذه الإدارة، في السنة الماضية، “مبادرة التكنولوجيا الحيوية والناشئة” (the Initiative on Critical and Emerging Technology) وغرضها أن تخطو بالتعاون بين حكومتي البلدين وشركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث والتطوير فيهما خطوات إلى الأمام. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من الميادين، من بينها قطاعات إنتاج أشباه الموصلات، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والجيل المقبل من الاتصالات، وقطاع الحواسيب المتطورة، والتقنيات الكمية (quantum technologies). ولجميع هذه الميادين وجوه استخدام دفاعية، من دون أن تقتصر عليه. إلا أن “مبادرة التكنولوجيا الحيوية والناشئة”، على رغم إمكاناتها واحتمالاتها، لا تضمن بلوغ نتائج محددة. وفي وسع الحكومة الأميركية الالتزام بالمبادرة أو التنصل منها، فهي الطرف الذي يعود إليه وحده إصدار البراءات التي يتطلبها كثير من المشاريع المشتركة. وعلى رغم ما تبديه إدارة بايدن من استعداد إلى أن تكون أكثر ليبرالية في هذا المجال من الإدارات التي سبقتها، وحده الوقت كفيل بالبرهان على ما إذا كانت المبادرة الجديدة تماشي تطلعات الهند إلى الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتطورة على أمل تحقيق برنامج “اصنعوا في الهند، اصنعوا للعالم” الذي يعتمده مودي، والرامي إلى جعل الهند مركزاً صناعياً عالمياً أساسياً قد ينافس، في يوم من الأيام، الصين “مصنع العالم”، وربما التفوق عليها.
ولكن السؤال الكبير يتناول سخاء واشنطن تجاه الهند وإسهامه في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فخلال ولايتي بوش وأوباما، انصبت المطامح الأميركية أولاً على المساعدة في بناء القوة الهندية، وتلافي هيمنة صينية كاملة على آسيا. وبينما كانت العلاقات الأميركية – الصينية تتردى على نحو متفاقم في أثناء إدارة ترمب – حين بلغت العلاقات الصينية – الهندية الحضيض في الوقت نفسه – عمدت واشنطن إلى تفحص احتمال اضطلاع نيودلهي، بدعم حثيث من واشنطن، بدور عسكري راجح يلجم قوة الصين المتعاظمة.
والحق أن ثمة أسباباً عديدة للاعتقاد بأن الهند لن تفعل ذلك. فهي أظهرت رغبة في تأييد الولايات المتحدة وشركائها في “الرباعية” (“المباحثات الأمنية الرباعية” – Quad)، وماشت بعض عناصر الحد الأدنى من السياسة مثل توزيع اللقاحات، واستثمارات البنى التحتية، وتنويع سلاسل الإمدادات، مع الإصرار على نفي أن تكون واحدة من هذه المبادرات موجهة ضد الصين. ولكن التحدي الأصعب الذي تواجهه واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – وهو تأمين مساهمات عسكرية فعالة تلحق الهزيمة في عدوان صيني محتمل – ترفض الهند، على الأرجح، تولي دور فيه في حال لا يكون أمنها مهدداً على نحو مباشر. وفي الحال هذه لن تسهم الهند، في أحسن الأحوال، إلا بدعم ضمني.
وعلى رغم أن الصين وهي، من غير شك، الخصم الأكثر تهديداً للهند، لا تزال نيودلهي تتجنب القيام بما قد يؤدي إلى قطيعة عميقة مع بكين. ويعي صناع السياسة الهنود، على نحو دقيق، التفاوت الصارخ في القوة الوطنية بين الصين والهند، وهو تفاوت لن يضيق في مستقبل قريب. والضعف النسبي هذا الذي تعانيه نيودلهي يحملها على تفادي استفزاز بكين. وهو ما قد يصنعه الانضمام إلى تكتل أو حلف تقوده الولايات المتحدة. وليس في مقدور الهند إغفال جوارها بالصين، فالبلدان يتشاركان حدوداً مديدة، مما يمكن الصين من تهديد الأمن القومي الهندي جدياً – وفي أثناء السنوات الماضية تعاظمت قدرات الصين العسكرية.
لذا، تبقى الشراكة الأمنية بين الهند والولايات المتحدة متأرجحة صعوداً وهبوطاً في الأعوام المقبلة. وبينما ترغب نيودلهي في دعم أميركي يقويها بإزاء الصين، تميل، في الوقت نفسه، إلى النأي عن مواجهة أميركية – صينية ليست مصالحها الخاصة عنصراً مباشراً ومهدداً فيها. وإذا اندلع نزاع كبير بين واشنطن وبكين، في شرق آسيا أو في بحر الصين الجنوبي، لا شك في أن الهند تود انتصار الولايات المتحدة فيه، ولكن من غير المرجح أن تتورط في النزاع.
لذا، لا ينبغي تأويل علاقات نيودلهي الدفاعية المتعاظمة بواشنطن على التأويل الذي ينسبها إلى تأييد قوي للنظام الليبرالي الدولي، أو يحملها على رغبة في الانضمام إلى حلف دفاعي مشترك في وجه العدوانية الصينية. فالعلاقة الدفاعية التي تزداد عمقاً (بالولايات المتحدة) هي، في نظر صناع السياسة الهنود، وسيلة تعزز قدرات الهند الدفاعية الخاصة، ولا ترتب التزاماً بدعم الولايات المتحدة وتأييدها في معرض أزمات دولية أخرى. وتطور العلاقة الأميركية – الهندية هذه على وجه السرعة، لا يردم هوة بين البلدين، نظراً إلى رغبة الهند الثابتة في تجنب تحولها إلى شريك ثانوي – أو حليف – لأية قوة عظمى.
وعلى الولايات المتحدة، من دون شك، مساعدة الهند إلى حد يتوافق مع المصالح الأميركية. ولكن عليها ألا تتوهم أن دعمها هذا، بالغاً ما بلغ من السخاء، سيغري الهند بالانضمام إلى حلف عسكري ضد الصين. فالعلاقة بالهند تختلف جذرياً عن علاقة الولايات المتحدة بحلفائها الآخرين. وعلى إدارة بايدن أن تلحظ هذا الواقع بدلاً من محاولة تغييره.
آشلي ج. تيليس تشغل “كرسي تاتا” للقضايا الخارجية وباحثة بارزة في إطار منحة كارنيغي للسلام الدولي.
مترجم من فورين افيرز، مايو (أيار) 2023
المصدر: اندبندنت عربية