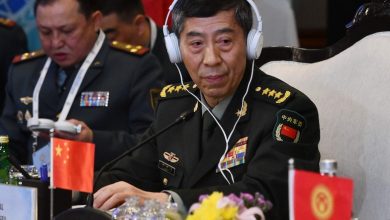يتزايد التوتّر السياسي والعسكري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، في شأن مستقبل تايوان، لاسيما مع إصرار حكومتها المحافظة على استقلال الجزيرة، مقابل إصرار الصين على إنكار ذلك عليها، وفقا لمفهومها عن “الصين الواحدة”، ما قد يهدد باندلاع حرب إقليمية، أو عالمية، أخرى، في ظرف الاحتقان الدولي حول الحرب الروسية في أوكرانيا.
المشكلة أن الولايات المتحدة تعترف بـ “الصين الواحدة”، في حين الصين حائرة، بين التمهّل في انتظار التطورات المناسبة لترجمة ذلك بالتدريج، وبالوسائل السلمية، أو تسريع ذلك بواسطة القوة، وبغض النظر عن رأي سكان تايوان (الصينيين طبعا).
بديهي إن الخلاف بين الأطراف المعنية بات أكثر سخونة وتعقيداً بسبب المناخات التي فرضتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والاصطفاف الدولي في هذا الشأن، بالنظر الى الشبه الكبير بين الموضوعين، إذ إن روسيا تعتبر أوكرانيا جزءا منها، والصين تعتبر تايوان جزءا منها، أيضا، علما أن الادعاءات الصينية تبدو أقوى من جهة الاعتراف الدولي بذلك.
بيد إن ما تفترض ملاحظته أن قواعد الصراعات الدولية لا تقوم، للأسف، على الحقوق، أو العدالة، وإنما على المصالح، وحقائق القوة، مع التأكيد أن كل طرف يحاول إضفاء بعض من الحقيقة والعدالة على روايته، رغم أن وسائله، وأغراضه، غير عادلة.
على ذلك فإن المسألة الأكثر أهمية تكمن في تفحّص كل طرف عوائد هذا الخيار أو ذاك عليه، فقد حققت الصين نجاحات هائلة، ومعترفاً بها دوليا، في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والعمران، بفضل حسن استثمارها لمسارات العولمة ومنجزاتها، بحيث أضحت قطباً لا يمكن تجاوزه، من دون تايوان، فما حاجتها لها اليوم؟ أو ما الذي يمكن ان تضيفه تلك الجزيرة اليها؟
ويبلغ عدد سكان تايوان 24 مليون نسمة، في حين أن عدد سكان الصين 1400 مليون نسمة، أي أكثر بـ 60 ضعفاً من تايوان، أما من حيث المساحة فإن مساحة الصين تبلغ 10 مليون كلم مربع تقريباً، في حين أن مساحة تايوان 36 ألف كلم مربع، أي أن الصين أكبر 300 مرة تقريباً من تايوان، مع كل ما يتضمنه ذلك من ميزات وثروات باطنية لمصلحة الصين.
وعليه، وبغض النظر عن الاصطفاف إلى جانب الصين أو تايوان، أو الصين والولايات المتحدة، فمن ناحية براغماتية بحتة، هل إن سعي الصين الى ضم تايوان بالقوة، سيزيدها قوة أم سيهدد بتقويض ما بنته باستثمارها في العولمة؟ بقوتها الناعمة، وبتركيزها على التطور الاقتصادي والتكنولوجي؟ ثم ألا يمكن اعتبار فرضية استدراج الولايات المتحدة الصين، أو استفزازها، في مسألة تايوان، توريطاً لها في شرك مغامرة عسكرية، قد تضعف مكانتها، وتستنزف قدراتها، على مثال روسيا في أوكرانيا، ومغامرة صدام حسين في العراق، أيضاً؟
وبعيداً عن المناظرة وفقاً للمفهوم البراغماتي، فمن ناحية مبدئية ثمة مسألتان، قد تفيدان في مناقشة تجربتنا في العالم العربي، الأولى، إنه في مسألة الصين وتايوان (كما في مسألة روسيا وأوكرانيا)، فإن التركيز يجري على الأرض/الجغرافيا، بمعزل عن السكان، أو المواطنين، كأن البشر لا دخل لهم، أو كأن مبدأ “حق تقرير المصير” لا يشتغل في تلك البلدان، التي تفتقد لحقوق المواطن، إلى درجة أنه يمكن فيها سوق مئات ألوف البشر إلى حروب بسبب قرار من الحاكم، أو الطبقة الحاكمة، من دون أن يكون لأي واحد من هؤلاء، الذين يموتون دفاعاً عن الوطن، ولو متر واحد في وطنهم، وهذا ما شهدناه في منطقتنا.
على ذلك، فإن السلطة في الصين لا يهمهما رأي صينيي تايوان في شكل نظامها السياسي (القائم على الحزب الواحد)، وهيمنة الرئيس على كل شيء، ولا شكل توزيع الموارد، ولا الافتقاد لحقوق المواطن في الصين ذاتها، تماماً مثلما لم يهتم بوتين لرأي الشعب الأوكراني؛ وغيره من الشعوب التي كانت يوماً في نطاق الاتحاد السوفياتي أو دول “المنظومة الاشتراكية”، والتي فضلت الغرب على روسيا، إذ هو لا يهتم برأي أحد ممن يفترض أنهم من مواطنيه في روسيا ذاتها، التي باتت تجرّم بالقانون كل من له رأي آخر في الحرب الاوكرانية.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تشكل الأمم، إذ إن عاملي اللغة والتاريخ المشترك، ليسا كافيين لذلك، أي إن الاتكاء عليهما، فقط، ومع إعمال القوة، قد يزلزل معظم بلدان العالم، علماً أن العديد من الدول باتت تتخذ اشكالاً متعددة فدرالية وكونفدرالية، وثمة عدد من الدول فيها قوميات ولغات متعددة، ولعل أكثر الدول اطمئناناً هي تلك التي تتأسس على حقوق المواطنة المتساوية، من دون تمييز بين شخص وآخر، ولا لأي سبب.
أيضاً، فإن الاتكاء على اللغة والتاريخ، كما حدث في بلداننا العربية، بادعاء وحدتها، جرّها إلى صراعات استنزفتها، وحتى المجتمعات في كل بلد تبدو غاية في التفكك (مثلاً العراق ولبنان وسوريا)، على خلفيات دينية، ومذهبية، وإثنية. ثم بالنسبة الى الصين فهي لديها أجزاء من أراضيها، أكبر من تايوان عشرات المرات، ضمت إلى روسيا في القرن التاسع عشر.
ثمة من يرى أن الطمع بتايوان ينبع من حيازتها 60 في المئة من انتاج أشباه الموصلات في العالم، إلا أن ذلك الأمر، على أهميته، لا يكفي كي تغامر الصين بمكانتها، وبنجاحاتها المتحققة من دون تايوان، بفضل علاقتها بالغرب، وبخاصة الولايات المتحدة. وأيضاً لأن ذلك سيضع الصين في دائرة الاستهداف بحرمانها من ميزات العولمة، وفرض حصار تكنولوجي عليها، وتخفيض قدرتها على انتاج أشباه الموصلات، التي باتت محرّكا لمعظم الصناعات التكنولوجية الحديثة، علما أن إنتاج آلات صناعة أشباه الموصلات في قبضة الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها (ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، تايوان)، وعلماً أن الولايات المتحدة تعمل على نقل تلك الصناعة من تايوان إلى أراضيها.
ولعل ما يفترض ملاحظته هنا أن الصين ترتبط بألف خيط بالغرب، وبخاصة بالولايات المتحدة، الذي يستثمر فيها، وتسوّق بضائعها في أسواقه، وترتبط بعملته وشبكاته المالية، كما ترتبط به بوصفه المصدر الأساس للتطورات التكنولوجية والعلمية في العالم.
وللتوضيح، ففي العام 1993 كان اقتصاد الصين تساوى مع اقتصاد روسيا، وفقاً لحسابات الناتج المحلي الإجمالي (بحسب البنك الدولي)، إذ بلغ في روسيا 435 مليار دولار، في حين كان في الصين 444 مليار دولار، لكن مع دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية (2001)، بات الفارق يتسع باطراد بين الطرفين، لمصلحة الصين. ففي حين كان الناتج الإجمالي لروسيا في العام 2001 نحو 306 مليار دولار، بلغ في الصين 1.34 ترليون دولار، وفي العام 2010 بلغ في روسيا 1.5 ترليون دولار، في حين ارتفع في الصين إلى 7 ترليون دولار، وفي عام 2021 بلغ الناتج الإجمالي في روسيا 1.78 ترليون دولار، في حين وصل في الصين إلى 17.77، أي أن الاقتصاد الصيني اليوم أقوى بقرابة عشرة أضعاف من الاقتصاد الروسي، في حين كان اقوى منه بمقدار أربع مرات في العام 2010)، ما يدل على جمود الاقتصاد الروسي مقابل الصعود الكبير للاقتصاد الصيني،
وتفسير ذلك يكمن في استثمار الصين في العولمة، واعتماديتها على الغرب، إذ منذ انخراطها في منظمة التجارة العالمية، ارتفع نصيبها في التجارة العالمية، من 1 في المئة (30 مليار دولار) عام 1979، إلى 12 في المئة (3.5 ترليون دولار) عام 2018. (ليو هونغ كوي: “تجارة الصين الخارجية في 70 عاما”، “الصين اليوم”، 30/8/2019).
القصد أن الصين تقف اليوم، في مرحلة صعبة، في مفترق طرق، والخيار الأفضل هو ما تختاره لاستمرار تطورها، من دون التورط في صراعات لن تضيف إليها شيئا، إذا لم تخسّرها، ويخسرها العالم.
المصدر: النهار العربي