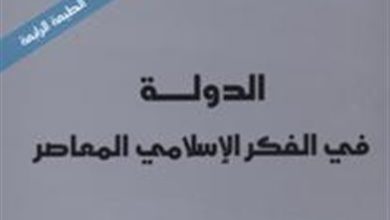يفترق الدين المُعلْمَن عن الدين التوحيديّ في ما خصّ عبادة الإله الواحد، وهو قد لا يتقيّد بالرواية الدينيّة عن نشأة الكون أو عن العالم الأخرويّ، ولا بأساسيّات أخرى في الأديان وتعاليمها، بل قد يكون إلحاديّاً، لا مُعلمَناً فحسب. مع هذا يستعير الدين المعلمن من الدين التوحيديّ بضع أفكار وممارسات تنبع من منطقه الداخليّ، أوّلُها ذاك التصوّر المركزيّ من أنّ “التسليم” لا يخضع لامتحان التجارب ولما تُظهره التجارب تلك. فإذا جوبهت فكرة “عودة المسيح” أو “عودة المهديّ” مثلاً بحقيقة عدم حصولها قرناً بعد آخر، ردّ الوعي التسليميّ بإجابات من نوع أنّها أُجّلت وأنّها لا بدّ من أن تحصل في وقت لاحق، فهي سوف تحصل تبعاً لمخطّط إلهيّ لا يسعنا إدراكه، أو ربّما أكّد الوعي إيّاه أنّها حصلت فعلاً إلاّ أنّنا، بالقصور الذي جُبلنا عليه، عَجزنا عن رؤيتها فيما هي تتجسّد.
وقد يأتينا ذاك الوعي التسليميّ بهذه الإجابة أو تلك ممّا يحيل إلى معجزة أو إلى قدَر مُخبّأ، مستبعِداً الواقع الفعليّ وما يحدث فيه أو ينجرّ عنه من معانٍ ودلالات، ومستبعِداً معه قدرتنا على التوقّع والتعقّل.
وهذا، بموجب منطق التسليم، منطقيّ جدّاً.
أمّا في بيئات الدين المعلمن فنرى تجلّيات ذاك الموقف الأصليّ في أشكال عدّة: فنحن، مثلاً، كثيراً ما نسمع أشخاصاً يقولون إنّ إنقاذ العالم من هذا الشرّ أو من ذاك يتطلّب هتلر آخر، أو عبارةً من هذا القبيل، دون التوقّف للحظة عند حقيقة المآسي التي تسبّب بها هتلر لبلده وللعالم. وقد يكون المثال الأكثر حضوراً، والذي يجد بين المعبّرين عنه مثقّفين رفيعي المعرفة، ذاك التسليم بالوجاهة المطلقة للماركسيّة، علماً بأنّ ما توقّعه كارل ماركس من ثورة اشتراكيّة في أوروبا الغربيّة لم يحصل، بينما انهارت دفعة واحدة دزينة من أنظمة أوروبا الشرقيّة والوسطى التي نسبت نفسها إليه، أمّا الماركسيّات التي انتصرت في “العالم الثالث” فغدت وصفةً ناجعة لزواج كاثوليكيّ بين البؤس والطغيان.
والحقّ أنّ تأثير ماركس يظلّ أقوى من أيّ تأثير تركه فيلسوف أو مفكّر آخر في تاريخ البشر لأنّه بالضبط كان نبيّاً مُعلمَناً، أو كان قابلاً لأن يُعامَل على هذا النحو السحريّ ممّا لم يتسنّ لسقراط أو لأيّ من أحفاده اللاحقين. فهو وحده من تُنتَظر عودته لتخليصنا مثلما تُنتظر عودات الأنبياء والمخلّصين، وهو وحده من وجد أتباعاً يصبّون أفكاره في تعاليم ملزِمة وفي قوانين مُحكَمة. وقد امتدّ قبَس التسليم بنبوّة ماركس المعلمنة إلى سائر “آل البيت” الماركسيّ، فلا يزال بيننا مَن لم ينجح انهيارُ المعسكر السوفياتيّ، بعد توطيد الغولاغ العبوديّ غير المسبوق، في إقناعه بأنّ ما أسّسه لينين في 1917 كان شيئاً رهيباً. وهناك من لا زالوا يسلّمون بعظمة ماو تسي تونغ رغم أنّ ملايين البشر دفعوا حياتهم ثمناً لسياساته المجرمة التي تخلّى ورَثَته عن معظمها، أو بإلهاميّة تشي غيفارا الذي تقلّبت حياته بين مأساة وأخرى، على رقعة من الفشل امتدّت من الكونغو إلى بوليفيا.
وفي العالم العربيّ كانت لنا تجارب عدّة مع هذا الوعي التسليميّ، خصوصاً في البيئات الحزبيّة الراديكاليّة. وكثيرون بيننا مَن لا زالوا يديرون ظهورهم لدفق المعطيات والأرقام، متمسّكين بأحكام من نوع أنّ أوضاع المرأة العربيّة ممتازة لا يتهدّدها إلاّ تدخّل الغرب، أو أنّ الحرّيّات لدينا، من جنسيّة وإعلاميّة وسواها، لا تتعارض بتاتاً مع قيمنا وعلاقاتنا، إلاّ أنّها تتعارض أيّما تعارض مع الثقافة الغربيّة، أو أنّ مجتمعاتنا براء من الطائفيّة والإثنيّة اللتين أوفدهما إلينا عدوّ خارجيّ كلّفهما بأن تنتهكا عفاف تلك المجتمعات، وهذا فضلاً عن آراء أخرى كثيرة من الصنف هذا. وربّما كان أهمّ تمثيلات النزعة التسليميّة في تاريخنا الحديث تعاطينا مع هزيمة 1967: ذاك أنّ الحدث الزلزاليّ المذكور لم يتأدّ عنه إضعاف هيبة جمال عبد الناصر وزعاميّته. فهو ظلّ “يرفع رأس العرب” حتّى وهو ينكّس هذا الرأس على نحو غير مسبوق في تاريخ الإهانات العامّة. أمّا المراجعة التي أعقبت الهزيمة (والتي وُصفت بالجذريّة) فطلبت التداوي بجرعات إضافيّة من الداء ذاته، بحيث صحّت في أولئك الطالبين العبارة الشهيرة المنسوبة إلى أينشتَين من أنّ “الجنون هو فعل الشيء ذاته مرّة بعد مرّة مع توقّع نتائج مختلفة”.
هكذا لم ترتفع إلاّ قليلاً أصوات تدعو إلى الحرّيّات والديمقراطيّة وتفكيك الأجهزة الأمنيّة قياساً بأصوات الداعين إلى أنظمة تكون أكثر تشدّداً في ليّ عنق الثقافة وكسر عنق الاقتصاد. وكان المُفارق أنّ عبد الناصر نفسه هو الذي طرح مسألة الأجهزة الأمنيّة، أو ما عُرف يومها بـ”مراكز القوى”، التي بناها ثمّ هدمها ثمّ أعاد بيديه تركيبها تحت يافطة أخرى وأسماء وعناوين مختلفة. كذلك قلّت كثيراً الأصوات التي تعلّمت من مواجهة 1967 ضرورة إعادة التفكير بمبدأ الحرب نفسه، بينما علت الأصوات الأكثر تشدّداً في استدراجنا إليها، واستدراجها إلينا، وفي اعتبار أنّ حرب العصابات (“حرب الشعب طويلة الأمد”) أفعلُ من الحرب الكلاسيكيّة وأقدر على تمتيعنا بالنصر المؤزّر. وبالطبع لم تحظ مراجعة العلاقة بـ “الأصدقاء” السوفيات باهتمام يُعتدّ به، علماً بأنّ الأجهزة الأمنيّة العربيّة التي بُنيت على غرار أجهزتهم أظهرت كفاءة في قمع شعوبنا وإضعافها تفوق كثيراً كفاءة السلاح السوفياتيّ في الدفاع عنها. في المقابل، كان ما استهوى قطاعاتٍ عريضة من المثقّفين العرب دعوة الأنظمة “الوطنيّة”، الموصوفة بـ “البورجوازيّة الصغيرة المتذبذبة”، إلى الاقتراب أكثر فأكثر من النموذج السوفياتيّ، وأحياناً الماويّ، الموصوف بالاشتراكيّة والبروليتاريّة الحاسمتين في جذريّتهما.
وقد رأينا، في لبنان، ولا زلنا نرى، مُصغّراً عن ذاك المنحى في تزاحم الأكفّ مُصفّقةً لمقاومة “حزب الله” وللآمال الكبرى المعلّقة عليها، وهذا من غير اكتراث بالنتائج التدميريّة الناجمة عن وجود هذا الحزب وعن نشاطه طوال ما ينوف عن أربعة عقود، وهي النتائج الملموسة جدّاً في السياسة والاقتصاد وعلى الأصعدة جميعاً.
لكنّ تسليميّة الدين المعلمن تشبه تسليميّة الدين الدينيّ من وجه آخر مفاده التثبّت عند عنصر أوّل، أو أصليّ، بدأ معه التاريخ ومعه انتهى، بحيث يُحجَب الاعتراف عن كلّ عنصر آخر قد يشاركه سببيّته. وكما أنّ العنصر أو السبب هذا هو الذي يردّه الدين الأصليّ إلى ماضٍ تأسيسيّ يبتلع الحاضر والمستقبل، فإنّه في الدين المعلمن كامن في “خطيئة أصليّة” أو ماضٍ تجسّده لحظة الاحتكاك بالغرب (الاستعمار، الإمبرياليّة، الصهيونيّة، التجزئة…)، ما لا يبقى معها مكان لحاضر أو لمستقبل. وما دمنا محكومين بهذا السبب الأوّل المُستولي علينا، والذي هو أيضاً سبب أخير، غدا الخلاص منوطاً بحسمه وحسم ما يترتّب عنه.
هكذا نلوي أعناقنا، المشدودة إلى ذاك الوراء، عن ظاهرات بالغة الأهميّة تقيم تحت أنوفنا وتؤثّر في حياتنا تأثيراً مباشراً، من نوع الإخفاق الذي انتهت إليه عشر ثورات وانتفاضات عرفها العالم العربيّ خلال عقد واحد (2011-21)، أو حركة اللجوء والهجرة المليونيّة من الديار العربيّة والمسلمة غرباً، أو رسوّ عدد من بلداننا على أوضاع تتهدّدها، كدول – أمم، تهديداً لا يقلّ عن الاندثار… فقياساً بالتذكير الرائج بالاستعمار والإمبرياليّة، إمّا مباشرةً أو مداورةً، لا يزال يحظى بأقلّ القليل الاشتغالُ الفكريّ على ما يطرأ من تطوّرات ومعانٍ، وعلى الأنظمة والتراكيب المجتمعيّة والثقافيّة التي أنتجت شروطنا الراهنة. ذاك أنّ التراكيب والأنظمة تلك لا تعدو كونها عَرَضاً بقياس السبب الجوهريّ الأوّل، فيما الجديد شكل ثانويّ ومُموَّهٌ من أشكال قد يتقمّصها القديم.
والسبب الأوحد، الذي يدير ظهره للزمان وللمكان، يستدعي الكائن الأوحد الذي يدير ذاك السبب ويشغّله. فهو، في الدين الدينيّ، الله الذي يحرّك من غير أن يتحرّك، وفق التعبير الأرسطيّ الشهير، وهو، في الدين المعلمن، القائد أو الزعيم الملهم الذي لا يُساءل في علمه أو حكمته أو نيّاته البلّوريّة.
أمّا القاسم المشترك الآخر بين الدينين فغلبةُ الوعي الضدّيّ عليهما. فعلى عكس إيديولوجيّات “إيجابيّة” كالليبراليّة التي تعد بالحرّيّة، أو الاشتراكيّة الديمقراطيّة التي تلوّح بمصالحة الاشتراكيّة والديمقراطيّة، تكاد تلك الصِيَغ الدينيّة تتعرّى من كلّ تعريف ذاتيّ حين تفقد عمودها الفقريّ الذي هو ضدّيّتها. فالدين الدينيّ ما كان ليعثر على علّة وجوده لولا الشيطان ومكافحة الشيطان، إذ هو الأمّار بالسوء الذي يتعرّق جسده رذيلةً وكفراً وإغراءً بالشرّ، كما يفرز في أوقات فراغه الصعوبات التي تعترضنا في حياتنا الدنيا. وما المسار الدينيّ نفسه سوى صراع متواصل ضدّ شرور الشيطان وآثامه، ممّا يفيض عن حياة امرىء بعينه إلى الحياة نفسها جيلاً بعد جيل. وعند أصحاب الدينين سواء بسواء، تستدعي “رسالةٌ خالدة” كهذه أطناناً من الدماء والشهداء والجماجم بطبيعة الحال، إذ يمكن ردّ أشكال الدين المعلمن كلّها إلى الصراع ضدّ عدوّ دهريّ معيّن قد يكون الاستعمار والغرب عند القوميّين، أو الرأسماليّة عند الماركسيّين، أو الاثنين معاً، ممّا يلتهم الأزمنة والأجيال تباعاً في مواجهةٍ مع “هجمة شرسة” لا تتعب من استهدافنا. هكذا، مثلاً، رأينا ميشيل عفلق يستعير “الألم” و”الإرادة” و”المعاناة” من مسيح مضادّ هو فريدريك نيتشه الذي شاركه ضعفَ الهمّة الجسديّة وإن بدا الفارق بينهما في الهمّة الذهنيّة فاقئاً للعين.
ثمّ لئن تفرّع كلّ من الدينين إلى “عقيدة” و”معتقَد”، فالعقيدة والمعتقد، وهما شقيقا العقدة، صُلبان مشدودان، وبمعنى ما عضليّان، يتّصل طرف كلّ منهما بطرفه الآخر اتّصال طور من أطواره بالطور الآخر. هكذا يغدو لزاماً أن نكون غائيّين، نخرج من ركام المعطيات وقد عثرنا على وجهة حاكمة نجحنا في انتزاعها من كومة قشّ المعاني، وهذا من غير أن يكون هناك ما يربط معطى بمعطى أو معنى بمعنى. وكما ردّت الأديان الدينيّة كلّ أشياء الكون والتاريخ إلى إرادة الله، درجت الأحزاب الشيوعيّة، مثلاً لا حصراً، على إنزال “التحليل الملموس” من الكون إلى المنطقة، مشتقّةً منه تحليلها للمنطقة تلك، قبل أن تستمدّ من التحليل الأخير تحليلاً متماسكاً هو الآخر لأحوال بلد من البلدان في سيره اللولبيّ إلى الاشتراكيّة.
وهذا ما قد يفسّر أحد مصادر المآلات البائسة التي ينتهي إليها نظام كالنظام السوريّ، أو حزب كحزب البعث أو الحزب السوريّ القوميّ حيث لم تعد هناك عقدة أو عقيدة أو معتقد. فالقوى والحركات المذكورة ليست من الدين الدينيّ بطبيعة الحال، إلاّ أنّها أوغلتْ في الرثاثة، ما أفقدها أدنى مؤهّلات الانتساب إلى الدين المعلمن في صلابته وفي درجة تماسكه المطلوبة، فانتهى بها الأمر، أيديولوجيّاً على الأقلّ، تعيّشاً لفظيّاً على ما ترسّب من منظومات الدينين المعتقديّة. ولدينا اليوم ممثّلون كثُر لهذه الرثاثة ربّما كان مصطفى طلاس مؤسّسهم في سوريّا، لكنّ رامي مخلوف هو بالتأكيد، وفي انتظار مَن قد يجود به الزمن الأسديّ، آخر حبّات العنقود.
والشيء نفسه يصحّ في تلك القوى التي انبثقت أصلاً من الدين الدينيّ، لكنّ امتزاجها العميق بالنزعة الميليشيويّة وبحروبها الأهليّة واقتصادها الناهض على أعمال تهريب عابر للحدود زوّد الكثير منها رثاثةً تنأى بها عن تمثيل العقيدة القويمة كائناً ما كان تأويلها. فهذه أيضاً تخرج عن الصلابة المعتقديّة لتنضح دعويّاتٍ تحريضيّة وتهريجيّة وكيتشيّة في آن معاً.
بيد أنّ مسار العلاقة بين الدينين الصلبين جدير، هو الآخر، بشيء من التأمّل. فمنذ نشأة “جماعة الإخوان المسلمين” في 1928، شرع الدين الدينيّ يتعلمن، بمعنى التصالح مع التنظيم السياسيّ ومع أشكال الاستقطاب والتأطير والتعبئة المعهودة في الأحزاب الحديثة. والوجهة هذه اندفعت أبعد فأبعد مع سيّد قطب الذي عجز عن رؤية أيّ جديد يطرحه الواقع من خارج ثنائيّة تكراريّة وأبديّة قطباها الجاهليّة والإسلام. مع هذا، فإنّ نظريّته عن “الجاهليّة الجديدة” تستدعي بالضرورة قدوم نبيّ، يُرجّح أنّه سيّد قطب نفسه، يقوّض الجاهليّة الثانية مثلما قوّض محمّد الجاهليّة الأولى. إلاّ أنّ المُنظّر الإسلاميّ، بفعله هذا، انقضّ أيضاً على “خاتم الأنبياء” فلم يعتبره خاتماً، معتدياً بهذا على فصل أساسيّ من الرواية الدينيّة الإسلاميّة.
وشيء من ذاك التعلمُن كنّا رأيناه في بضع حركات إسلاميّة نضاليّة استعانت بنُتَف من لينين وماو وهوشي منّه، واتّسع قاموسها لـ “الجماهير” و”الكادحين”. لكنْ منذ قيام ثورة الخمينيّ في إيران عام 1979، بات واضحاً أنّ وجهة معاكسة بدأت تعدّل الوجهة الأولى وتضبطها. فرجال الدين أصبحوا، بفعل نظريّة “ولاية الفقيه”، الحكّامَ المباشرين المحتكرين للأبوّة والطاردين لسائر الآباء، فيما مراكز الدعوتين القوميّة والشيوعيّة، في القاهرة ودمشق كما في موسكو، كانت قد أصيبت بالانهاك والتخشّب، فرُوي مثلاً أنّ ليونيد بريجنيف، وهو الماركسيّ العارف بـ “حركة التاريخ والفكر والطبيعة”، بات في سنواته الأخيرة يستشير العرّافات والعرّافين. مذّاك، وعلى صعيد المنطقة كلّها، غدا انضواء الدين المعلمن في عباءة الدين الدينيّ أقوى من انضواء الأخير في عباءة الأوّل. فبعدما كان “الإسلام” و”الاشتراكيّة” يُلحَقَان إلحاقاً تبعيّاً بـ”العروبة” و”القوميّة العربيّة”، كما كانت الحال مع الناصريّة والبعث المبكر، أضحت “العروبة” و”الاشتراكيّة” وما تبقّى من سقط متاع الحقبة الآفلة تُلحَق بـ”الإسلام”. هكذا بِتنا نرى كيف أمست أحزاب وحركات دينيّة، كـ”حزب الله” اللبنانيّ و”حماس” الفلسطينيّة و”النهضة” التونسيّة وسواها، هي أمّهات الراديكاليّة في بلدانها، يصطفّ وراءها حطام أحزاب الدين المعلمن من شيوعيّة وماركسيّة وقوميّة وسواها. لا بل نشهد في اعتماد نظام مائع الهويّة وعديم العقدة والعقيدة، كالنظام السوريّ، على الدعم الإيرانيّ ودعم “حزب الله”، وفي ارتهان بقائه بهذا الدعم، برهاناً على الوجهة إيّاها. فليس من المبالغة أن يقال أن منطق العلاقة اختلف تماماً، إذ بعدما كان نظام الأسد هو الذي يحمي نموّ “حزب الله” ويرعى تمدّد النفوذ الإيرانيّ إلى لبنان وفلسطين، صار العكسُ القاعدةَ السائدة.
والارتفاع هذا في نسبة التطابق بين الدين المعلمن والدين الدينيّ، لصالح الأوّل مرّة ولصالح الثاني مرّة أخرى، لا يزيد مقدار المآسي ولا يقلّلها، فهي كثيرة في الأحوال جميعاً. إلاّ أنّ بعض ما نعانيه راهناً، وعلى نطاق كونيّ، هو نجاح بعض الشعبويّات الحاكمة في إحداث تركيب مستقرّ نسبيّاً بين هذين الدينين، ومن ثمّ إحكام السيطرة على ذاك التركيب. مثل هذا، وكأمثلة غير حصريّة، بِتنا نجده في بلدان كتركيّا إردوغان وإسرائيل نتانياهو وبن غفير وهند مودي وهنغاريا أوربان وروسيا بوتين وصين جانبينغ وبرازيل بولسونارو… حيث يرزح فوق الصدور الدينان القويّان معاً، فيقترن دين معلمن، تمثّل القوميّة الشوفينيّة ذراعه الضاربة، ودين دينيّ يشدّ إزر الأوّل بطرق شتّى. كذلك لم تعد القوى الشعبويّة، القوميّة على نحو أو آخر، قليلة النفوذ في الولايات المتّحدة ومعظم بلدان أوروبا الغربيّة، بينما تنضوي في قوميّاتها منازع دينيّة وعبادات للقوّة ممزوجة بكره الغريب.
ولم تعد خطورة هذا التطوّر بحاجة إلى الاستنجاد بالمبالغات التعبيريّة توكيداً لضخامتها، إذ نمّ الغزو الروسيّ لأوكرانيا عن حقيقة أنّ الاحتمال النوويّ لم يعد شديد الاستبعاد، وهذا فيما تتوسّع رقعة الحرب والتدمير والسطو على الأرض والسكّان ضامّةً إليها المنطقة التي ظُنّ أنّها طلّقت احتمالات كهذه وصارت القاعدة الأكثر ترشيحاً لأن ينطلق السلام منها إلى باقي العالم. وفي مناخ كهذا شاهدٍ على انحسار القيم التنويريّة والتعدّديّة، يتحوّل بعض الفِرَق الحاملة لمطالب مُحقّة، كنظافة البيئة والمساواة الجندريّة ومكافحة العنصريّة، فِرَقاً متعصّبة تحاول فرض هذا اللون أو ذاك من ديكتاتوريّة الصواب المتخم باليقين. ولا يفوت، في هذه الأشكال الكثيرة من التسليم، ذاك الحضور القويّ للعنصر الشابّ الذي يرفدها بطاقة حماسيّة متأجّجة وبلون جيليّ يغلب عليه الإصرار الملحميّ وضرب المواعيد الخلاصيّة والمحتَّمة.
وإذ يغدو الاقتصاد النيوليبراليّ أقرب، هو الآخر، إلى معتقد دينيّ لا ترفّ له عين أمام عذابات البشر، نجد أنّ الطاقات الشبابيّة التي تستقطبها العلوم المضبوطة، أو التي تمتصّها التطوّرات التقنيّة الجبّارة ممّا يشهده عالمنا، تزداد نأياً عن السياسة، أو تمارس التنفيس عنها بوسائط التواصل الاجتماعيّ، وهذا ناهيك عن المداخلات ما بعد الحداثيّة على أنواعها في توكيدها على أنّ كلّ واقع مستحيل، وكلّ حقيقة موضوعيّة مجرّد واحدة من “سرديّات” كثيرة تتساوى في صلاحها أو في طلاحها.
وكائناً ما كان الأمر يبقى أنّ ارتفاع نسبة التطابق بين الدينين، خصوصاً في منطقتنا، إنّما يشي بأنّ طلب الحرّيّة، بوصفها ولادة لـ”الأنا” المتفلّتة من قيود المرجعيّات المطلقة والمغلقة، هو إمّا ضعيف جدّاً أو مقموع جدّاً، وأغلب الظنّ أنّ الوصفين صحيحان. فالفرد الحرّ، في هذه الرقعة من العالم، مرشّح لسحق يمارسه الدينان، متحالفَين أو متعارضين، متكاملين أو متنابذين، كما تمارسه ثُـفالة الدينين معاً، على ما تدلّ أنظمة أمنيّة كثيرة نجحت في ضرب ثورات “الربيع العربيّ” وعاودت التربّع فوق أطلال مجتمعاتها.
وقد نضيف ما علّمنا إيّاه إريك فروم حول الخوف من الحرّيّة بوصفها مسؤوليّة. والحال أنّ الدينين تعاقبا على جعل الأفراد أقلّ فرديّة وتحمّلاً للمسؤوليّة، ومن ثمّ أقلّ تثميناً للحرّيّة. وفي الميل المستشري إلى الإذعان والتبعيّة هذا، بِتنا نَهباً لعمليّة مديدة من التبادل بين الدينين: يتلقّفُ الدين المعلمن مَن ينفرون من الدين الدينيّ فيسلّمهم إلى إله معلمن هو القائد والزعيم. فإذا اتّضح لهم، بالمعاناة واللحم الحيّ، أنّ الأخير لن يأتيهم بالخلاص المنشود استردّهم الدين الدينيّ، أو استردّ معظمهم، إلى إلهه، وهو، على ما نعلم، غفور رحيم.
أمّا المجتمعات التي تشقّها العصبيّات، على ما هي حال معظم مجتمعاتنا، ففيها تُكتَب للدينين معاً حياة أطول. فهنا يرتسم الله خادماً للجماعة مثلما تتطوّع الجماعة لخدمة الله أو لخدمة مَن تكلّفه بهذا المنصب. والحقّ أنّ ما ينشأ بين الطرفين يشبه العقد الدائم، حيث لا بدّ للجماعة من إله دينيّ أو معلمن، فيما لا بدّ للإله من جماعة تعلن أنّها تفديه “بالروح، بالدم”.
وتجد الوجهة هذه ما يدعمها في سياسات أرض محروقة تنفي السياسة والتبادل السياسيّ من أساسهما. ففضلاً عن انهيار الروابط الوطنيّة في عديد البلدان، وما أحدثته الهجرات وأعمال التهجير الكثيرة والكثيفة من تعديل للخرائط الداخليّة، ينتشر اليوم تعميمٌ لـ”سياسات” الاستيلاء على الأرض وطرد السكّان ممّا بدأته إسرائيل بحقّ الفلسطينيّين واعتمده صدّام حسين بحقّ الكرد. ففي سوريّا كما في اليمن تباشر الديموغرافيا الحلول محلّ السياسة استيطاناتٍ صغرى قابلة للتمدّد في موازاة الكراهيّات التي تتنامى والحلول التي تستعصي.
فالسياسة الوطنيّة التي تنتف الديموغرافيا ريشَها الأيمن في حرب داخليّة على الموارد، يتعرّض ريشها الأيسر لنتف آخر تمارسه الجغرافيا السياسيّة في حرب إقليميّة ودوليّة على الموارد إيّاها. وهكذا يغدو مفهوماً أن تصطبغ وحدة المعارضات الوطنيّة داخل البلدان المعنيّة بالاستحالة. هكذا يتظاهر المحتجّون الشيعة في العراق، من دون أن ينضمّ إليهم السنّة عرباً وكرداً، ومن دون أن يُدعَوا إلى ذلك، ويدافع اليهود الإشكناز في إسرائيل عن ديمقراطيّة لا تُعنى بمسائل الاحتلال والاستيطان، فلا تقرب حركةُ الاعتراض العربَ ولا يقربها العرب. ولا تكاد شخصيّة سوريّة عامّة، سياسيّة أو ثقافيّة، تفارق الحياة، حتّى يطلع غبار المعارك بين السوريّين من ساحات التواصل الاجتماعيّ، وهذا فيما يخرج اللبنانيّون من تجربتيهم الوحدويّتين في 14 آذار و17 تشرين بدرس مفاده أنّ العزلة خير من أخلاط السوء. وليس بعيداً من تلك اللوحة التي ترسمها “حرب الكلّ على الكلّ” وانكفاؤنا المتعاظم إلى “حالة الطبيعة” أنّ أوضاع النساء تزداد تردّياً بوتائر متسارعة، فيما تخوض “الرجولة” حروبها المتوالية لطردهنّ من الفضاء العامّ بعد معسهنّ في الفضاء الخاصّ، مع حفظ حقّهنّ في الاختيار ما بين أفق إيرانيّ وديع وأفق أفغانيّ فظيع.
وبينما يقتات التديّن على أنواعه من انسداد الحلول والمراوحة في العجز، تصطفّ قضايا المنطقة تباعاً وراء القضيّة الفلسطينيّة بوصفها استعصاء مؤلماً ومضجراً في الوقت عينه، فإذا بنا أمام قضايا لبنانيّة وسوريّة وعراقيّة “لا يحلّها إلاّ الله” كما يعلن المؤمنون. وهي جميعاً تزجّنا في مسار هذا التديّن أو ذاك فنروح، بحسب أحد الأمثلة المكسيكيّة، نسمّي أمورنا في أزمنة السلام سانتا ماريّا، ونسمّيها هي نفسها في أزمنة الحرب زابّاتا.
وبينما تنهار منطقة المشرق اقتصاديّاً، وفي سوريّا ولبنان تتجسّد طلائع الانهيار هذا، لا يعدنا التصفير الاقتصاديّ بغير التصفير السياسيّ، تاركاً للمعوّلين على “الإفقار المطلق” أن يمضوا في ملء غربالهم بأنهار “النظريّة” الطبقيّة المتدفّقة. ومع التصفيرين ينمو التصفير الفكريّ الذي يستفيد من هجرة المتعلّمين ومن لجوء المثقّفين، مثلما يستفيد من تقاليد محلّيّة لا تعلّم إلاّ الصراع وليس لديها ما تقوله عن السلام.
وهذه كلّها طرق، مباشرة أو التفافيّة، إلى الدين المنشطر دينين رئيسين. وفي مواجهة دينين قويّين، لا يعود يكفي إلحاد واحد، إذ لا بدّ من إلحادين. فكما سبقت الإشارة، كثيراً ما كان الإلحاد في أحد الدينين يفضي إلى تديّن في الدين الآخر. واليوم يتسارع، بقوّة رَفْشين اثنين، حفر الخندق الذي سوف نُطمر فيه زرافات ووحداناً فيما نحن نتردّد بين هذا الدين وذاك.
المصدر: صفحة عادل خوري