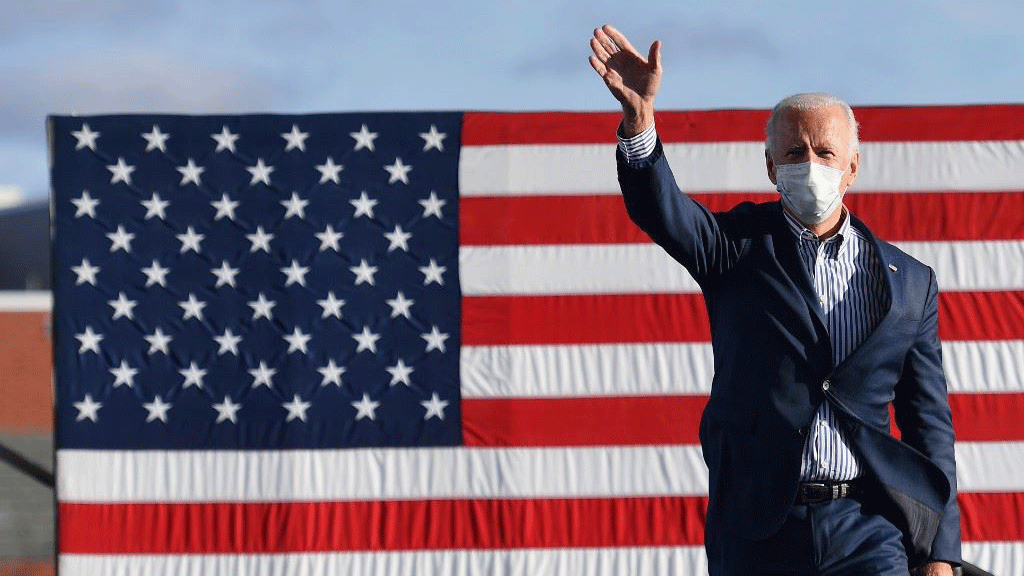
نجاح إدارة بايدن في التقدّم نحو إحياء الاتفاقية النووية JCPOA مع إيران، برغم التحفّظ الإسرائيلي، لافت سياسياً وديموغرافياً، ويطرح الأسئلة حول نوعيّة العلاقة الأميركية – الإسرائيلية التي بقيت عضويّة لعقود حتى بعدما مرّت في مراحل توتّر متقطّعة. المثير للفضول هو دوافع ونتائج التوافق العلني الأميركي – الإيراني – الإسرائيلي الذي يتقاطع بين الانتخابات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية في زمن تحوّل أميركا يساراً، وتعمّق إسرائيلي يميناً، وحصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية استثماراتها في تسلّط الثيوقراطية وفي الورقة النووية.
قد يكون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دور في التطوّرات على الساحة الدولية، لأن عهده تميّز بالاضطراب على الصعيد الداخلي الأميركي وعلى المستوى العالمي. بغض النظر عن حسن سياساته أو سوئها، بصمة ترامب كانت بصمة الاستفاقة يومياً على القلق والتوتّر من مفاجآته غير الاعتيادية، بل الاعتباطية. زرع، من دون أن يقصد، تشوّق الناس الى الاستراحة من الإرهاق الذي تسبّب به، والى النمطيّة، حتى وإن كانت مملّة. البعض انتقم منه حيث للانتقام أثر، مثل طبقة “وول ستريت” التي هجرته والإعلام الذي استهدفه، ومثل شريحة جيل الشباب الذي أسقطه انتخابياً.
الرئيس جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية، جزئياً، بسبب رفعه شعار الهدوء في وجه الضجيج. إنه اليوم ماضٍ في طبع بصمة التهدئة والرتابة على سياساته الداخلية والخارجية، برغم ضخامة التحوّل في بعض السياسات الخارجية الأميركية، خصوصاً نحو إيران وإسرائيل. ويبدو أن الرأي العام الأميركي، بأكثريته، مرتاح الى خيارات رئيسه، متشوّق الى تعافيه من آثار كوفيد-19 والعودة الى الحياة الطبيعية.
العناوين الرئيسية للسياسات الخارجية للرئيس بايدن هي أولاً إعادة رصّ الصفوف بين الولايات المتحدة وحلفاء شمال الأطلسي (ناتو)، لحشد المواقف المتطابقة في مختلف الملفات، وأبرزها ملف الصين. وهذا سيكون واضحاً أكثر في المواقف التي ستصدر عن الاجتماعات المهمّة التي سيحضرها بايدن في قمة مجموعة السبع G7 وفي القمة الأميركية – الأوروبية في الأيام العشرة المقبلة. فالصين تبقى أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، وإدارة بايدن ترى أن تمتين الشراكة الأميركية – الأوروبية حيوي وضروري وأساسي لنجاح السياسة الأميركية الاستراتيجية البعيدة المدى نحو المُنافس الأكبر: الصين.
هذه العلاقة الأميركية – الأوروبية في عهد الرئيس بايدن هي التي أدّت الى الانقلاب السريع على سياسات الرئيس ترامب نحو إيران والذي سيُتوّج باتفاق – الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين – قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 الشهر الجاري. فريق بايدن لم يخفِ يوماً أن أولى مهماته عند فوزه بالرئاسة ستكون إحياء الاتفاقية النووية مع إيران، واستئناف العلاقات الودّية التي بنتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهو الفريق ذاته في العهدين، وهو على عهده نحو طهران بفصل المسألة النووية عن مسألة الصواريخ البالستية وعن السلوك الإيراني الإقليمي “الخبيث”، كما يحلو لإدارة بايدن وصف السياسات الإيرانية الإقليمية، تعويضاً.
اللغز يكمن في تقاطع العلاقات الأميركية – الإيرانية مع العلاقات الأميركية – الإسرائيلية وما بينهما في العلاقة الإيرانية – الإسرائيلية الباطنية. لسببٍ ما، هناك ودٌ أميركي شعبي نحو إيران برغم احتجازها بعد الثورة رهائن أميركيين لمدة 444 يوماً، وبرغم العداء المُعلن من حُكام طهران نحو أميركا، والذي تمثّل في أكثر من عملية طالت دبلوماسيين وأميركيين عاديين. فالأميركيون اختاروا التسامح مع إيران. اختاروا الخوف من قدراتها النووية ومشاريعها العالمية. قرّروا نسف العراق برمّته لأنه تجرّأ على الحلم بامتلاك قدرات مماثلة وأسلحة متطورة، فساهموا بقتل علمائه. اجتاحوه واحتلوه وتركوه تحت السيطرة الإيرانية، واستخدموا إرهاب 9/11 كذريعة تبرّر كل ذلك، متناسين تماماً كل ما فعلته إيران قبل تاريخ 9 أيلول (سبتمبر) 2001.
ذلك التاريخ بات تاريخ العداء والكراهية للعرب بسبب ارتكابهم تلك الجريمة الفظيعة. لكن الكراهية لم تولد يومها، بل هي تاريخية برغم كل ما قدّمه العرب نفطياً واستراتيجياً لأميركا. ولعل السبب هو إسرائيل، بالدرجة الأولى.
إسرائيل وإيران لم تدخلا حرباً مباشرة بينهما في تاريخهما، وكل معاركهما كانت بالنيابة، عبر لبنان بالدرجة الأولى وعبر مختلف الوكلاء. المسألة النووية أتت لتمتحن العلاقة الأميركية – الإسرائيلية في عهد الرئيس أوباما الذي لم يبرم الاتفاقية النووية فحسب، بل نفّذ للجمهورية الإسلامية الإيرانية كامل مطالبها: الاعتراف بشرعية النظام، الموافقة على “حق” إيران بامتلاك القدرات النووية المدنية والتي تحوّلت قدرات نووية عسكرية، وعدم التدخل في سياسات طهران الإقليمية التوسّعيّة في الجغرافيا العربية. وهذا تماماً ما تقدّمه إدارة بايدن لإيران.
لماذا تمكّنت إدارة أوباما من تمرير الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برغم كل ما قيل عن معارضة إسرائيلية للصفقة؟ لعلّه اللغز. لعلّ إسرائيل لم تضع ثقلها وراء اعتراضها على الصفقة، لا حينها، ولا الآن عند إحيائها في عهد إدارة بايدن. فبعيداً عن نظريات المؤامرة، الثابت هو التزام الولايات المتحدة القاطع بتفوّق إسرائيل – نوعياً وكميّاً – عسكرياً في كامل الشرق الأوسط. هذا لم يتأثّر بالصفقة مع إيران قبل سنوات، ولن يتأثر بها الآن، حتى إشعار آخر.
فإسرائيل دولة نووية لا تتحدّاها أيّ دولة كبرى، لا الولايات المتحدة ولا الصين ولا روسيا ولا أوروبا. إيران دولة لها القدرات النووية، والهدف الأميركي والأوروبي المُعلن هو منعها من تحويل القدرات الى امتلاك فعلي للقنبلة النووية.
ثانياً، والى جانب أولوية “منع” إيران من الوصول الى امتلاك القنبلة النووية، تقدّم إدارة بايدن الى إسرائيل موافقة إيرانية ضمنية على عدم تفعيل أي جبهات ضدها تحت أي ظرف كان، لا باسم فلسطين والمقاومة، ولا عبر صواريخ وكلائها في لبنان أو سوريا أو غزة، ولا بمعارضتها الفعلية للتطبيع بينها وبين دول عربية.
هذه ليست مجرد تطمينات إرضائية. إنها جزء من التفاهمات غير المُعلنة التي تنوي إدارة بايدن، عبر الأوروبيين وبصورة مباشرة، إثبات جدواها. بالطبع، السؤال هنا هو: ماذا لدى أميركا وأوروبا من أدوات تأثير على إيران ما بعد رفع العقوبات عنها، والتي ستدرّ عليها الأموال الباهظة لاستخدامها كما ترتئي القيادات الإيرانية، وفي مقدمتها الحرس الثوري القائم على صنع المشروع الإيراني الإقليمي وتنفيذه.
يبدو أن أميركا وأوروبا لا تكلّفان نفسيهما كثيراً التفكير إذا كان المشروع الإيراني هو تصدير الثورة الى الدول العربية، أو إذا كان جعل إيران القوة الإقليمية الكبرى في الشرق الأوسط، خارج إسرائيل. فالغرب لا يبالي بنوعية القِيَم والممارسات التي يتبناها الحرس الثوري لا داخل إيران ولا في جيرتها. هوسه نووي وليس هوساً “ديموقراطياً” أو عقائدياً أو ذا علاقة بحقوق الإنسان أو مفهوم السيادة للدول.
ما ستسعى وراءه إدارة بايدن بشراكة أوروبية هو إضعاف التطرّف في الساحة العربية – سنيّاً – وفي الساحة الفلسطينية عبر إضعاف حركة “حماس” مع تبني مبدأ “التهدئة”. إحياء “حل الدولتين” لن يلاقي معارضة إيرانية علنية، وهذا في رأي الشريكين في حلف الأطلسي، إنجاز. أما عن الخطوات العملية، فهي ستكون عبر إعادة بناء غزة وعبر إعادة الاعتبار الى السلطة الفلسطينية. غير ذلك ليس وارداً في الأولويات الغربية، برغم كل المؤشرات الواضحة الى تعمّق اليمين الإسرائيلي المتطرّف في الحكم وتداعيات هذا التطرّف على الفلسطينيين تحت الاحتلال. وفي غزة، والأخطر على الفلسطينيين داخل إسرائيل ومصيرهم لاعتبارات ديموغرافية.
التعاطف الشعبي الأميركي والأوروبي مع الفلسطينيين ما بعد حوادث غزة له مردود بالطبع، بالذات على قدرة الحكومات الأميركية والأوروبية على النظر في سياسات أقل انصياعاً لما تفرضه إسرائيل كأمر واقع، كعادتها. لكن ليس لدى الدول الغربية خريطة طريق فعليّة لحل جذري للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وهذا مخيف. مخيف لأن التهدئة مجرد تحذير، ولأن التفاهمات الإيرانية – الإسرائيلية الضمنية ليست أبداً مشروع حل لمعاناة الفلسطينيين الذين يلقون التعاطف الشعبي الأميركي والأوروبي، مرحلياً وموقتاً.
فيسار أميركا وأوروبا لن يتلاقى مع يمين إسرائيل. والسؤال هنا هو: هل سينمو التعاطف الى حركة جديّة تؤثر جذرياً في السياسات الأميركية نحو إسرائيل؟ السؤال الآخر هو: الى أي مدى ستتمكّن إدارة بايدن من احتواء الانقسامات الأميركية الداخلية في شأن إسرائيل وإيران؟
الأهم هو مراقبة ما يحدث وسيحدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب إحياء الاتفاقية النووية ورفع العقوبات عنها، وتموضعها الخارق بين الأحضان الأميركية والأوروبية والصينية والروسية وكذلك الإسرائيلية.
المصدر: النهار العربي







