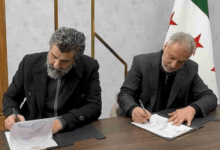منذ عودة دونالد ترامب إلى صدارة المشهدين السياسيين، الأميركي والعالمي، لم يعد كافياً الاكتفاء بتحليل خطابه الشعبوي، أو قراءة سياساته بوصفها انعكاساً لنزعة فردية صدامية أو حسابات انتخابية ظرفية، فخلف هذا المشهد الصاخب، يبرز سؤال أكثر عمقاً وإلحاحاً: من الذي يفكّر للترامبية؟ ما المرجعيات الإيديولوجية التي تؤطّر خياراتها؟ وإلى أي أفقٍ سياسيٍّ وفكريٍّ يمكن أن تقود الولايات المتحدة، والعالم معها، إذا ما وطّد هذا التيار موقعه في السلطة؟
يقود الجواب إلى تيار فكري ظلّ طويلاً على هامش النقاش العام، قبل أن يتسلّل بهدوء إلى دوائر التأثير والنفوذ، ويتموضع اليوم بوصفه أحد أخطر البنى الإيديولوجية التي تهدّد الديمقراطية الليبرالية من داخلها. إنه تيار الرجعية الجديدة “النيوريَاكسيونيزم” (Neoreactionism)، المعروف أيضاً باسم “الأنوار المظلمة” (Dark Enlightenment)، الذي لم يعد مجرّد نزعة فكرية رقمية أو نقاش نخبويّ معزول، بل تحوّل إلى إطار نظري يمنح السلطوية الجديدة مبرّرات فلسفية، ويعيد تعريف مفاهيم الحكم، والدولة، والشرعية السياسية.
نشأت “النيوريَاكسيونية” في بدايات الألفية الجديدة داخل فضاءات الإنترنت، من مدونات ومنتديات تقنية، في أوساط ليبرتارية شعرت بخيبة أمل عميقة من الديمقراطية الليبرالية ومن المشروع التقدّمي برمّته. وفي هذا السياق، برز اسم كورتيس يارفين، الذي كتب تحت الاسم المستعار “مينسيوس مولدبَغ”، بوصفه المنظّر الأبرز لهذا التيار، والمفكّر الذي نجح في تحويل السخط الليبرتاري على الدولة إلى مشروع فكري متكامل يستهدف تقويض فكرة الديمقراطية ذاتها.
حين تتحرّر السلطة من أي التزام أخلاقي أو ديني أو إنساني، وتُختزل السياسة في تقنية للحكم، يصبح كل شيء مباحاً بما في ذلك تقويض الدساتير
ينطلق التشخيص النيوريَاكسيوني من فرضية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها شديدة الجذرية في نتائجها مفادها بأن الديمقراطية، في نظرهم، نظام فاشل بطبيعته، ينتج الفوضى بدل الاستقرار، ويكافئ الرداءة بدل الكفاءة، ويشلّ القدرة على اتخاذ القرار الحاسم. فالانتخابات، وتعدد مراكز السلطة، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، لا تُعدّ، وفق هذا المنظور، مكاسب حضارية، بل عوائق بنيوية أمام ما يسمونه “الحكم الفعّال” و”الإدارة العقلانية للدولة”.
ولا تنتمي هذه الرؤية إلى المحافظة التقليدية، ولا إلى حنين ديني أو أخلاقي إلى الماضي. فالنيوريَاكسيونية لا تدافع عن القيم الدينية ولا عن الأخلاق المحافظة، بل تقدّم نفسها تياراً عقلانياً، تقنياً، “واقعياً”، يسعى إلى إعادة هندسة السلطة على أسس إدارية صارمة، هرمية، وسلطوية، حيث لا مكان للسياسة بوصفها تعبيراً عن الإرادة الشعبية، بل مسألة تقنية تُدار بالكفاءة لا بالتمثيل.
في قلب هذا المشروع الفكري تقبع أطروحات كورتيس يارفين، التي يمكن اختزالها في تصور واحد شامل لما بعد الديمقراطية. فالدولة، في نظره، يجب أن تُدار كما تُدار شركة سيادية، يقودها “مدير تنفيذي” يتمتع بسلطات شبه مطلقة، لا يخضع لانتخابات، ولا لمساءلة شعبية، ولا لقيود مؤسساتية. أما المواطنون، فلا يُنظر إليهم فاعلين سياسيين، بل مستفيدين أو زبائن، يحق لهم “تغيير الخدمة” إن لم تعجبهم، لا تغيير النظام.
في هذا التصور، لا تُعدّ الحرية حقاً أصيلاً أو قيمة أخلاقية، بل نتيجة ثانوية للنظام والانضباط. كما تُختزل العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وحماية البيئة، وحقوق الأقليات، في كونها قضايا هامشية، أو حتى عوائق أمام الفعالية والاستقرار. وهكذا تُفرَّغ السياسة من بعدها الإنساني، وتتحول إلى مسألة تقنية باردة، تُدار بالأرقام لا بالقيم، وبالضبط لا بالمشاركة.
لا تُعدّ الحرية لدى تيار الرجعية الجديدة حقاً أصيلاً أو قيمة أخلاقية، بل نتيجة ثانوية للنظام والانضباط
غير أن خطورة النيوريَاكسيونية اليوم لا تكمن فقط في راديكاليتها الفكرية، بل في انتقالها من الهامش الرقمي إلى قلب السلطة، فقد نجح هذا التيار في بناء جسور قوية مع نخب وادي السيليكون، التي ترى في الديمقراطية عبئاً على الابتكار والهيمنة الاقتصادية، وتحظى بدعم شخصيات نافذة مثل بيتر ثيل (المهندس الغامض لوادي السيليكون)، ومارك أندريسن (رجل الأعمال الأميركي ومهندس البرمجيات البارز في عالم التكنلوجيا). كما تسللت أفكارها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دوائر سياسية مقرّبة من ترامب، من بينها جي دي فانس (نائب الرئيس) ومايكل أنطون (مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية).
وبذلك، لم تعد النيوريَاكسيونية مجرد تنظير فكري، بل إنها اليوم الوحيدة القادرة على مساعدتنا لفهم تصرفات ترامب، وسلطويته، وسعيه الدائم لإضعاف الضوابط الدستورية، وازدرائه للإعلام، وتقويضه لاستقلال القضاء، واستخفافه بالقانون الدولي. هذا التفكير يمنح الترامبية إطاراً نظرياً بديلاً يُشرعن حكم القوة بدل حكم القانون، ويحوّل كل ما هو استثناء إلى قاعدة.
وعلى الصعيد الدولي، لا تقلّ “النيوريَاكسيونية” خطورة، فهي تحمل تصوراً نيوكولونيالياً صريحاً للعلاقات بين الدول، يقوم على منطق القوة العارية التي تؤمن بأن الدول القوية هي التي يجب أن تحكم، وعلى نظيرتها الضعيفة أن تقبل أن تُدار. ففي منطق هذا التفكير فإن مفاهيم مثل السيادة ليست حقاً، بل امتياز مؤقت يجب ألا يكتسبه سوى الأقوياء. أما السلام فهو لا ينبع من التعاون أو القانون الدولي، بل من الهيمنة الكاملة والإخضاع التام. والأمر نفسه بالنسبة للحرب فهي ليست نتيجة لفشل السياسية، بل أداة من أدوات إدارة العالم، ما يعيد شرعنة العنف ويقوّض النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية على القواعد التي نرى اليوم ترامب يقوضها واحدة تلو الأخرى.
لا تكتفي “النيوريَاكسيونية” بانتقاد الديمقراطية أو فضح عيوبها، بل تسعى صراحة إلى تجاوزها نحو نظام سلطوي متكامل. وتكمن خطورتها في أنها لا تقدّم نفسها بوصفها استبداداً فجّاً، بل على أنها “حل عقلاني” و”بديل واقعي” لأزمات عالم مأزوم. إنها لا تهاجم القيم مباشرة، بل تُفرغها من معناها، وتستبدل المشاركة بالطاعة، والمواطنة بالإدارة، والشرعية بالقوة.
تيار بلا مكابح قيمية، يرى في القوة معياراً وحيداً للشرعية، وفي الفعالية بديلاً عن العدالة، وفي الهيمنة مبدأً ناظماً للعلاقات الدولية
ومن الضروري، لفهم طبيعة هذا التهديد الإيديولوجي، التمييز بين الرجعيين الجدد (النيوريَاكسيونيين) والمحافظين الجدد الذين طبعوا السياسة الأميركية خلال عهدي جورج بوش الأب والابن. فالمحافظون الجدد، رغم ما اقترفوه من كوارث استراتيجية وحروب مدمّرة، خصوصاً في العراق وأفغانستان، ظلّوا يتحرّكون داخل أفق إيديولوجي تقليدي تحكمه منظومة قيم واضحة تقوم على الإيمان بالديمقراطية الليبرالية، ولو بشكل تبشيري ومشوَّه، الدفاع عن الدولة القومية، والاحتكام، ولو انتقائياً، إلى خطاب أخلاقي يستند إلى مفاهيم مثل الحرية، وحقوق الإنسان، والدور “الرسالي” لأميركا في العالم. كانت سياساتهم عدوانية، لكنها سعت دائماً إلى شرعنة نفسها أخلاقياً وقانونياً، سواء عبر المؤسسات الدولية أو الخطاب القيمي.
أما الرجعيون الجدد، فإنهم يمثلون قطيعة جذرية مع هذا الإرث، فهم لا يؤمنون بالديمقراطية لا قيمة ولا أداة، ولا يعترفون بحقوق الإنسان مرجعية كونية، ولا يستندون إلى دين يقيّد عنف السلطة أو إلى أخلاق سياسية تضبط ممارستها. إنهم تيار بلا مكابح قيمية، يرى في القوة معياراً وحيداً للشرعية، وفي الفعالية بديلاً عن العدالة، وفي الهيمنة مبدأً ناظماً للعلاقات الدولية. وهم واضحون، لا يسعون إلى “نشر الديمقراطية”، بل إلى إدارتها أو تجاوزها، ولا يبرّرون الحروب بخطاب أخلاقي، بل يدرجونها ضمن منطق الإدارة والربح والخسارة.
تكمن خطورة الرجعيين الجدد تحديداً في هذا الفراغ القيمي، فحين تتحرّر السلطة من أي التزام أخلاقي أو ديني أو إنساني، وتُختزل السياسة في تقنية للحكم، يصبح كل شيء مباحاً بما في ذلك تقويض الدساتير، وسحق المعارضين، وإعادة رسم الخرائط، وتطبيع العنف بوصفه أداة عقلانية. وإذا كان المحافظون الجدد قد أساءوا استخدام القيم، فإن الرجعيين الجدد يسعون إلى إلغائها من الأساس، وهو ما يجعلهم أكثر تهديداً للديمقراطية، وللسلم العالمي، ولمستقبل النظام الدولي برمّته.
المصدر/ العربي الجديد