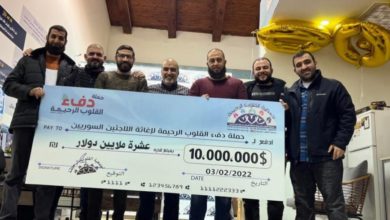كانت الطقوس الدينية قبل قيام “الدولة”، وقبل الهجرات اليهودية إلى فلسطين، الرابطَ الذي يربط اليهود بعضهم ببعض، وكانت الإطار الذي يشكّل الهوية اليهودية، وهي التي تحافظ على العلاقات الاجتماعية المتينة في ظلّ عدم وجود كيان سياسي يجمع شمل اليهود في العالم. كان ذلك يعني أنّ الحاخامات ورجال الدين هم أصحاب المكانة المُتقدّمة؛ بحكم مسؤوليتهم عن فهم الدين وقيادة الشعائر الدينية، وهذا مكّنهم من أداء أدوار اجتماعية كبيرة بين أبناء الطائفة، علاوة على الدور السياسي بحكم أنّهم حلقة الوصل بين أبناء الطائفة والسلطات الحاكمة. هكذا إذاً، كان اليهود يعيشون تحت سلطة دينية، ولم يكن هناك أيّ وجود للعلمانية إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية، التي اتّخذ أغلب رجال الدين وأتباعهم في البداية موقفاً سلبياً تجاهها نتيجة علمانية مؤسّسيها، ولأنّ انتشارها، أي الصهيونية، كان سيخصم من سلطتهم الدينية. ومع الوقت، أصبحت الصهيونية هي الغالبة، وكثر أتباعها، حتّى اضطر كثيرون من رجال الدين، والمُتديّنين إلى التصهين.
لم يؤدّ تصهين رجال الدين إلى نهاية عدائهم مع الصهيونية العلمانية نفسها، فقد كان تصهينهم جزءاً من الصراع على السلطة والمكانة، بين الدين، الذي يتصدّرون طقوسه، والعلمانية. ولم يختفِ هذا الصراع أو يتوقّف مطلقاً، وظلّ مُستمرّاً بين صعود وهبوط، وبين إنجاز وإخفاق. لكنّ الوقت كان في صالح المُتديّنين منذ أن قامت الدولة، التي أراد ديفيد بن غوريون أن تكون هي المُتحكّمة بالدين. كانت هناك عوامل عدّة أسهمت في تصاعد نفوذ رجال الدين في إسرائيل وفرض كلمتهم في أحيان كثيرة. ولا شكّ أنّ النظام البرلماني كان أحد هذه العوامل المُؤثّرة، التي أتاحت للمُتديّنين مراكمة المكاسب؛ فالنظام البرلماني في إسرائيل لم ينتج في أيّ يوم من أيامه حكومة الحزب الواحد، وكانت نتائج الانتخابات طوال الوقت تُفضي إلى حكومات ائتلاف كانت الأحزاب الدينية طرفاً فيها، في أحيانٍ كثيرة. وقد أدّى ذلك إلى أن أصبح لدى هذه الأحزاب القدرة على جعل اهتماماتها الدينية والطقسية على سلّم أولويات الحكومة، حتّى إنّ بعض الحكومات جرى حلّها نتيجة مخالفة بعض الشعائر الدينية وانسحاب الأحزاب الدينية منها.
من بين العوامل، أيضاً، الديمغرافيا في إسرائيل، ومعدّل المواليد في الأوساط المختلفة، وارتفاعه في أوساط المُتديّنين اليهود على وجه الخصوص. فحسب التقرير الصادر عن هيئة المسح السكّاني الإسرائيلي لعام 2023 يصل مُعدّل الإنجاب في أوساط الحريديم إلى ما يقارب سبعة أطفال في الأسرة، بينما يقلّ في أوساط اليسار والعلمانيين والطبقات الأعلى اجتماعياً إلى أقلّ من طفلين، وهذا يعني تزايد نسبة المُتديّنين وتراجع العلمانيين بالضرورة. ووفقاً للتقديرات، فإنّ تعداد الحريديم وحدهم، من دون حساب فئات دينية أخرى، يتخطّى حالياً 1.3 مليون نسمة، بنسبة تقارب 14% من إجمالي السكّان، ومن المقدّر أن تتصاعد في المستقبل لتصل إلى 50% من مجمل السكّان اليهود وحدهم في إسرائيل، بحلول عام 2059. وهذه النسب قد تزداد بمُعدّل أكبر من المذكور إذا صدقت دراسة أخرى أعدّها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تتوقّع هجرة عكسية للعلمانيين إلى الخارج. وتقلق هذه الزيادة السكّانية العلمانيين الإسرائيليين الذين أصبحوا يشعرون، حسب ما نشره موقع فورين بوليسي في يوليو/ تموز الماضي، بالخطر الشديد من وصول المُتديّنين إلى ذروة جديدة، وامتلاك الأحزاب الدينية قوةً أكبر مع الوقت.
ثمّة عامل آخر يخدم المُتديّنين بدرجة أكبر؛ فبينما تبدو قياداتهم أكثر وضوحاً وإصراراً على رؤيتها الفكرية والأيديولوجية، وعدم تقديم تنازلات تتعلّق بأفكارهم الأساسية، علاوة على تمسّك جمهورهم بهم نتيجة الالتزام الأيديولوجي الصلب، لا يبدو القادة العلمانيون، في المقابل، في مستوى الوضوح نفسه، أو الإصرار على رؤاهم، مع استعداد للتنازل عن مبادئهم الأساسية بحثاً عن التحالفات الحزبية. يضاف إلى ذلك أنّ كلّ البدائل العلمانية لم تعد بدائل مقنعة للجمهور العلماني. فبيني غانتس، مثلاً، لا يجيد إلّا لعب دور الرجل الثاني، ولا يجيد استغلال الفرص ولا يملك القدرة على المناورة، واليسار تآكل تماماً وأصبح على وشك الاختفاء من الخريطة السياسية في إسرائيل، وبنيامين نتنياهو أصبح ما تبقى من مستقبله السياسي مرهوناً بأيدي قادة الأحزاب الدينية المُتطرّفة، ولم يعد يملك رفاهية مخالفتها. ولذلك، عادةً ما ينتقل الجمهور العلماني في إسرائيل عند التصويت من حزب إلى آخر بسهولة، وهذا لا يحدث بالقدر نفسه مع الجمهور المُتديّن الذي يحافظ على اختياره الحزبي، ولا يغيّره إلا بالانتقال إلى حزب ديني آخر في الغالب. وهذه العوامل هي عوامل ذات طبيعة ثابتة، لا تتأثّر بنتائج الانتخابات التي تجري أو بحلّ حكومات تشارك فيها الأحزاب الدينية، ولن تتأثّر، حتّى لو سقطت الحكومة الحالية، إلّا بشكل محدود للغاية. وإذا كانت العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل، في السابق، علاقة تكامل أو تصالح انعكسا في المجال القومي والسياسي والاجتماعي، إلّا أنّ العامين الأخيرين شهدا تجرّؤاً من الأحزاب الدينية واستعجالاً لقطف ثمار مكاسب الانتخابات الأخيرة، التي جعلتهم يملكون ما يقرب من نصف مقاعد الحكومة الحالية، فلم تعد هذه الأحزاب تكتفي بمُجرّد مراعاة الدولة للطقوس الدينية، وأصبحت تبحث عن ملاءَمة هُويّة الدولة لهويتها، وليس العكس، وتتصارع مع الدولة العميقة من أجل ذلك.
يعكس ذلك استطلاعٌ كان قد نشره معهد إسرائيل للديمقراطية، في مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، كشف أنّ 70% من العلمانيين في إسرائيل أصبح لديهم قلق من إمكانية المحافظة على نمط حياتهم العلماني تحت إدارة حكومة نتنياهو الحالية، كما بيّن الاستطلاع أنّ 75% من المُستطلَعة آراؤهم اعتقدوا حينها أنّ تأثير الجماعات الدينية، وعلى رأسها الحريديم، في السياسة الإسرائيلية كبير جداً مقارنة بالنسبة التي يمثّلونها من إجمالي عدد السكّان، وتظاهر كثيرٌ من الإسرائيليين في الداخل، ويهودٌ في الخارج، ضدّ ما أسموه الحكم الثيوقراطي في إسرائيل في ذلك الوقت. كانت جامعة بار إيلان، هي الأخرى، قد أجرت استطلاعاً في إبريل/ نيسان العام الماضي (2023)، نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقتطفات منه، بشأن مدى شعور سكّان المدن بالتحوّل في هُويّة المناطق التي يسكنونها؛ وأظهر الاستطلاع أنّ 42% من المشاركين فيه اعتقدوا أنّ مدنهم أصبحت تميل نحو التديّن بشكل مُطّرد في السنوات الأخيرة، وأنّ 34% من العلمانيين كانوا أميل للانتقال للعيش في مدن أخرى بسبب التوتّر الحاصل من الاحتكاك مع المُتديّنين. وأخيراً، كشف الصحافي في “هآرتس”، نير حسون، أنّ نسبة سكّان القدس اليهود ممن يعرّفون أنفسهم علمانيين تدنت إلى 9% فقط، وشبّه نسبة العلمانيين المتراجعة بمياه البحر الميت التي تجفّ يوماً بعد يوم، وأنّ هؤلاء العلمانيين قد لا يختفون تماماً، لكنّهم سيصلون إلى درجة لن يكون التعرّف إليهم في المدينة أمراً سهلاً.
ما يحدُث في القدس ومدن إسرائيلية أخرى، اليوم، سيكون مصير باقي المدن في العقود المُقبلة على الأرجح، إن استمرّت إسرائيل في الوجود. ويشكّل هذا خطراً كبيراً على الدولة تدركه الإدارة الأميركية ومؤسّسات الدولة العميقة في دولة الاحتلال، خصوصاً وقد عكست تجربة الأحزاب الدينية خلال الفترة الماضية، منذ تأسّست الحكومة الحالية، قلّة خبرة لدى هذه الأحزاب، وإثارتها قضايا أثّرت سلباً في الدولة نفسها وتماسك المجتمع، وفشلاً في إدارة الحرب الدائرة، وخسارةَ الرأي العام العالمي، وتراجعاً للمشروع الصهيوني وتعريضه لخطر وجودي حقيقي، بل أثّرت كذلك في العلاقات مع الولايات المتّحدة. ولذلك ترغب الإدارة الأميركية في توقّف الحرب الدائرة لشعورها بالخطر المُحدِق بالمشروع الصهيوني، في ظلّ الفشل في تحقيق أيّ إنجاز حقيقي، ولإعطاء الفرصة لإجراء انتخابات إسرائيلية مُبكّرة تُفضي إلى التخلّص من نتنياهو والأحزاب الدينية، ثمّ العمل مُستقبلاً على ألّا تتكرّر هذه التجربة من جديد. غير أنّ ارتباط نتنياهو بهذه الأحزاب، وخوفه من المصير الذي سيلاقيه إذا انتهت الحرب، يعطي هذه الأحزاب قدرة على المناورة، ويرسّخ أقدامها ويجعلها عصيّة على أن تكون لقمة سائغة.
لقد أراد بن غوريون أن تكون الدولة، منذ لحظة قيامها، مُمسكة بالدين، ومتحكّمة فيه. وفي ذلك الوقت، كان المُتديّنون في مرحلة ضعف، فلعبوا على عامل الوقت ومراكمة المكاسب الصغيرة المُتمثّلة باحترام الطقوس والشعائر الدينية، إلى أن تمكّنوا، في النهاية، من جعل الدين يخرج عن عباءة الدولة، ويصبح المُتحكّم فيها على عكس ما خطّط بن غوريون، وهو أمر، رغم عواقبه الوخيمة المتوقّعة على الكيان الصهيوني، لا يُتَوقّع أن يتوقّف عند هذا الحد، وإن قابلَته بعض العقبات المُستقبلية.
المصدر: العربي الجديد