
أفرزت السنوات التي أعقبت انطلاق الثورة السورية عام 2011 وما رافقها من قتل وتعذيب وتدمير وتهجير حالة من اليأس لدى بعض النخب السورية دفعتهم للتوقف طويلا عند الشروخ النفسية التي ظهرت بين مكونات الشعب السوري، وكذلك عند قابلية فئات اجتماعية لتقبل أشكال من الفكر الإسلامي المتشدد بعيدا عن أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة.
ومثلما يحدث دائما فقد خلق فشل الثورة السورية بيئة خصبة لمراجعات فكرية وسياسية مبررة ومطلوبة لولا أنها تتعدى أحيانا الواقعية السياسية نحو الوقوع في أسر شروط المرحلة بحيث تنتهي لحالة من الشكوى والنواح وجلد الذات تتخذ صورة دوامات تبتلع الفكر السياسي بدلا عن أن تغنيه بالنقد.
ومثلما أن لدينا دائما من يفضل الرغبات المثالية الحالمة التي لا سند لها في الواقع، فهناك أيضا من ينظر إلى ما تحت ظاهر الواقع من إمكانات لا يمكن أن نعطيها حقها من التقدير عندما نعتبر أن الواقعية تكمن في الانكسار أمام الواقع المرحلي والاستسلام لما يطفو على السطح ومنحه صفة الحقيقة الدائمة.
ففي التجربة التاريخية للحرب العالمية الأولى كان هناك موقفان متناقضان في فرنسا بعد انهزام الجيش الفرنسي أمام الجيش الألماني واحتلال باريس.
فالجنرال فيليب بيتان بطل فرنسا في الحرب العالمية الأولى وجد أن الواقعية تقتضي الاعتراف بالهزيمة أمام الألمان وأن مصلحة فرنسا وأمن وسلامة الشعب الفرنسي أصبحت مرتهنة بعدم مقاومته القوة الألمانية المنتصرة والتفاهم مع هتلر بحيث يمكن الحصول على نوع من الحكم الذاتي ولو كان بإشراف وسيطرة ألمانية بدلا من تعريض فرنسا للتدمير والشعب الفرنسي للمذابح والتشريد.
في المقابل كان هناك جنرال آخر اسمه شارل ديغول ظل يحلم بفرنسا الحرة وبمقاومة المحتل النازي، وحالفه الحظ عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء، وفي النهاية انتصر ديغول وتم تحرير فرنسا وحكم على بيتان بالخيانة والموت لكن ديغول خفف الحكم عليه إلى السجن المؤبد.
ولماذا نبتعد كثيرا، فقبل آذار 2011 لم يكن أكثر المتفائلين في سورية يحلم بخروج الشعب السوري بمظاهرات بالملايين من أجل الحرية والكرامة بعد أربعين عاما من أقسى حكم استبدادي مر على سورية في تاريخها الحديث.
بينما يفتح نقد المرحلة السابقة النافذة أمام الاستفادة من دروس الفشل في التمهيد للنهوض الجديد فإن تغلب نزعة الاستسلام للواقع ببؤسه الراهن وفلسفة ذلك الاستسلام عبر نظريات تشبه الأيديولوجيات تنتهي بعدم قابلية الشعب السوري للديمقراطية مما يعني غض النظر حاليا عن أي تفكير بالتغيير وانتظار تغير وعي الشعب السوري وتخرجه من أكاديميات تعليم المواطنة والديمقراطية والحداثة بمرتبة مقبول على أقل تقدير!
ويعكس ما سبق الفرق بين ضرورة الكفاح الفكري لتكوين وعي عقلاني حداثي نقدي مترافق مع الايمان بجدارة الشعب السوري للديمقراطية التي سبق أن كان رائدا في تطبيقها في العهد الفيصلي بين 1918-1920 وكذلك في الخمسينات بين 1954-1958 وبين الانطلاق من تأبيد الواقع بمعطياته السلبية وإغلاق الطريق أمام الكفاح السياسي لتغييره أو تأجيل ذلك لمرحلة أخرى على الأقل .
بل إن أكثر التغييرات عمقا في وعي الشعوب لا تترسخ سوى من خلال الحركات الاجتماعات والسياسية التي تهز أعماق المجتمع بحيث يبدأ في التخلي عن الثقافة التقليدية الموروثة لصالح ما هو أقرب للحقيقة وواقع العصر .
يعلمنا التاريخ أن فترات ازدهار الفكر والحضارة كانت دائما مترافقة مع هامش معين متاح للحريات سواء كان ذلك الهامش بفعل حالة ديمقراطية كما كان الحال عليه في اليونان , أو بفعل ضعف السلطة المطلقة بحيث لا تعود قادرة على مواجهة تجدد الفكر الانساني .
وفي التاريخ الحديث لسورية فإن القفزات التي شهدها الوعي السياسي للشعب كانت مرتبطة بدرجة الحريات العامة المتاحة، وفي العهد الفيصلي كانت هناك أكثر من 20 صحيفة سياسية في دمشق وحدها، تكتب كما تريد حتى وصل الأمر ببعضها لمهاجمة الشريف حسين والد الملك فيصل الذي كان يحكم سورية
وحتى في عهد الانتداب ورغم تضاؤل هامش الحريات عن العهد الفيصلي لكن الشعب السوري الذي سبق أن تنفس رياح الحرية استطاع تحقيق نقلة أخرى في وعيه السياسي.
لا يمكن أن تكون التجربة المريرة للشعب السوري ومأساته الحالية قد مرت بدون أن يستخلص الشعب منها الدروس، فليست النخب وحدها من يستفيد من التجربة التاريخية لكن الشعوب أيضا، وفي كثير من الأحيان تسبق الشعوب النخب في استيعاب التجارب التي تمر بها واستخلاص النتائج منها، ألم يكن الشعب السوري متقدما على نخبه في الثورة السورية؟



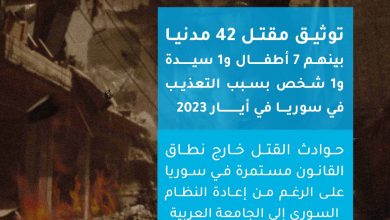




ألم يكن الشعب السوري متقدما على نخبه في الثورة السورية؟ نعم لأن النخب لم تكن تحلم بخروج الشعب السوري بمظاهرات بالملايين من أجل الحرية والكرامة بعد أربعين عاما من أقسى حكم استبدادي مر على سورية في تاريخها الحديث، فهل ستستفيد نخبنا وشعبنا من معاناته لأكثر من ثلاثة عشر عاماً بأن الديمقراطية وحرية التعبير الطريق نحو الحل.