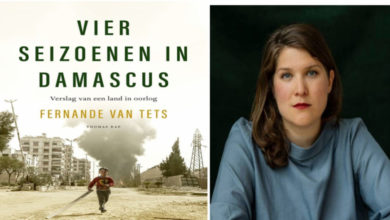في الذكرى الثالثة عشرة لثورة الحرية والكرامة تتعرض سورية لمخاطر عديدة، إذ تتقاسمها قوى الأمر الواقع: نظام الاستبداد مدعوماً من روسيا وإيران اللتين تتقاسمان النفوذ في مناطق سلطة النظام، أما المناطق الأخرى فهي موزعة بين نفوذ كل من تركيا وهيئة تحرير الشام والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم قوات ” قسد ” الانفصالية. وكل من هذه القوى تطمع في حصة من الجغرافية السورية، مستغلة غياب مؤسسات سورية معارضة، ذات مصداقية، قادرة على تمثيل السوريين على طاولة مفاوضات رسم مستقبل سورية.
ومن غير الواضح حالياً، كيف ستتم عملية تقاسم المصالح، وما حدودها الجغرافية الدقيقة، والدول الراعية لها، وما سيترتب على هذه الدول من مسؤوليات وأعباء، وما قد تجنيه في المقابل من مكتسبات. إذ يُتداول حالياً في توافر ثلاث مناطق نفوذ تحت إدارة تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وإشرافها، حيث تكون المنطقة التي تقع شمالي حلب تحت الإشراف التركي، بينما يُعدُّ الساحل السوري إضافة إلى غربي حمص متضمناً حماة والغاب وحلب حتى حدود إدلب، منطقة تحت إشراف روسي، وأن تكون المنطقة الجنوبية على امتداد الحدود مع إسرائيل وحتى القنيطرة هي منطقة تحت إشراف أميركي وإدارة أردنية، إضافة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سورية الديمقراطية ” قسد “) في الجزيرة السورية. وربما تكون المناطق الممتدة من الحدود العراقية في اتجاه الرقة تقع حمايتها تحت مسؤولية قوات مُشكّلة من العشائر العربية تحت الإشراف الأميركي المباشر.
ولا بدَّ من ملاحظة التقارير الثلاثة لمؤسسة راند الأميركية، الصادرة في المدة من كانون الأول/ديسمبر 2015 وشباط/ فبراير 2017، حول ” خطة سلام لأجل سورية “، والداعية إلى ” اللامركزية أصلح نموذج للحكم في سورية المستقبلية “، و” أنّ التطورات الأخيرة في سورية والمنطقة بما في ذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته روسيا وإيران وتركيا سيفتح الآفاق لوقف إطلاق النار على أساس وطني متفق عليه، وهو ما سيفرز مناطق سيطرة تدعمها قوى خارجية “.
وفي الواقع، تتوزع دوافع قوى الأمر الواقع بين الغايات السياسية والأهداف العسكرية والأمنية، فمثلاً ثمة أسباب عديدة لتركيا تبدأ بالتخلص من اللاجئين السوريين في أراضيها، مروراً بتوظيف منطقة الشمال الغربي شريطاً عازلاً على طول الحدود لمواجهة تبلور وضع عسكري وميداني للأكراد السوريين، يؤهلهم لإقامة كانتونهم القومي، مروراً بتحويل المنطقة إلى ما يشبه القاعدة لتجميع فصائل المعارضة المقربين منها، وانتهاء بالرهان على إدارة هذه المنطقة لتفعيل النفوذ التركي، وشرعنة حضوره السياسي والعسكري وفرص محاصصته على المستقبل السوري.
ولكنّ السوريين يتخوفون من أن ينتهي أمر لعبة الأمم إلى تكريس مشروع تقسيم قد يظهر مستقبلاً، وفي واقع الأمر لا توجد أية ضمانات تبدد هذه المخاوف، لأنها مخاوف حاضرة وبقوة في أوسع وسط شعبي سوري، مما يعني أن جميع السوريين اليوم أمام اختبار مصيري لوطنهم، فإما أن يحفظوه وإما أن يخسروه إلى زمن طويل قد يمتد إلى مرحلة غير معلومة.
إنّ البديل الأصوب المشترك الوحيد لكل السوريين هو حلّ جذري وآمن لجميع سورية، ولعلَّ وثيقة 8 آذار 2024 تساهم في فتح أفق وطني سوري جامع مستقل يقطع الطريق على مخاطر لعبة الأمم، بما انطوت عليه من رفض مشاريع التقسيم على حطام الدولة التي هي ملك للسوريين، وضرورة ربط الشمال بالجنوب لمواجهة المشاريع التي تعمل على الاستثمار في خصوصيات مناطق نفوذ الأمر الواقع، وتعزيز حضور المجتمعين الأهلي والمدني في تقرير مستقبل سورية، بما يتجاوز الهياكل الحزبية والتنظيمية السياسية القائمة، وتعزيز امتلاك السوريين لقرارهم والخروج من عباءات القوى المختلفة التي تحاول السيطرة عليهم والتحكم بمصيرهم. وقد عبّر مضر الدبس، أحد المساهمين في صياغة الوثيقة، عن هذا الطموح ” ثمة نوعٌ من القناعة بأنّ منهجيات العمل السياسي وأدواته التي بين أيدينا الآن لم تعد صالحة لتحقيق طموحاتنا وحل مشكلتنا، وعليه سوف نسعى معاً إلى تجاوز المنهجيات القديمة القاصرة، وبناء شيء جديد يشبهنا يتجاوز النظام والمعارضة معاً، ويقترب من روح السوري العادي، وهذا سوف ننجزه معاً وبصورة مشتركة على امتداد سورية كلها “.