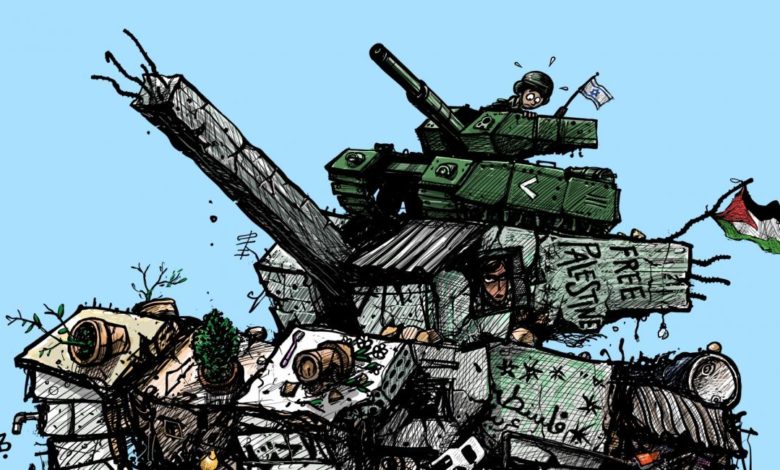
لا يخفى على القارئ أن ثمّة علاقة راسخة بين تحليل ميزان القوى وتقدير الموقف الذي يترتب عليه تحديد أشكال الصراع، وأفضل الوسائل لإفشال غايات الخصم وبلوغ أهدافنا، تكتيكية كانت أم استراتيجية. وبدايةً، ثمّة منهجَان سائدان في تحليل ميزان القوى. يرى الأول في ميزان القوى القائم أمراً غير قابل للتغيير، ويروّج الخضوع له، والاستسلام لواقعه، والتعايش معه، بدعوى عدم القدرة على مقاومته أو تغييره، متناسياً أن هذا يخالف سُنَن الحياة، ومعايير العدالة والحرّية، وأن ثمّة دولاً سادت ثمّ بادت، وأن قوّة الخصم مهما بلغت لا تخلو من نقاط ضعف. ويرى الثاني ميزان القوى على حقيقته، حتى إن كان يميل إلى صالح الخصم، لكنّه لا يستسلم له، بل يسعى إلى تغييره، والانقلاب عليه، من دون أن يهمل قوّته أو يتجاهل نقاطَ ضعفه. وفي حالتنا، نرى هذا الفارق بوضوح بين من يرى في الهيمنة الأميركية والتفوّق الصهيوني حالةً ينبغي الخضوع لها ومن يرى وجوب مقاومتها والتصدّي لها بجميع الأشكال المتاحة، من دون أن يغفل عن عناصر قوّتها ومدى تأثيرها، أو أن يقلّل إيمانه بعدالة أهدافه وقدرته في تحقيق الانتصار، كما حدث مع الشعوب التي تطلّعت إلى التحرّر، فنالت استقلالها ودحرت الغزاة.
قد تترك النزعة الأيديولوجية بصماتها في تقدير الموقف، ولعلّ في تجربة السبعينيّات من القرن الماضي ما يشير إلى ذلك، حين رفعت التنظيمات اليسارية شعاراً مفاده أن الإمبريالية الأميركية نمر من ورق، مستلهمةً من اندحار الاستعمار وتحرّر الشعوب، وهزيمة الولايات المتحدة في فيتنام، دليل على ذلك، فتضع هزيمتها أو تراجعها في بقعة ما، وكأنّه نهاية المطاف في العالم بأسره، ويعمم بشكل آلي دون رَوِيَّة على الواقع ككل، على الرغم من أن التاريخ ينبئنا بفشل عدة حركات للتحرّر الوطني في بلدان مختلفة، كانت تتبنّى النظريات الثورية ذاتها، وعن نجاح أخرى. وبلغ الشطط في ذلك تحت تأثير الخلاف الصيني الروسي، وظهور الاتجاهات الماوّية (نسبة إلى ماو تسي تونغ)، فاعتبر الإمبريالية الأميركية في مرحلة تراجع، وما وُصف حينها بالإمبريالية الاشتراكية المنسوبة إلى الاتحاد السوفييتي في حالة صعود، وهو مثالٌ على تقدير الموقف الذي لم يصمد طويلاً، وانقلب رأساً على عقب.
تنعدم الحاجة إلى تقدير الموقف أو البحث في موازين القوى عندما تسود التنبّؤات المُستنِدة إلى ما يعتقده بعضهم بمنزلة تأويلاتٍ لها علاقة بالأديان أو الأساطير، هنا نواجه حتمياتٍ لا مجال لنقاشها، يعزوها أصحابها إلى نبوءات إلهية لا قدرة للبشر على مقارعتها، كأن يقرّر بعضهم تاريخاً محدّداً لما يصفه بحتمية زوال إسرائيل، متناسياً “وجعلنا لكلّ شيء سببًا” و”أعدّوا”، فتصبح دعوةً إلى التواكل، تنفي الحاجةَ إلى ضرورة العمل لتغيير الموازين أو وضع الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف، ما دامت تلك ستتحقّق بمشيئة تفوق قدرات البشر. ومن المضحك المبكي أن ثمّة تنافساً في هذا المجال، يستوي فيه الفرقاء والخصوم، في جبهتنا، وأولئك الذين يعتنقون الأساطير التوراتية وامتداداتهم في الغرب.
تنعدم الحاجة إلى تقدير الموقف أو البحث في موازين القوى عندما تسود التنبّؤات المُستنِدة إلى تأويلات تتعلّق بالأديان أو الأساطير
ثمّة غرور مزمن، وغطرسة لدى العدو، منعتاه من رؤية ما يجري في قطاع غزّة المحاصر من إعداد حثيث لمعركة “الطوفان”، وهو غرور ممتدّ منذ حرب 1973، حين رفض تصديق المعلومات التي وصلته من مصادر عدّة عن نيّة مصر عبور القناة واقتحام خطّ بارليف. بعنصريّته، فشل العدو في تقدير الموقف في الحالتَين، ولم يصدّق أن أولئك العرب قادرون على خوض غمار الحروب. استهتار العدو بخصمه العربي الفلسطيني منعه من اكتشاف الأنفاق، ولم يتوقّع قدرة المقاومة على الصمود الأسطوري في غزّة، وفشل في تنبؤه بانهيار المقاومة في لبنان، بعد سلسلة التفجيرات والاغتيالات، كما فشل في تحديد المدى الزمني للحرب.
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023)، وقبله، برزت مجموعة من الظواهر الشعبوية والدعائية المترافقة مع الرغبة في تحقيق استثمار سياسي سريع لهذا التيّار أو ذاك المحور، وتبرير موقفه وخياراته في المعركة المحتدمة، ما أدى إلى ظهور تقديرات موقف خاطئة، انعكست في تطوّرات المعركة ذاتها، على الرغم من المقاومة الباسلة في جبهتَي غزّة ولبنان، وساهمت في حجب الحقائق عن اتجاهاتها. منذ اندلاع المعارك في غزّة وفي جبهات إسنادها، راج الحديث عن عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحرب في أكثر من جبهة واحدة في وقت واحد، بل امتدّ تقدير الموقف إلى أنه سيبقى ملتزماً (إلى حدّ كبير) بقواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة عليه، وأنه لن يجرؤ على خوض حرب واسعة نظراً لقدرة حزب الله على إيقاع خسائر كبيرة لن يكون بمقدور العدو تحمّلها في جبهته الداخلية. غفل هذا التحليل عن أن تدمير القدرات المتراكمة لدى المقاومة في لبنان يشكّل هدفاً استراتيجياً للعدو يوازي أهدافه في الحرب على غزّة، وأن من اﻷفضل واﻷكثر أهميةً له أن يقوم بمحاولة إنجاز هذه المهمّة والحرب محتدمة، وجبهته الداخلية مستعدّة، واحتياطه معبَّأ، والدعم اﻷميركي مستمرّ، من أن يؤجلّ ذلك إلى أعوام أخرى تتضاعف فيها قدرات المقاومة، ولا تكون الظروف مهيأة كما هي الآن. وكان هذا موقف الجيش الإسرائيلي منذ اليوم اﻷول للحرب، محاولاً إقناع القيادة السياسية بأولوية الحرب على لبنان. ولو قبلنا جدلاً التحليلات القائلة بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحرب في أكثر من جبهة، وتلك التي تحدّثت عن تفكّكه وضعفه، ألا يستدعي التماهي معها توسيع الحرب وامتداداها، بدلاً من حصرها ضمن جبهات إسناد وقواعد اشتباك؟
أعاد “طوفان الأقصى” إحياء القضية الفلسطينية وبعثها من جديد، بعدما اقتربت من حافّة التصفية، بعد الاتفاقات الإبراهيمية، وامتدادات أوسلو، والانقسام والتطبيع العربيين
كان من الممكن ردع العدو عن القيام بهذه الحرب، أو عدم التوسّع فيها، في حال أظهرت المقاومة في لبنان قدرتها على الردع منذ البداية، لتشكلّ أداةَ ضغط داخلية تمنع الجيش من التصعيد. كان هذا متاحاً عندما اغتيل الشهيد صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولم يتم الردّ على العملية، على الرغم من وجود معادلة سابقة تضع حيفا وتلّ أبيب في مقابل الضاحية وبيروت، وكان مبرّراً عدم الردّ أو ضعفه، تقدير آخر لا يخلو من خطأ مفاده أن هذه الحرب خطّط لها بنيامين نتنياهو لتوريط إيران في حرب لا تريدها، وبهذه المعادلة، قُيّدت يد المقاومة ضمن قواعد الاشتباك التي وضعتها، والتي أصبحت غير قادرة على تجاوزها.
ثمّة تحليلات أخرى ناجمة عن عدم فهم المجتمع الصهيوني، استندت إلى ما يدور فيه من خلافات وتظاهرات سبقت الحرب بشأن التعديلات القضائية، ولم تلاحظ وحدة المجتمع الصهيوني بأطيافه حول الحرب واستمرارها، وروّجت تظاهرات أهالي الأسرى الصهاينة على أنها تظاهرات ضدّ الحرب، على غرار تظاهرات عام 1982، إبّان اجتياح بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا، كما زعمت أن العدو لن يتمكّن من خوض حرب طويلة، وأن الاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والجيش يتفكّك، كما تنبأ أحد المحلّلين العسكريين في قناة تلفزيونية، بعد تنفيذ عملية بطولية للمقاومة، بتفكّكه خلال ستّة أسابيع، متجاهلين تدفّق الأموال من الولايات المتحدة التي فاقت 40 مليار دولار، إضافة إلى الأسلحة والذخائر. وفسّر أولئك استمرار الحرب وطول مدّتها بمحاولة نتنياهو الإفلات من السجن والمحاكمة، ولم يلاحظوا التغيّرات التي طرأت على المجتمع والفكر الصهيوني الديني، ولم يلقوا بالاً لتصريحات العدو عن معركة وجود وانبعاث جديدَين.
يتلخص الدرس الذي تعلّمه مقاتلو الحرّية بأن استمرار المقاومة دليل انتصارها، وتصفيتها لا تكون إلا بتصفية فكرتها
أعاد “طوفان الأقصى” بدوره إحياء القضية الفلسطينية وبعثها من جديد، بعدما اقتربت من حافّة التصفية، بعد الاتفاقات الإبراهيمية، وامتدادات أوسلو، والانقسام والتطبيع العربيين. لكن ثمّة أسئلة تدور، وستشكّل محور بحث المحلّلين والمؤرّخين والسياسيين في الأيام المقبلة، ليس عن الحرب والمقاومة وصمودها، والإبادة الجماعية، ومخطّطات اليوم التالي فحسب، ولكن أيضاً عن تقدير الموقف الذي أدّى إلى قرار الحرب، هل كانت بدايةً لحرب تحرير، أم كان مخطّطاً لها أن تكون عمليةً محدودة هدفها تحريك الوضع السياسي، وإنهاء الحصار وتحرير الأسرى؟ وما هي القراءة التي اعتُمِدت لموازين القوى التي أدّت إلى هذا القرار، وماذا كانت التوقّعات من الحلفاء وردّات فعل الخصوم؟ … وهي أسئلة سيتكفّل المستقبل القريب بالإجابة عنها.
مُني العدو الصهيوني بهزيمتَين، سياسية وأخلاقية، لا تخفيان عن عين بصيرة، وهي هزيمة سيكون لها ما بعدها من نتائج إيجابية على مسار القضية الفلسطينية. أمّا السؤال عن النصر أو الهزيمة بالمعنى العسكري، فإجابته تحدّدها ميادين الحرب وساحات الصراع، ولكن معيارنا هنا مختلف تماماً عن معيار الحروب التقليدية، التي يكون حصار الجيوش فيها وحده كفيلاً باستسلامها وإعلان هزيمتها. الدرس الذي تعلّمه مقاتلو الحرّية كلّهم يتلخّص بأن استمرار المقاومة دليل على انتصارها، وأن تصفيتها لا تكون إلا بتصفية فكرتها المتجذّرة في عقول أبنائها.
المصدر: العربي الجديد



