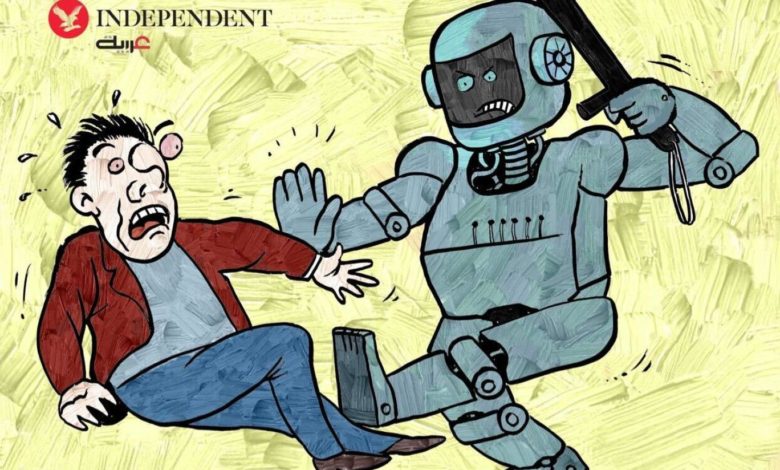
سمعت من قريب تصريح “إيلون ماسك” بشأن مزيد من التجارب على زراعة شريحة الكترونية في دماغ ،إنسان، وأنه طلب متطوعين جدد لهذه التجربة.
ويبدو أن هذا المجال من التقدم العلمي سيكون مجال التنافس والتسابق والابداع والتصارع على المستوى العالمي، وقد بدأت بوادره بالظهور.
وولوج هذا الباب ليس جديدا فقد اقتحمته السينما الأمريكية من قبل عبر العديد من أفلام الخيال العلمي، ويبدو أن السينما العربية استعارت هذا الخيال كما في فيلم “اللمبي 8 جيجا”. وقد استطاعت هذه الأفلام ملامسة المخاطر الأخلاقية وغير الإنسانية لتطبيقات هذا الذكاء الاصطناعي على الانسان.
وفي أحدث تصريحات ماسك التي أعلن فيها نجاح تجربته الأولى على مريض الشلل الدماغي وطلب متطوعين جددا، فإن أسئلة كثيرة قفزت إلى حيز التفكير النشط عندي تحاول أن تستقرئ إجابات لها. لكن من كل تلك الأسئلة برز سؤال أظنه الأخطر :
هل من شأن هذا التطور العلمي أن يقلل أو يزيد من فرص وجود نظم وجماعات وقادة أقل ما يوصفون به بأنهم قتلة، مجرمون، معدومو القيم العامة، يبررون لأنفسهم عمل أي شيء ما دام يخدم مصالحهم، وفرص بقائهم على رأس السلطة، متحكمين بالبلاد والعباد، وقد شهد عصرنا العديد من أمثال هؤلاء، وأظن أن أبرز ثلاثة أمثلة يستشهد بها في هذا المجال:
** نظام “بول بوت” زعيم الخمير الحمر الذي حكم كمبوديا ١٩٧٥ – ١٩٧٩
الذي نفذ مذابح في بلده تجاوز ضحاياها مليون ونصف المليون إنسان، وارتكبها خلف دعاوى ومزاعم بائسة وسخيفة.
** ونظام بشار الأسد الذي قتل مباشرة وبالقصف وبالتصفية داخل السجون أكثر من مليون ونصف المليون شخص معظمهم من المدنيين عبر السنوات الممتدة من العام ٢٠١١ ، وغيب قسرا وأخفى أكثر من نصف مليون سوري لا يعلم أحد مصيرهم ، وهجر أكثر من نصف الشعب السوري، ودمر البنية الحضارية والاجتماعية لسوريا، وكان الشعار السائد على مدى السنوات كلها”الأسد أو نحرق البلد”.
**ورغم اختلاف البنية والطبيعة والمنشأ فإنه يدخل في هذا التصنيف النظام الصهيوني في فلسطين المحتلة الذي ارتكب وما يزال جرائم إبادة، وجرائم ضد الانسانية ويقوم بتدمير وتهجير الفلسطينيين في غزة، ويطارد الفلسطينيين في الضفة والقدس، في مسيرة اغتصاب وقتل وتدمير لم تتوقف منذ أن وضع هذا الكيان على أرض فلسطين، واستخدام النظام الصهيوني العنصري في نسخته الحديثة بقيادة نتنياهو مختلف أنواع الأسلحة تحت عين وبصر ودعم النظام الرأسمالي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوربي الكبرى. وهذه حالة تعزز الاعتقاد الحقيقي بسيطرة الصهيونية على مختلف هذه النظم. ومن زاوية ما نبحث فإن هذا يسلط الضوء على كارثة سيطرة شركات العالم الافتراضي على كل المعلومات التي تخص وتهم الانسان. بما يمكن من تسخيرها لخدمة هذا النظام ولخدمة طبيعتها العنصرية العدواني.
والمشكلة هنا ليست في زعيم كمبوديا أو رئيس سوريا فحسب، أو حتى في هذا الكيان المدعو “اسرائيل” وإنما في البيئة الدولية والاقليمية التي سمحت بوجود مثل هذه النظم والكيانات والقادة، وحمتهم. ومدتهم بالعون والقدرة، وشاركتهم فيما قاموا به.
السؤال الرئيس الذي أقلقني أن تصبح هذه التقنية الجديدة، وهذا الذكاء الاصطناعي أداة لإنبات وتنمية مثل هذه الزعامات، وسلاحا جديدا في أيديهم، لتحقيق مزيد من السيطرة، وبالتالي في التشجيع على ظهور المزيد من هذه النظم والقيادات.
ولا يأت هذا التخوف من نزعة تشاؤم، وإنما من حقيقة تاريخية عيانية تظهر أن التقدم العلمي الحساس يكون أولا سلاحا في يد النظم قبل أن يتحول ليكون أداة لخير المجتمع،
فتستخدمه لتعزيز سيطرتها، تستخدمه في السجون، وفي عمليات التصفية والقتل، وفي عمليات التزوير والخداع، وفي الهيمنة السياسية والفكرية والاعلامية والتربوية.
وبهذا يكون جانب الشر أسبق، وأبعد أثرا.
وأكثر الأمثلة وضوحا ما خص “تفجير الذرة”، وقد استقبلتها البشرية بتفجيرين ” هيروشيما. وناغازاكي” ولم يكن لهما ضرورة حتى في منطق الصراع والحرب، إذا استخدمتا والحرب العالمية تطوي صفحتها (أغسطس ١٩٤٥)، وإنما لجأت إليهما واشنطن لاعلان زعامتها وتفردها على العالم كله.
وقبلها وبعدها الأمثلة كثيرة.
كذلك يأتي هذا التخوف من انعدام الثقة بقيم “النظام الرأسمالي المتوحش”، خصوصا حينما يستفرد بالمجتمع الانساني، ويبسط سيطرته وقيمه على هذه البسيطة التي نعيش عليها.
لنتذكر أن السلاح النووي لم يستخدم إلا من قبل الولايات المتحدة حينما كانت هي الوحيدة التي تملك هذا السلاح، وحينما تسرب سر هذا السلاح الى”الاتحاد السوفياتي”، تحول من سلاح دمار شامل هجومي. إلى سلاح ردع دفاعي، يحذر الجميع من استخدامه. وهو لم يستخدم بعد ذلك.
أنا متشائم، ومتخوف، وأرى أن “المجتمع الدولي” الذي نعايشه، لم يثبت أنه أمين على “المجتمع الإنساني”، وأن علينا أن نتوقع الأسوأ، أنظمة أسوأ، وقادة أسوأ، وجرائم أسوأ، وأدوات للتحكم في الانسان وحريته وإنسانيته أكثر وحشية، وقد لا يكون هناك من خلاص من هذا المصير ما لم يبن سور حقيقي من القيم الدينية والأخلاقية، ومن الإطارات السياسية والاجتماعية متعددة الأقطاب، ومن الشفافية الحقيقية والشاملة، تلجم هذه التوجهات. وتجفف منابعها. وتعطي أملا للإنسان بإمكانية أم يعيش حياة إنسانية على سطحةهذه الأرض التي ترتجف خوفا مما ينتظرها.







