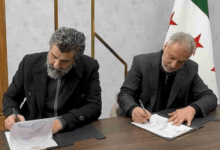تتولى فرنسا، طيلة عام 2022، قيادة “قوة المهام المشتركة” عالية الجاهزية لدى حلف شمال الأطلسي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ علاقتها بالحلف، والتي عرفت سلسلة من الخلافات والتوترات، كان آخرها في الخريف الماضي، عندما كادت صفقة الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تعيد العلاقات بين باريس والحلف إلى عهد مضى في نهاية ستينيات القرن الماضي، حين قرر الجنرال شارل ديغول انسحاب بلاده من الجناح العسكري للحلف، وأغلق كل قواعده على الأراضي الفرنسية.
ولولا لقاء المصارحة الذي جمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في روما في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لما تحملت فرنسا مسؤولية قيادة هذه القوة ذات المهام الخاصة في مرحلة دقيقة من عمر الحلف، الذي يواجه في هذه الأيام عدداً من التحديات الأمنية، في مقدمتها الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النقاط الساخنة في ليبيا، وسورية، والعراق، وأفغانستان، والحرب على “داعش”.
دور الفيلق الفرنسي الألماني في الأطلسي
وتسلّم جنرال فرنسي، أول من أمس السبت، لواء القيادة من القائد التركي الذي تولى هذه المهمة طيلة العام الماضي.
وجاء في بيان للأطلسي أن عديد “قوة المهام المشتركة” عالية الجاهزية سيبلغ 3500 جندي خلال عام 2022. وهي قوة تشكلت بناء على اتفاق زعماء دول الأطلسي خلال قمة ويلز عام 2014، عقب أنشطة روسيا الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
والأساس في هذه القوة هو الفيلق الفرنسي الألماني، الذي يتمتع بجاهزية دائمة للتحرك بسرعة للدفاع عن أي حليف، ضمن إطار قوة الرد السريع التابعة للحلف، والتي يبلغ قوامها 40 ألف جندي.
ويجري النظر إلى تولي فرنسا قيادة “قوة المهام المشتركة” باهتمام، داخل الحلف وخارجه، لعدة أسباب، يأتي على رأسها أن عماد هذه القوة هو الفيلق الفرنسي الألماني، المتمركز في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويشكّل النواة لقوة أوروبية موحدة تكون المنطلق لمشروع الدفاع الأوروبي الموحد، الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
والسبب الثاني هو أن فرنسا تنهض بدور عسكري خاص في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي ومنطقة المحيط الهادي، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستمر في الحفاظ على جيش كبير حديث مدرب جيداً، وقوة جوية كبيرة، وحاملات طائرات.
ولذلك، تتعاطى مع مسألة الدفاع من زاوية اعتماد أوروبا على ذاتها، وذلك اقتداء بالجنرال شارل ديغول الذي أنهى وجود القواعد الأميركية، وسحب فرنسا من حلف شمال الأطلسي عام 1966، وبقيت خارجه 43 عاماً، حتى أعادها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في 2009.
أما السبب الثالث، فيكمن في موقف فرنسا من الأزمات الدولية، والمناطق الملتهبة في أوكرانيا وليبيا وسورية.
وفي ما يخص المسألة الأوكرانية أدت باريس دوراً مميزاً، إلى جانب ألمانيا، منذ اندلاعها في بدايات عام 2014، وهي التي وقفت وراء اتفاقية نورماندي في يونيو/حزيران 2014، وجمعت بموجبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وتطورت إلى “اتفاقية مينسك” في فبراير/شباط 2015، والتي وقّعت عليها أطراف النزاع، وتعهدت بمقتضاها بتسوية سلمية.
قيادة فرنسا للقوة الأطلسية تضع على عاتقها أعباء إضافية، بسبب موقفها كدولة من الأزمات الدولية، وفي ظل تحديات غير مسبوقة مطروحة على الأطلسي من جهة، ووضعها الخاص داخل حلف الأطلسي من جهة ثانية، الذي تعرّض إلى الاهتزاز بسبب صفقة الغواصات، التي ردت عليها باريس بشن حرب إعلامية ودبلوماسية ضد الولايات المتحدة. وتحدّث المسؤولون الفرنسيون في حينه عن “الدرس الأول” الذي تعلمته فرنسا من تلك الصفقة، هو أنّ الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني استقلاله الاستراتيجي.
وأظهر الانسحاب الأميركي الأحادي من أفغانستان وصفقة الغواصات، أنه لم يعد بإمكان الأوروبيين الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان حمايتهم الاستراتيجية.
واعتبروا أنّ لدى الولايات المتحدة اهتماماً استراتيجياً واحداً فقط؛ الصين، واحتواء صعود قوتها، وأنّ الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن “يعتقدان أن حلفاءهما يجب أن يكونوا طيّعين. نحن نعتقد أننا يجب أن نكون مستقلين. لم يعد بإمكاننا الاعتماد إلا على أنفسنا” حسب ما جاء على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.
عاملان داخلي وخارجي مؤثران لفرنسا
وهناك عامل آخر يؤدي دوراً مهماً في فرنسا، وهو ذو بعدين: البعد الأوروبي، إذ تتولى فرنسا اعتباراً من مطلع الشهر الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
وتلقي هذه المهمة بثقلها عليها، وتحمّلها أعباءً إضافية فوق ما تنهض به بصورة طبيعية كدولة ذات مكانة أساسية في المشروع الأوروبي، وتقع عليها مسؤولية تصدّر أوروبا وحدها لفترة إلى حين من الزمن، بعد مغادرة حليفة باريس القوية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكم.
وسيبقى الحال كذلك إلى حين تتضح ملامح الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار الاشتراكي أولاف شولتز، الذي يوصف بالانطوائي.
والعامل الثاني هو الانتخابات الرئاسية الفرنسية في إبريل/نيسان المقبل، التي لا تبدو حظوظ ماكرون فيها محسومة بصورة قطعية، إذ يواجه منافسة قوية من مرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس.
صحيح أن سياسة فرنسا الخارجية لن تتغير في اتجاهاتها العامة، لكن في حال خسارة ماكرون ستحصل تغييرات في نمط الحكم.
والمسألة التي تلقي بظلالها هي التداعيات التاريخية لعلاقة فرنسا بالأطلسي، وتعود إلى قيام الجنرال ديغول بانقلاب دبلوماسي، حين كتب في 7 مارس/آذار 1966 إلى نظيره الأميركي ليندون جونسون، إن “فرنسا تقترح استعادة ممارسة كامل سيادتها على أراضيها”.
ولم يهدف ديغول الخروج من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي وقّعتها باريس في 4 إبريل 1949 إلى جانب 11 دولة أخرى، من الكتلة الغربية، بل حرص على أن يحدد، من خلال إعادة صياغة المادة 5 من المعاهدة، أنّ فرنسا تظلّ على استعداد “للقتال إلى جانب حلفائها في حالة تعرّض أحدهم لعدوان”، إلّا أنّه من الناحية السياسية، أبدى، لأول مرة منذ بداية الحرب الباردة، بوضوح، رغبة فرنسا في الاستقلال عن الولايات المتحدة.
وبعد وقت قصير، طلبت باريس من الأطلسي إخلاء 29 قاعدة تابعة للحلف موجودة على الأراضي الفرنسية منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي. ويقدّر عدد الجنود وعائلاتهم بحوالي 100 ألف، وبذلك تم نقل مقر القوات الأميركية في أوروبا إلى بلجيكا، ولم يكن ذلك سهلاً على ديغول، وخرجت تظاهرة كبيرة في باريس ضد تلك الخطوة، وواجه الرئيس الفرنسي انتقادات شديدة، على وجه الخصوص من جانب الاشتراكيين والوسط.
وداخل المعارضة، كان الاشتراكي فرانسوا ميتران من أشد المعارضين، وفي نظره، كان الخروج من الأطلسي ينم عن “رغبة في العزلة على أساس فكرة أنّ القومية هي حقيقة عصرنا”.
صحيح أنّ فرنسا انسحبت من الحلف، لكنّها من الناحية العملية، بقيت تشكل محور نظام دفاع الحلفاء في أوروبا الغربية، وكلّ ما جرى أنّها انتقلت من المشاركة في التكامل إلى علاقة جديدة قائمة على التعاون، والتي ستصبح وثيقة بشكل متزايد على مر السنين.
ولم تتوقف فرنسا منذ ذلك الحين عن تعزيز روابطها مع الأطلسي، وحصل ذلك لأول مرة في عام 1974، في بداية رئاسة فاليري جيسكار ديستان، ثم في عام 1983، في خضم أزمة الصواريخ الأوروبية، وافق الرئيس فرانسوا ميتران على قرار الحلف بتثبيت صواريخ “بيرشينغ” في ألمانيا الغربية سابقاً، ردًا على تركيب صواريخ “أس أس 20” السوفييتية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقاً).
أخيراً، وقبل كلّ شيء، في عهد جاك شيراك، وهنا يكمن التناقض، فالرجل الذي نصّب نفسه وريثاً للجنرال ديغول، سيكون من بين جميع رؤساء الجمهورية الخامسة، الوحيد الذي بذل قصارى جهده لتقريب فرنسا من الأطلسي، بينما كان ميتران يعتقد أنّ نهاية الحرب الباردة ستجعل المنظمة كمؤسسة عفا عليها الزمن، وأنّ الوقت قد حان لبناء أوروبا للدفاع الذاتي.
ومضى مع المستشار الألماني هيلموت كول لبناء الفيلق الأوروبي. وكان شيراك يعتقد أنّ “الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية” يمكن أن تؤكد نفسها في إطار الأطلسي.
ومن هنا جاء قراره في ديسمبر/كانون الأول 1995، في خضم الأزمة البوسنية، باستعادة عضوية فرنسا في مجلس وزراء الدفاع وفي اللجنة العسكرية للحلف، ولاحقاً المشاركة في العديد من العمليات التي أجريت تحت رعاية الأطلسي، كما حدث في كوسوفو عام 1999 أو في أفغانستان منذ عام 2001.
وفي عام 2004 سيتم اتخاذ الخطوة الأولى بـ”إدراج” مائة جندي فرنسي في “المهمات العليا” في بلجيكا، وقيادة التحكم والتخطيط في الولايات المتحدة. وحين وصل ساركوزي إلى الرئاسة عام 2007، قام بإنهاء القطيعة رسمياً عام 2009، والتي جاءت تتويجاً لمسار تراجعي عن سياسة ديغول، وليست بداية لعصر جديد.
المصدر: العربي الجديد