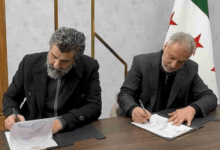أخبرتني والدتي أن فاتورة الكهرباء بلغت ما يصل إلى 100 دولار عن دورتين (قرابة شهرين)، وهو سعر استهلاك لكهرباء غير متوفرة على مدار 24 ساعة، بل بمتوسط 6 ساعات فقط، في بلد لا توجد فيه أنظمة “UPS ECO” أو ما يُعرف بترشيد استهلاك الكهرباء أو الكفاءة المعززة لاستخدام الطاقة، كما هو موجود في دول متطورة أو المستورد من دول العالم الأول، إلى جانب كابلات قديمة جميعها تستهلك ضعف الكهرباء أحياناً.
ليس لدى معظم سكان سوريا رفاهية شراء أجهزة إلكترونية جديدة متطورة، بل إن كل البيوت التي فيها أجهزة منزلية قديمة، تعمل تلقائياً عند وصل التيار الكهربائي بعد ساعات التقنين، وتستهلك طاقة أعلى بكثير بسبب تقنيات غير كفؤة وعزل متدهور، ما يزيد من فاتورة الكهرباء بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.
مصروف الكهرباء متصل مع فواتير الإنترنت والاتصال، وإيجار المنزل، وتعبئة المياه من الصهاريج بشكل شبه يومي بكلفة تصل إلى 70 ألف ليرة (6 دولارات) للمرة الواحدة، وأسعار وقود التدفئة (المازوت) التي تحسنت عن العام الماضي إلى أقل من 80 سنتاً للتر الواحد، ثم تأتي المصاريف اليومية من طعام وتنقل وصحة وحاجيات.
من البطاقة الذكية.. إلى بطاقة التحصيل
ننتقل في سوريا الجديدة إلى اقتصاد السوق الرأسمالي الحر بسرعة ومن دون تدرّج، مع معرفتي بصعوبة وضع الاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب والنظام والعقوبات الاقتصادية أيضاً، كما أننا أمام شعب مدمر اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً، معظم السكان لا يملك مسكناً، ولا وظيفة ثابتة (وإن وُجدت فهي دون الكفاف بمراحل)، ناهيك عن خط الفقر الذي يقبع تحته 90 بالمئة من عدد السكان.
في الحقيقة، لا يمكن الانتقال مباشرة إلى نظام جباية المال أو التحصيل من جيب السوري المعتر الدرويش، انتقال ما يُعرف بالصدمة الاقتصادية، كما حصل مع سوق السيارات التي أُغرقت بها سوريا من دون حسابات استراتيجية (مع فوائد أخرى يمكن فهمها في سياق زمنها وظروفها)، أو أسعار شركات الاتصالات التي لا تؤدي خدمة جيدة مع أسعار خيالية، عبر باقات إنترنت وهمية تنتهي قبل استخدامها، بناءً على التجربة والفحص والتمحيص، وهذا ما يحصل مع أسعار الكهرباء حالياً.
معظم السوريين عرفوا بشكل مباشر ما هو نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي حكم سوريا نصف قرن (نظام البطاقات الذكية)، الذي وصل إلى منتجات كالبصل والسكر والقهوة، ثم عدم توفر المنتج إلا بأسعار السوق السوداء أو السوق الحر، المسروق أصلاً من المواد المدعومة، وهو ما يشمل بشكل عام الوقود والمحروقات والمشافي والتعليم والخبز، الأمر الذي جعل كل شيء مفقوداً في ظل شبكات الفساد التي كان يديرها النظام المخلوع وأجهزة مخابراته بشكل مباشر.
بعد سقوط النظام، انتهى النظام الاشتراكي وطلقته الدولة طلاقاً نهائياً، مع بقاء التعليم والصحة مجاناً ضمن ظروف غير طبيعية، إلا أنها أفضل من السابق بشكل كبير لظروف تخص الإمكانيات والموارد البشرية والتقنيات وغير ذلك، فلم يعد يقف المواطن على طوابير البصل والخبز والبنزين والسرفيس بالساعات.
توفر كل شيء ولكن بثمنه؛ إن كنت تملك المال ستحصل على كل شيء وبسهولة، وإن كنت لا تملكه ستراه ولكن لن تشتريه.
والاقتصاد الحر، لمن لا يعرفه، هو نظام اقتصادي تُترك فيه عملية الإنتاج والتسعير والتبادل لقوى السوق (العرض والطلب) مع تدخل محدود من الدولة، يقوم على الملكية الخاصة والمنافسة، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة والابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي.
يعني ببساطة أن تبيع الدولة كل ما لديها من شركات ومؤسسات تقريباً للقطاع الخاص، أو ما يُعرف بـ “الخصخصة”، ويصبح هم الشركة هو تقديم خدمة جيدة مقابل ربح وافر، تأخذ الحكومة حصتها عبر الضرائب أو تشارك بنسب، وأشهر نماذجه هو الاقتصاد الأميركي، أقوى نظام اقتصادي رأسمالي في العالم، ويعرف أيضاً بـ “اقتصاد القلة” شركات كبرى تسيطر على معظم اقتصاد العالم لا تمثل 1 بالمئة من عدد سكانه الذي وصل إلى 8 مليارات نسمة.
ربما لا يعرف كثير من المسؤولين السوريين الجدد أن الثورة السورية انطلقت لأسباب اقتصادية أيضاً، وليس فقط سياسية، فقد عاشت سوريا عشر سنوات سيئة جداً في بداية حكم الوريث (المخلوع) بشار الأسد، مع تراكمات الفساد في عهد أبيه.
من الناحية الاقتصادية، قاد المخلوع تحولاً اقتصادياً “نيوليبرالياً” جزئياً بعد سنوات من الشكل الاشتراكي الذي يدعم الخبز والمحروقات وبعض المنتجات، وانفتح على اقتصاد سوق العقارات والمال (عدة بنوك خاصة) والدراما التلفزيونية والاستيراد والسياحة، مع اتفاقيات تجارية ذبحت الصناعيين السوريين وحتى المزارعين، إلى جانب انخفاض نسب الأمطار والتصحر والهجرة الكبيرة التي رافقت ذلك من الأطراف إلى المدن الكبرى في حلب ودمشق، ما مهّد لانضمام مدن كاملة إلى الثورة السورية ليس فيها نخب سياسية أصلاً.
فالثورة السورية، مكنونها سياسي، ولكنها تحمل بصمة اجتماعية اقتصادية واضحة.
من نماذج تحول “الصدمة”
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تشكلت روسيا الاتحادية، وخرج على الشعب الروسي الرئيس بوريس يلتسن الذي تصدى للإصلاحات الاقتصادية، أو سياسة تحويل الاقتصاد الاشتراكي الروسي إلى اقتصاد سوق رأسمالي وعلاج البلد بـ “الصدمة الاقتصادية” وتحرير الأسعار والخصخصة.
ما حصل حينها أن معظم مؤسسات الدولة (كهرباء وماء وطاقة وإنتاج وأعلاف وزراعة) وقعت في أيدي “قلة” بسبب هذا التحول الكلي المفاجئ في الاقتصاد، وانتشرت ظاهرة المليونير الملياردير الذين يشبهون بارونات اللصوص في القرن التاسع عشر.
عمل يلتسن على تمكين الشركات الكبرى في العالم من أخذ الأسواق السوفيتية السابقة – الروسية الجديدة، بأسعار رخيصة، مستفيدة من فروق الأسعار المحلية مقارنة مع الأسعار العالمية.
شهدت فترة يلتسن انهياراً اقتصادياً وتضخماً مخيفاً ومشكلات سياسية واجتماعية، ونجح يلتسن في إنهاء مشروع “روسيا القوية” عبر ما وصفه شركاؤه بالحكم بـ “الإبادة الاقتصادية”، إضافة إلى انعدام الهيبة التي كان يعيشها رئيس واحدة من الدول العظمى في العالم، مع إدمانه الفودكا وشخصيته الخفيفة (مقارنة بسجل من الرؤساء السوفييت الدمويين)، إلى أن استقال وسلم السلطة لعضو الاستخبارات الروسية (الكي جي بي) فلاديمير بوتين، والذي كان يشغل رئاسة الوزراء، وما زال في سدة الحكم من عام 1999 حتى الآن مع تعديلات دستورية خفيفة الظل.
ما حدث في روسيا يحمل حتى الآن بعضاً من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الروس، مع عدم إغفال الوضع السياسي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلد ينافس على الكعكة الجغرافية في مقابل الغرب والصين.
نموذج الاقتصاد الاجتماعي
لا يُعد النظام الاشتراكي شراً خالصاً، حيث له بعض الميزات التي تعطي المواطن حق السكن والتعليم والصحة والعمل، إلا أن التطبيق الفاسد والقائم على الانغلاق السياسي حرم الشعوب من تلك الحقوق والوصول السهل لها، وحصر المكتسبات في يد نخب الحكم من دون حصول الشعب إلا على الفتات، ولذلك يبقى النظام الرأسمالي أكثر نجاحاً لسبب وجيه، وهو ارتباطه بأجواء سياسية وحرية أعلى ومساحة للنقد وتطبيق القانون تختلف من بلد إلى أخرى.
في ألمانيا، أُنتج ما يُعرف بـ “الاقتصاد الاجتماعي”، وهو مثال كلاسيكي مشهور نشأ بعد الحرب العالمية الثانية بهدف الجمع بين كفاءة السوق الرأسمالي والعدالة الاجتماعية.
في هذا النموذج يعمل السوق بحرية نسبياً، لكن تحت إطار قانوني وتنظيمي صارم تضعه الدولة لمنع الاحتكار وضمان المنافسة العادلة، وفي الوقت نفسه تتدخل الدولة بقوة لتأمين شبكات حماية اجتماعية واسعة مثل التأمين الصحي الشامل، ومعاشات التقاعد، ودعم البطالة، والتعليم العام عالي الجودة.
الربح مهم في الاقتصاد الألماني، لكنه ليس الهدف الوحيد؛ إذ يُنظر إلى الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي كشرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
هذا التوازن ساعد ألمانيا على بناء اقتصاد قوي وصناعي وتصديري، مع الحفاظ نسبياً على فجوة طبقية أقل واستقرار اجتماعي أعلى مقارنة بنماذج السوق الحر الخالص.
وبالطبع لهذا النظام سلبياته، فهو ذو عبء مالي مرتفع على الدولة، كما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب البيروقراطية وكثرة القوانين التي تُبطئ الاستثمار، وتجعل اليد العاملة مكلفة، ما يقلل من القدرة التنافسية.
ومع ذلك، تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة اقتصادياً بعد الولايات المتحدة والصين، كما أن النظام نفسه يُطبق في معظم الدول الإسكندنافية.
أما النموذج التركي، فهو نموذج هجين يميل أكثر إلى الاقتصاد الحر منه إلى نظام الاقتصاد الاجتماعي، لكن الحكومة تتدخل لحماية الطبقات الفقيرة وتسن قوانين داعمة من دون أن تؤثر على التشريعات الاقتصادية المستمدة من السوق الحر.
ولذلك، فسوريا بحاجة إلى تطبيق نظام الاقتصاد الاجتماعي في هذه الفترة الحرجة تطبيقاً أميناً، يراعي وضع الشعب، ولا يفرض عليهم فاتورة كهرباء تتجاوز دخلهم الشهري، بعد ساعات وصل لا تتجاوز عدة ساعات، وفي فصل شتاء قارس.
المصدر: تلفزيون سوريا