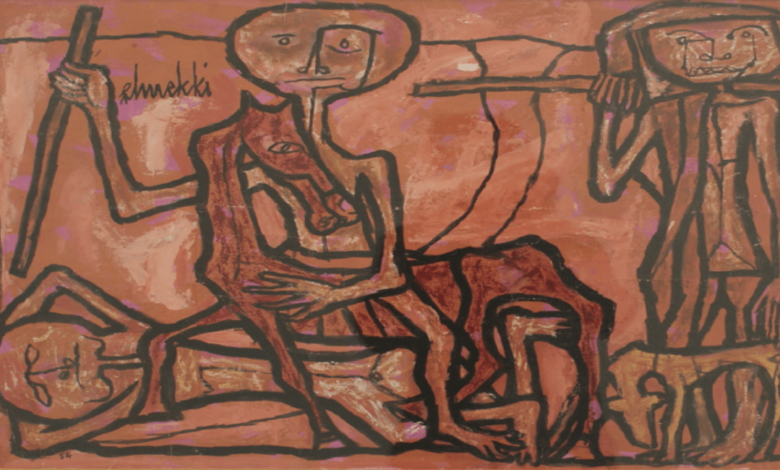
العيشُ بطريقة “كَما لو” فلسفةٌ أَصَّل لها الفيلسوف الألماني هانز فايهنغر عام 1911، في كتابٍ يحمل العنوان نفسه (Die Philosophie des Als Ob)، إذ لاحظ فايهنغر أنّ البشرَ يميلون إلى إنتاجِ افتراضاتٍ أو خيالاتٍ يتعاملون معها كما لو أنَّها حقيقة، وهي تساعدهم في مقاربة الحقيقة وبناء نمط تفكيرهم، مثل تَخيُّل المستقيم الذي يمتدّ إلى اللانهاية، أو المستقيمَين المتوازيين بصورةٍ مثالية جدّاً تجعلهما مهما امتدّا في اللانهاية لا يلتقيان، أو الأعداد السلبية. وفي السياسة أيضاً خيالاتٌ إيجابيةٌ يستند إليها الفهم الحديث مثل الإرادة العامة والعقد الاجتماعي وروح الأمة… وما إلى ذلك من مفهوماتٍ نتعامل معها كما لو أنَّها حقيقية وموجودة بصورةٍ متعيّنة وناجزة. هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى قد يُستخدم العيش بطريقة “كما لو” لتكريس نوعٍ من التكيُّف السلبي، بالمعنى الذي استخدمته الكاتبة الأميركية ليزا ويدن في كتابها السيطرة الغامضة (Ambiguities of Domination)، الذي وصَف سورية أيّام حافظ الأسد، ونُشر في عام 1999، وفيه طرحت الكاتبة أنَّ السوريّين في تلك الأيّام تصرَّفوا كما لو أنَّهم يصدِّقون كلَّ الشعارات والكذب وطقوس المبايعة والتقديس، في حين أنَّهم في العمق كانوا يدركون أن ذلك كلَّه كذبٌ، ولكن كانت الطاعة تعني أن يتصرَّفوا كما لو أنَّهم يصدّقون كلَّ شيء، ولم تكن تعني بطبيعة الحال أن يصدِّقوا كلَّ شيء لأنَّ ذلك كان مستحيلاً.
انتهى الأسد، لكن بعض السوريين لا يزالون يتصرّفون كما لو أنه لم يذهب، وآخرون كما لو أنه سيعود
انتهى الأسد الآن، ولكن بعض السوريّين لا يزالون يعيشون مع “كما لو” التي رسَّخها النظام البائد أسلوباً في الحياة طوال 50 عاماً من السيطرة، فلا يزال بعضهم يتصرّفون كما لو أنّ الأسد لم يذهب، في حين يتصرّف بعضهم الآخر كما لو أنَّه سيعود، وثمّة أقليَّة ناجية ظلّت تتصرّف بالطريقة الإيجابية نفسها التي كانت تتصرّف بموجبها قبل التحرير، أي كما لو أنَّهم مواطنون. ولو أردنا التوسّع في هذه الفكرة أكثر قد نلاحظ بعض الأمثلة ومنها السلوك الفصائلي واللجوء إلى السلاح الذي كان في الأصل له هدفٌ هو الدفاع عن النفس مقابل قمع النظام البائد وظلمه وبطشه، والتمسّك بالفصائلية والسلاح إلى اليوم يعني أنَّنا لا نزال نتصرّف كما لو أن النظام لا يزال موجوداً. وأيضاً، السلوك الانعزالي والتكتُّل الطائفي والفصائلية المناطقية وتخوين الموضوعيّين، كلّها سلوكياتٌ تدلّل على الفكرة نفسها. أيضاً، ثمّة نوعٌ من التفكير والسلوك يبني نفسه كما لو أنَّ الأسد قد يعود في صورة “فلولٍ” أو “حُكم أقليات”، كما يُقال أحياناً، ومن ثمّ علينا أن نكون حذرين ولا نسمح بذلك! ويتحوّل هذا الهاجس الأخير خوفاً من الحرية يؤدّي إلى تقسيم المجتمع إلى مكوّناتٍ استناداً إلى الأساس المذهبي، وهذا وَهمٌ يمنع الدولةَ من أن تتصرّف كما لو أنَّها دولةٌ بالحدّ الأدنى المطلوب لتستحقّ اسمها. صحيحٌ أن النظام البائد ذهب ولم يترك السوريين شعباً، ولا مواطنين، ولم يترك لهم دولةً متماسكةً، وهذا طبيعي؛ ولكن ينبغي أن يكون سلوكنا كما لو أنَّنا أمّةٌ سياسيةٌ واحدةٌ لنصير كذلك، وكما لو أنَّنا ديمقراطيون لنصير كذلك، وكما لو أنَّنا مواطنون لنصير كذلك… وهكذا، فالجماعات في السياسة تجذب ما تكون عليه، فإذا كانت تتصرّف كما لو أنَّها قطيعٌ، ستصير قطيعاً في الحقيقة؛ وإذا كانت تتصرّف كما لو أنَّها شعبٌ، ستصير شعباً في الحقيقة.
استناداً إلى ما سبق، يصبح السؤال المُهم: في وقتٍ لم نتحوَّل بعد مواطنين يُشكِّلون جميعهم شعباً سورياً، كيف نتصرّف كما لو أنَّنا مواطنون، وكيف نتصرّف كما لو أنَّنا شعب واحد؟ المفارقة أنَّ الجواب عن هذا السؤال ينتمي إلى اللاسياسة، وليس إلى السياسة، لأنّه يريد منّا أن نستكشف إمكانية أن نكون مواطنين في غياب المواطنة، وأن نكون شعباً في غياب السياسة، ولا نملك أمام هذا الغياب إلّا اللاسياسي الذي بين أيدينا القابل لأن يكون سياسياً؛ فأن نتصرَّف كما لو أنَّنا مواطنون يشكِّل اجتماعهم السياسي شعباً واحداً، يعني أن نجاهد أنفسنا كي لا نكون عصبيّين؛ فنعمل ضدّ الطائفية، وضدّ القبيلة، بوساطة آليات تنتمي إلى أخلاقيات الدين والقبيلة نفسها. لبسط هذه الفكرة، نبني الأطروحة الآتية في سياقٍ سوري راهن: أن الدين، ومن ثمّ التديُّن، وسيلةٌ فاعلة وناجعة في مواجهة الطائفية والتشنّج الطائفي الذي يرافق مشكلات عدّة في سورية هذا الأيام، وأنَّ ترجمةً سياسيةً لهذه الفكرة قد تؤدّي إلى تفعيل حلول ناجعة لمشكلاتٍ سوريةٍ مستعصية (مثل السويداء)، على المستويَين الاجتماعي والسياسي. هذا يعني ضمناً أنّنا نقارب الطائفية في سورية بوصفها تشوُّهاً، أو أزمةً، في مقاربة الدين والتديُّن؛ فعندما يَصلُح التديُّن يُفترَض أن تصلُحَ الأخلاق بما يكفي لتحصين القلب والعقل ضدّ أيّ سلوكٍ طائفي، وعندما يتأزَّم التديُّن أو يتشوَّه، على الصعيد الوجداني والأخلاقي، يسعى إلى إثبات نفسه على الصعيد الطائفي والأيديولوجي. هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يتضمّن هذا النمط من التفكير أيضاً افتراضاً بأنَّ فكرة الدين تتحمَّل فكرة الاختلاف بالمعنى الذي يفيدنا به تعبير ابن القيم الجوزية (1292-1350) في “إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين”، حين قال: “النصوص صامتة، وإنّما يتكلّم عنها العلماء”، أو الشاطبي (ت 1388) في “الموافقات”: “إنّما ينطق بالكتاب الرجال، فهم حملة معانيه، والمقاصد تُفهَم منهم”. وقال بذلك أيضاً علي بن أبي طالب: “إنَّ القرآن بين الدفَّتين لا ينطق، وإنَّما ينطق به الرجال”. وهذا كلُّه يعني أنَّ الرجالَ ينطقون بما يفهمون من النصوص المقدّسة، وأنَّ هذا الفهم يتغيَّر بتغيُّر الناطقين وطرائق فهمهم لذواتهم وللحياة من حولهم. وهذا يعني أنَّ الأصل في فهم معنى الدين هو الاختلاف، شريطة الحفاظ على النيّات الصافية التي تقبع خلف التأويل والفهم، وعلى الروح العامّة لمقاصد الدين. وهذا بطبيعة الحال ينطبق على النصوص المُقدَّسة كلّها، ويبدو أنّه طريقٌ لبناء تديّن حقيقي كما لو أنّ المُتديِّن مواطن بالضرورة، يعمل ضدّ الطائفية التي يتصرَّف فيها البشر كما لو أنَّهم متديِّنون، ولكنّهم أنفسهم لا يعرفون أنَّهم عندما يلعبون لعبة الطائفية لا يمكن أن يستمرّوا في ادّعاء التديّن إلّا على سبيل الكذب على أنفسهم وعلى الدين.
أن نتصرّف كما لو أننا مواطنون يعني أن نجاهد أنفسنا كي لا نكون عصبيين أو طائفيين
وما دامنا نرى متديِّنين غير أخلاقيين، يتغطُّون بالدين لتحقيق أهداف سياسية، أو لبناء تحالفات تخدم خططاً دنيوية ضيقة، أو عداواتٍ تخدم الهدف نفسه؛ فإنَّ التديّن لا يعني بالضرورة امتلاك الأخلاق. والأصح أن نقول إنَّ الإنسان لا يكون مُتخلقاً لأنَّه متديّن، بل إنَّه يتديّن لأنه مُتخلّق، فالطائفية تبدأ وتتوسّع عندما يصير التديّن مأوى الذين لا يقيمون للأخلاق وزناً، والذين نامَ ضميرهم وغاب عنهم التفكير. ويعني ما سبق بمجمله أنَّ فهم الدين كما لو أنَّه تتويجٌ للأخلاق، يمكن أن يكون عاملاً مهمّاً ضدّ الطائفية. وتنطبق هذه المقاربة على مفهوم العلمانيَّة أيضاً، ففي الوقت الذي يكون فيه هذا المفهوم بطبيعته مضادّاً للطائفية، فإنّه قد يتحوَّل وصفةً هووية لا تفعل شيئاً إلّا تطييف الحياة وفصل التديُّن عن الدين عند بعض الجماعات، فلا يرى المرء في سورية اليوم ظاهرة علمانيةً إلا على سبيل الإشاعة التي تداري على عملية فصل التديّن عن منظومة الدين الأخلاقية، لتنتج متديِّنين كما لو إنّهم من دون دين، مثل غالبية المقاتلين الدروز الذين يريدون العلمانيَّة وينادون “يا غيرة الدين”، ويستعدُّون للموت من أجل الدين، ولكنَّهم لا يعرفون عن الدين شيئاً. والمفارقة أنّ هذه النتيجة النهائية، أي ظاهرة المتديِّنين من دون دين، نتيجةٌ يشترك فيها الدين مع العلمانيَّة، فيصير هؤلاء “الدروز العلمانيون” يشبهون أعداءهم المتطرّفين دينياً الذي قتلوا الأبرياء منهم باسم الإسلام الذي بالكاد يعرف هؤلاء القتلة عنه شيئاً؛ فأكثر الناس حماسةً للحروب الطائفية هم أقلُّهم تديُّناً، وهم الذين يتصرّفون كما لو أنَّهم متديِّنون. وهكذا، اختلط الدين الذي جُهّز أيديولوجياً لخوض غمار المعارك الضيّقة غير المفهومة في حالة العشائر، مع العلمانيَّة وقد صارت إشاعةً لتغطّي على فصل التديّن عن الدين في حالة السويداء. ولو عدنا إلى فكرة الدين الصافي الذي لم يتلوّث بالأيديولوجيات، الدين الأخلاقي المُتّصل بالثقافة، لهوَّن علينا حلَّ الأمر عند الفرقاء جميعهم، ولتصرَّفنا كما لو أنَّنا سوريُّون عاديُّون، ولا يمكن أن نكون مواطنين إن لم نمرّ بمرحلة السوريّين العاديّين.
المصدر: العربي الجديد



