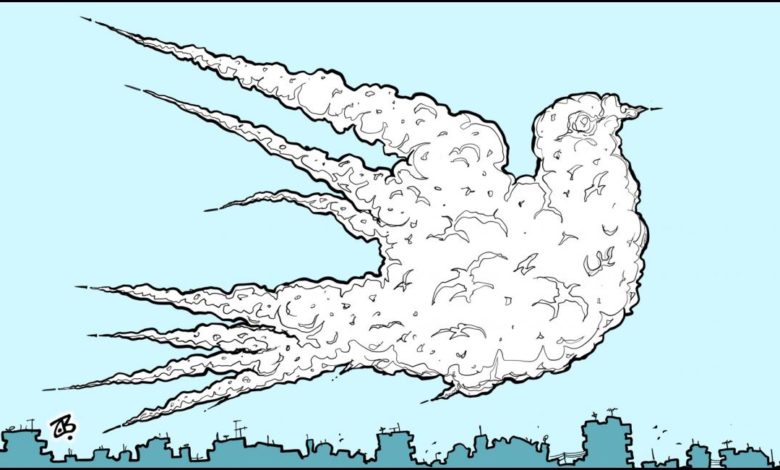
كان دونالد ترامب متأكداً من فوزه رئيساً للولايات المتحدة. ولذلك رتب أموره على مهل. وسواء تعلق الأمر بمعاونيه ومستشاريه، أم بإعداد حزمة من القرارات جلّها يخصُّ شأن الاقتصاد الأميركي، لتحريك وتائر نموِّه، وتخفيض نسب تضخمه المحلِّقة. ولأجل ذلك سيتخلَّى عن نفقات واجب الدولة “الإنساني” تجاه المسائل المشتركة عالميّاً، ويستثني من ذلك مصر وإسرائيل.. ولإلغاء قراراتٍ كثيرة، اتخذها الرئيس السابق جو بايدن، ذات بعد اجتماعي.
ومعروف أنَّ الدول العظمى، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، تعير السعودية من دول المنطقة العربية كلِّها، أهمية كبرى لما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي مريح، ومكانة سياسية لها أبعادها في المنطقة، وكذلك للعلاقة التاريخية التي تربطها بالولايات المتحدة.. طبعًا بعد “إسرائيل” العزيزة، أكثر من أيِّ دولة، على قلب أميركا، وعلى الرئيس ترامب بالذات، وعموم اليمين الأميركي والأوروبي.. ويعوِّل ترامب كثيراً على استثمارات السعودية في الولايات المتحدة، في إطار برنامجه المرسوم للسنوات الأربع المقبلة التي يركِّزها على إبقاء الولايات المتحدة دولة عظمى، إذ ذكر في أحد تصريحاته: “الذهب تحت أرجلنا ولا نعرف كيف نستثمره!”، من دون أن يحدد مصدر ذلك الذهب، أهو في أميركا بالذات أم خارجها. ومؤكّد أن لا مشكِّك في غنى الولايات المتحدة، فناتجها المحلي هو الأكبر، ولا يقاس مع مقارنته بأي ناتجٍ لأي دولة، فقد بلغ للعام 28.78 تريليون دولار في العام الذي انقضى (2024)، وتجيء الصين (العدو المقلق) بعدها، فقد بلغ ناتجها المحلي 18.54 تريليون دولار! أما الدول الأوروبية الكبرى فناتج أكبرها المحلي دون الـخمسة تريليونات دولار. أما أهم مشاريع الرئيس ترامب المرسومة في ذهنه فهي أن تزيد السعودية من استثماراتها في الولايات المتحدة، خلال سنوات حكمه.. فعلى الرغم من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد رفع المبلغ إلى 600 مليار دولار، بزيادة مليار واحد عمَّا كان في فترة حكم ترامب الأولى (2017 – 2020)، لكن الرئيس ترامب يأمل زيادته ليصل إلى تريليون دولار، ما يعني ألف مليار دولار مقابل أن تكون المملكة أول دولة تستقبل ترامب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة (مايسترو قيادة جوقة العالم سياسيّاً واقتصادياً).
وما دامت العلاقة بين الدول تقوم غالباً على المقايضة، أو ما يمكن تسميتها المنافع المتبادلة، فإن للسعودية مطلباً جاء في سياق التطبيع وتظاهرة السلام الإبراهيمي، ولا يخضع المطلب لقانون الربح والخسارة.. وهو ما أعلنه ولي العهد في خطاب له أمام مجلس شورى المملكة في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي السلام الذي تسعى إليه إسرائيل بتأييد من أميركا، إذ اشترط قيام دولة فلسطينية، وفق قوانين الأمم المتحدة. ومما جاء في خطابه “لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية، مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك”.
للسلام الدائم مشروعيته وعوامله واستقامته، وهي إحياء القوانين النائمة في أدراج الأمم المتحدة منذ 1947
وما بات معروفًا للعالم أجمع أن إسرائيل هي من يعكِّر صفو سلام الشرق الأوسط، منذ وجدت عام 1947، وما يقوم به الشعب الفلسطيني ليس أكثر من مقاومة عدوان الاحتلال الدائم الذي يأخذ أشكالًا متعدّدة، أهمها الاستيلاء، غير القانوني، على الأراضي الزراعية ومنازلهم، بالإضافة إلى المضايقات الدائمة في شؤون حياتهم اليومية بغية الإزعاج بالهجرة أو الترحيل القسري. وترامب لم يتخلَّ عن مشروعه في طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، ويرى اليوم غزّة غير جاهزة للسكن، وينصح الفلسطينيين بالسكن بعيداً عنها، يعني عن موطنهم التاريخي، إذ يرى ترامب ذلك آمَنَ لهم. هكذا.. و(ربما، من هنا، عدم قطع المساعدات عن مصر وإسرائيل)، ويتجاهل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين سبيلًا لترسيخ احتلالها الاستيطاني.. ويطلب ترامب من ملك الأردن، عبد الله الثاني، أن يستقبل فلسطينيين من قطاع غزّة، ويغض طرفه عما فعله الجيش الإسرائيلي هناك، وما يفعله في مخيم جنين. عدا عن أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحاماته لها يأتيان تمهيدًا لتنفيذ “صفقة القرن” التي دار الحديث عنها في فترة حكم الرئيس ترامب الأولى. وأيضاً في سياق ما جرى لحزب الله في لبنان، وكذلك ما أعقبه من إنهاء حقبة حكم آل الأسد في سورية. وهكذا تظهر إسرائيل محقة بكل ما ارتكبته، بل يمكن أن تعدَّ نفسها “مخلِّصة” لسكان تلك البلدان مما لحق بهم من عسف حكامهم.
إسرائيل أول من طرح شعار “الأرض مقابل السلام”، لكن للقوى اليمينية الإسرائيلية اليوم توجه آخر
ذاقت بعض شعوب المنطقة الويلات باسم الشعارات ذات السقف العالي، لكن حكامها لم يستطيعوا المواءمة بين حرية الشعوب التي يحكمونها وعيشها الكريم من جهة، وبين حدَّة الشعارات وسبل تحققها، ومن ذلك تنمية أوطانها. ويمكن قول الكثير في هذا المجال، لكن الأهم اليوم وغداً ودائماً ما إذا لدى العرب الإمكانية ليحزموا أمرهم، ويتصدّوا لهذا المشروع والعمل لإقامة الدولة الفلسطينية، فالقضية لا تتعلق بنقل مجموعة من السكان من حي إلى آخر، إنها عملية سرقة وطن في وضح النهار، ما يشكِّل عارًا حقيقيًّا لا على مستوى هذا الحاكم أو ذاك، بل على مستوى امتهان كرامة الأمتين العربية والإسلامية، ولا أبرِّئ القيادات الفلسطينية من مسؤوليتها، وعجزها عن صياغة موقف موحَّد جامع. ولا أعني هنا حمل السلاح، وإنما استخدام السياسة والاقتصاد والكثير من العلاقات السياسية التقليدية. وللعلم، إسرائيل أول من طرح شعار “الأرض مقابل السلام”، لكن للقوى اليمينية الإسرائيلية اليوم توجه آخر، إنها تعمل على إشعال صراعات جديدة، فللسلام الدائم مشروعيته وعوامله واستقامته، وهي إحياء القوانين النائمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عام 1947.
المصدر: العربي الجديد







