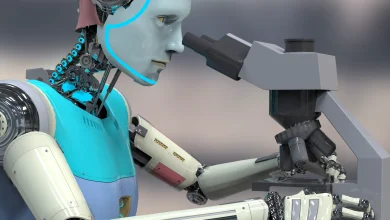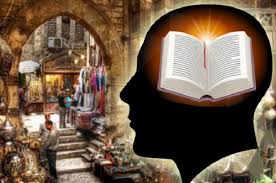
الحداثة القانونية الغربية، نتاج للتفاعل بين الرأسمالية وتطوراتها، والحداثة السياسية، والعقلانية، والانفصال بين الوضعي والميتاوضعي، ومن ثم كانت تعبيرا وتمثيلًا للفلسفة العقلانية، وأيضا للفلسفة الوضعية، ومن ثم للصراعات ثم المنافسات الاجتماعية، بين بُني طبقية، متمايزة، وصراعاتها على المصالح، ثم التوازن النسبي بين بعضها بعضًا في مراحل متطورة للنظام الرإسمالي والليبرالية، ثم الأنتقال إلي مرحلة مابعد الحداثة ومابعدها من تغير فلسفي ووجودي نسبياً.
كان القانون، ولا يزال نتاج للقوة السياسية المعبرة عن موازين القوى الاجتماعية، والاقتصادية، المسيطرة في المجتمعات الأكثر تطورًا ومؤثراً عليها ، وصولا للرأسمالية النيوليبرالية، وشركاتها الكونية الضخمة، وتأثيراتها على وضع القوانين في هذه البلدان وانعكاساتها على الدول المتوسطة، والتابعة الفقيرة. من ثم تحرر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من مسألة الدين – في جذور القانون ومرجعياته أفي القانون الروماني ، والتقاليد المسيحية- اليهودية – جزءا من التكوين التاريخي لليبرالية ، والقيم والثقافة السياسية الديمقراطية التمثيلية وتطوراتها ، ومن ثم حدثت عمليات التمايزات والانفصال بين القانون والأديان –أيا كانت ومعها مذاهبها- ، وهو تعبير عن تشكل الغرب الرأسمالى التاريخي ، وقواه الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية. من ثم لم يمثلُ الدين أيا كان موضوعا إشكاليا في مواجهة قانون الدولة والسلطة ، إلا في العقود الماضية من أواخر القرن الماضي ، واوائل الألفية وحتي الآن ، وخاصة مع بعض الأصوات السلفية من بعضهم داخل الجماعات المهاجرة إلى الغرب، وبعض الأصوات التي تنتمي إلى الفكر السلفي، والراديكاليات الدينية، كنتاج لتمددها داخل هذه المجموعات الإسلامية، لاسيما في ظل بعض من تفاقم وجودهم كأقليات ، ومشاكل إخفاق سياسات الاندماج الداخلي، والتهميش، وتنامي مشكلات الهويات المتخيلة لدى بعض مكونات هذه الجماعات، منذ تحولات ما بعد الحداثة، وعالم المابعديات، ثم الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ماسيؤدي إلي تنامي هذه النزعة الهوياتية مع هويات الدول الغربية، وذلك تعبيرًا عن رهُاب الخوف من التطورات العلمية فائقة السرعة، والتطور، وتأثيراتها، كمرحلة انتقالية.
في عالمنا العربي اوضاعنا القانونية والثقافية والقيمية والدينية منذ مطالع النهضة المغدورة لاتزال رهينة سياجات الثنائيات المتضادة بين الموروث الديني والاجتماعي وسردياتهم ، وبين الحداثة القانونية وبين التراث والمعاصرة ، وبين نظام الشريعة والقانون الحديث ، وبين محاولات التوفيق بين هذه الثنائيات التي لم نستطع الخروج من دوائرها شبه المغلقة الي إبداعات تتجاوز حدودها وتتابع واقع محمل بأرث طويل من التخلف ومعه اسئلته وإجاباته في كل مرحلة من مراحل تطور وخصوصيات كل مجتمع عربي ، بل وفي تجارب الدولة والمجتمع والتحديث المادي السلطوي والحداثة المبتسرة في الحالة المصرية التاريخية وتجاربها المجهضة ، وخاصة مع عودة المسألة المصرية -رجل الشرق الأوسط المريض والمعاق – مجدداً من عصر السادات إلي الآن ، من ثم لا تزال في كل مرحلة من نظام يوليو التسلطي تثار الإشكاليات حول العلاقة مابين القانون والدين عموماً والإسلامي خصوصاً والمستمرة كأحد الإشكاليات والعقبات البنيوية التاريخية، وانفجارات المشكلات السياسية والاجتماعية المعقدة مابعد الإستقلال عن الأستعمار الأوروبي ، والتي تتمثل في الصراع السياسي الديني بين الحداثة القانونية، والمصادر المتعددة للنظام القانوني للشريعة الإسلامية، ، وتفاقم مشكلات العقل الديني الوضعي النقلي السلفي، والجهادي، والسلطات الدينية التابعة للسلطة السياسية الحاكمة، وغياب حركة اجتهادية خلاقة، قادرة على التفاعل الإيجابي الخلاق، مع الوضعيات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ومشاكل المجتمعات العربية، وانقسامها الداخلي، وبنيات الدولة والوطنيات الهشة والأسئلة المتجددة حول ثنائية العقل والنقل والتراث والمعاصرة والدوران حولها وكأنها حالة من التيه التاريخي .
كانت الأوضاع الاجتماعية التاريخية ، ونظام الحرف، والزراعة، والوعى قبل الاستقلال تخضع للأنظمة العرفية، وأنماط التدين الشعبي السائدة في كل جماعة داخل المجتمع، تداخلت بعض المكونات مع تأويلات وتفسيرات الفقهاء ورجال الدين لنظام الشريعة القانوني، مع هذه الأوضاع .
بدأت إشكالية الشريعة/ القانون الحديث في مصر مع نشأة الدولة الحديثة، وبناء الهياكل البيروقراطية، ودمج الاقتصاد المصري –تجارة القطن- مع الاقتصاد الرأسمالي الدولي آنذاك، واضعاف الأزهر ، وتبعيته للدولة من حيث السيطرة ودفع رواتب مشايخ الجامع من الدولة بعد إلغاء نظام الألتزام .
كانت جماعة العلماء، تنحو صوب الجمود القرائى والتأويلي للشريعة، وسردياتها الفقهية الوضعية، في مواجهة الدولة وقوانينها الحديثة منذ محمد على، ثم إسماعيل باشا وما بعد، إلا أن بعضهم كان ينزع نحو التجديد الفكري، ومحاولة رفع بعض التناقضات مع الحداثة القانونية، ومنظوماتها الوضعية، وعلى رأسهم الشيخ خليفة المنياوى، ثم الإمام محمد عبده، وتلامذته، حتى مولانا الأمام الأكبر المجدد الشيخ محمود شلتوت وإلي الأمام الأكبر مولانا د احمد الطيب .
مع المد التغريبي، ونشأة الجماعات السلفية والإخوان المسلمين والسلفيين في العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي، كانت الشريعة في خطاب هذه الجماعات تستخدم ضد التحولات الحداثية القانونية والثقافة الكوزموبولتيانية في المدينة –القاهرة والإسكندرية، والمنصورة وبورسعيد-، ثم ضد الاستعمار البريطاني، التي كانت سياساته، تدعم الاتجاهات الدينية في مواجهة الحركات والأحزاب الوطنية مثل حزب الوفد، ومطالباته بالدستور والاستقلال الوطني. مذاك، وطيلة نظام يوليو 1952، كانت هذه الجماعات الإسلامية السياسية، توظف المطالبة السياسية بالشريعة جزءا من الصراعات السياسية، وفي مواجهة المنظومات القانونية الوضعية، دونما اجتهادات خلاقة من داخل نظام الشريعة، تستجيب لتغيرات العصر، ومشاكله، والتغيرات في النظام الاجتماعي والاقتصادي، ويعيدون إنتاج المقولات والسرديات والفتاوي القديمة ابنة عصورها، ومجتمعاتها! ومن الملاحظ ان غالبُ المنظومات القانونية الحديثة لاتتناقض مع المبادئ العامة للشريعة ومصادرها كالعرف ، والمصلحة علي سبيل المثال ، وخضوع الأحوال الشخصية لنظام الشرائع الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية .
من هنا قامت أنظمة الحكم –في مصر والمغرب-، وفي غالبُ البلدان العربية، بالصراع مع هذه الجماعات الإسلامية، وذلك من اجل السيطرة على التأويلات الدينية، ومعها السلطات الدينية الرسمية التابعة في مواجهة الجماعات الإسلامية السياسية، ومشايخ الطرق، بل وظفت أيضا في هذا المضمار الجماعات الصوفية في مواجهة الجماعات الإسلامية السياسية، دونما وعي سياسي بأنها تشكل وسطاً اجتماعيا، وبيئة دينية، داعمة لقواعد هذه الجماعات، ومصدرًا للتجنيد السياسي لبعض أعضاءها وتابعيها.
من هنا كان الدين أحد مصادر الشرعية السياسية ، وأداة بيد السلطات الحاكمة العربية في السياسات الدينية السلطوية، وفي مواجهة معارضيها أيا كانت أيديولوجياتهم ، وذلك لعديد الاعتبارات التي يمكن إيجاز بعضها فيما يلي:
1- إن التأويلات الدينية السلطوية ، والسلطة الدينية التابعة هي مادة أساسية في تشكيل علاقة الفرد / الشخصي بدينه، ومذهبه ، والوعي به ، ومن ثم مركزية ذلك في عملية توظيف السياجات السردية التاريخية النقلية في تكوين الضمير الفردي والدينى والأخلاقي للشعب وخاصة الكتل الشعبية الغفيرة والطبقة الوسطي في تشكلاتها.
2- الدين بات أداة رئيسة لاستخدامات السلطة له، فى الضبط الاجتماعي، والتعبئة، ومن ثم ثارت تاريخيا المزايدات المتبادلة على الدين وبه مع المعارضات –أيا كانت إيديولوجياتها-، وذلك في شرعنة سياساتها وقوانينها، من ثم استخدمت الجماعات الإسلامية الدين في جحدُ شرعية الدولة والنظام والقوانين الحديثة ذات المصدر المرجعي الغربي.
3- استخدمت الجماعات الإسلامية السياسية، والسلفيات الجهادية الدين الشعبي المسيطر على حياة الجموع الفعلية –ثم الرقمية- في مواجهة السلطة وقوانينها الوضعية.
4- تغلغل الجماعات السلفية الوهابية، وغيرها، والإخوان وتأويلاتهم الوضعية داخل المجتمع، والمؤسسات الدينية العربية التابعة، وهو ما شكل ولا يزال عائقا إزاء أية اتجاهات إصلاحية، أو اجتهادية في الفكر الدينى الرسمي، والمؤسسي، في مواجهة مشكلات مجتمعاتنا، تدفع نحو الحرية والمساواة والإخاء والمواطنة لجميع مكونات المجتمعات العربية الانقسامية.
لا شك أن هذا الجمود في الفكر الدينى، وإعاقاته للتجديد والاجتهاد العصري، مصدره الطبيعة التسلطية والاستبدادية للدولة والسلطة ،وقمع الحريات العامة والفردية ، ومن ثم أدى ذلك إلى تفاقم الإشكاليات والمشكلات المعقدة بين القوانين الوضعية السلطوية، والتصورات السائدة حول العقيدة، والقيم الإسلامية الفضلى، وبين الدرس الديني النقلي، وبين الإيديولوجيا السياسية الدينية كما تطرحها هذه الأطراف والفواعل الدينية في الحقل الدينى، وسعيهم للهيمنة بأسم الدين على الجموع الغفيرة الفعلية والرقمية. وهو ما أدى إلى فجوات وأزمات بين التصورات الدينية السائدة حول التراث القانوني الديني الوضعي ، وبين أسئلة ومشاكل التنظيم القانوني للحياة المعاصرة ، وهذا التراث النقلي ، لاسيما مع التحولات إلى ما بعد الإنسانية، وانعكاساتها الراهنة والمستقبلية على الأديان والمذاهب، ورجال الدين وأدوارهم وسلطاتهم الرمزية -أيا كان الدين والمذهب-، خاصة مع الذكاء التوليدي والأدوار التي سيلعبها بديلاً عن رجال الدين المحترفين حول تارخ الأديان ومصادر بعضها ، والمذاهب وتشكلاتها وتفسيراتها وفتاويها .
يمكن القول ايضاً أن الصراعات حول الدين، وبه على السياسة، والقانون أدت إلى شيوع ثقافة دينية شعبية تغذيها الجماعات السلفية والإخوان المسلمين بين الجموع الغفيرة وقواعدهم التنظيمية ترى ان القوانين الوضعية الحديثة مضادة للدين، والشريعة، ومن ثم تمدد وعي اجتماعي، وديني شعبي يرى في الخروج على قانون الدولة والسلطة، أمرًا مشروعا دينيا. من ثم تحول هذه الوعي الجمعي المضاد نسبيا إزاء شرعية قانون السلطات العربية الحاكمة إلي أحد ابرز العوائق ضد قانون الدولة والسلطة ، ومن ثم إلى عدم فاعلية هذه القوانين في تطبيقاتها على الواقع الموضوعي والعلاقات الاجتماعية.
4- ساهمت الثقافة الصوفية الشعبية –في المنطقة العربية- وطابعها الطقوسي والاستعراضي في الموالد –والخلوات-، واختلاطها بالتدين الشعبي إلى تزايد النزعة القدرية، وارتباطها بالحياة الجوانية للمتصوف، وأن تحرره من الشرور والآثام التي يقارفها إزاء الآخرين، والخروج على قانون الدولة، يمكن نفيها والتحرر منها، من خلال التطهر الجواني والروحي والذاتي، على نحو فاقم من انتهاكات القانون وقواعده في بعض تفاصيل الحياة اليومية العربية .
5- أدى الطابع الانقسامي للدولة ومكونات المجتمعات العربية إلى انعكاساتها داخل تشكيل مراكز القوى في النظام والبيروقراطية وأجهزة إنفاذ القانون –لبنان والعراق وسوريا والسودان واليمن .. الخ – بل وفي تركيبة جيوش هذه الدول، وهو ما أثر سلباً على فاعلية القانون، وشجع علي إنتهاكه والخروج علي سراطاته ، في ظل قوة الانتماء الديني والمذهبي السياسي، والطائفي، والقبلي والعشائري.
في غالب دول ومجتمعات عالمنا العربي، السلطة والمعارضة ترفع شعار دولة القانون وفاعليته، بينما الفجوات واسعة بين الشعار، والواقع الموضوعي المتفجر بالاضطرابات وثقافة الفوضى داخل كل دولة ومجتمع ، والانعزال عن تطورات القوانين المقارنة في البلدان الأكثر تطورا في عالمنا المتحول، وأزماته ، وايضاً تطوراته العلمية والتقنية والأقتصادية النيوليبرالية ، وانعكاساتها علي الانساق القانونية في هذه البلدان وعلي الدول وسلطاتها ، وأثر القوة عليهم من الشركات الكونية النيوليبرالية الرقمية والمصارف وغيرها . عالم تبدو النخب السياسية الحاكمة في حالة انفصال عن عن واقعها الموضوعي في كل دولة ومجتمع ، وايضاً عن عالمها وتحولاته فائقة السرعة في تفاصيل حياته ! وا أسفاه !
المصدر: الأهرام